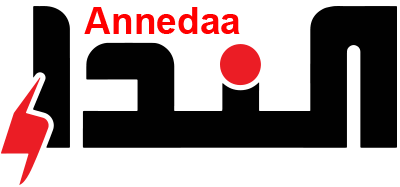السلوك قبل الوعي، والنظام قبل الكلام، فإذا تغيرت الشروط المادية لحياة الناس، وتحسنت فرص عيشهم بما يشبع حاجاتهم الأساسية، فربما تتغير أفكارهم وأفعالهم وتفاعلاتهم وأنماط علاقاتهم الاجتماعية وقيمهم وسلوكهم، إذ إن أفكار الناس تنبع من واقع علاقاتهم الاجماعية في عالم الممارسة اليومية. والسؤال هو: لا ماذا يفعل الناس، ويعتقدون ويقولون؟
بل لماذا يفعلون ما يفعلونه ويقولون ما يقولونه؟! والأيديولوجيا تعني أن الناس يفكرون من أقدامهم! والثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي؛ هي ما يبقى بعد نسيان كل شيء! بمعنى أن الوعي إذا لم يترسخ في السلوك، ويكتسب صفة العادة، لا يصمد كثيرًا في مواجهة تحديات الحياة الواقعية، وحينما يتكرر الفعل والسلوك مرات كثيرة، يصير عادة، وحينما تترسخ العادة، تصير ثقافة. والوعي لوحده لا يغير حياة البشر، وكذلك هي المواعظ والتعاليم والوصايا، بل إن حاجة الناس إلى مثُل عليا للسلوك أكثر من حاجتهم إلى المواعظ والتعاليم والنصائح. والجماعة السياسية التي ترغب في قيادة الناس، لا تكلمهم عن ذاتها ونواياها في ما سوف تفعله من أجلهم، بل عليها فعل ذلك بصمت وبلا ضجيج عبر المؤسسات، وليس عبر الأشخاص. والناس هم الذين يقومون بتشكيل مؤسساتهم العامة، ثم تقوم هي بتشكيلهم، فكيفما كانت مؤسساتهم يكونون، ولا سحر في التاريخ، ولا مصادفة في الطبيعة. لا الأخلاق ولا المواعظ ولا التقوى ولا الدين ولا الثقافة ولا الحب ولا الانتماء ولا النوايا الطيبة يمكنها أن تصنع النظام في أي مكان أو زمان في هذا العالم. النظام والانضباط هو ابن الدولة، والقانون الذي ليس له قلب ولا عيون! هو سيد الجمع بلا استثناء. ولا وحدة ولا اتحاد ولا اجتماع ولا اندماج بدون مؤسسة دستورية قانونية جامعة وعادلة ومستقرة إلا في قلوب القوى الناعمة فقط. والناس بدون قانون ومؤسسات وعيونهم إلى الأرض أشد فوضى وانحطاطًا من الحيوانات. والأشخاص يأتون ويذهبون، بينما المؤسسات هي وحدها التي يمكنها أن تدوم إذا وجدت من يتعهدها بالحفظ والحماية والصون والتنمية. والتنوير بدون تنمية محسوسة وملموسة وفاعلة يظل جهدًا مرهقًا في بيئة تشكلت مؤسساتها منذ أقدم العصور، وثمة فرق شاسع بين فقيه عربي نقلي يستند على مؤسسة سياسية ودينية عمرها ١٤٠٠ عام، وفيلسوف عقلي ليس لديه من سند غير عقله وثقافته الخاصة في سياق تاريخي ثقافي محاط بالجهل والتجهيل من كل الجهات. الاستئناس بقوى العقل والتفكير في بيئة النقل والتكفير، يعد مغامرة غير مأمونة العواقب. ومع ذلك، ثمة من لديهم الشجاعة لخوض التجربة. وتلك هي وظيفة المثقف العضوي، وبين السلاطين ووعظهم علاقة هيمنة ظاهرة وخفية يتم تكريسها منذ أقدم العصور؛ علاقة تتعين شفرتها بلسان حال السلطان على النحو التالي "نحن نحكم الناس بالقهر والطغيان والاستبداد إلى حد جعلهم يكرهون حياتهم"، وأنتم -وعاظ السلاطين- عليكم تقديم العزاء لهم والسلوى، ووعظهم بأن الحياة الآخرة هي خير وأبقى! وهذا هو سر اندلاع الموجات المتكررة من الحروب الدينية الطائفية التي يندفع إليها الشباب المسلمون برغبة وحماسة منقطعة النظير، تحت رايات الجهاد في سبيل الله، ومن أجل الفوز بجنات النعيم وبالحور العين.
وفي المجتمعات التي تضيق فيها حدود الحرية؛ حرية العقل والضمير، تضيق آفاق الخيال والإبداع والتفكير والتعبير، فبدلًا من إطلاق العنان للعقل والخيال في ما ينبغي أن يكون، يرتد اهتمام الناس للتفكير بأعضائهم التناسلية وحاجاتهم البيولوجية، والبحث عن سبل إشباعها، إذ يندر أن تجد فيها أشخاصًا طبيعيين يتصرفون ببراءة وعفوية بالاتساق مع سجاياهم الحقيقية، بل تسود ثقافة وقيم الظاهر والباطن، وتزدهر قيم التكلّف والتزلف والنفاق والمراءاة والمجاملات والكذب والحقد والخيانة والغدر والخديعة والشتم والغيبة والنميمة والحذر وانعدام الثقة والشك والارتياب وسوء الفهم وسوء الظن والفصام وازدواج الشخصية وسرعة التقلب من حال إلى حال، والجمع بين المتناقضات دون الشعور بالتناقض وصعوبة التنبؤ بسلوك الأفراد وردود أفعالهم. ويمكنك تعداد المزيد من القيم السلبية من واقع حياتك اليومية ومعاشرتك للناس في محيطك الاجتماعي، وحينما تسود تلك القيم السلبية حياة مجتمع من المجتمعات، يصعب أن تجد أحدًا من الأفراد غير متأثر بها بهذا القدر أو ذاك.