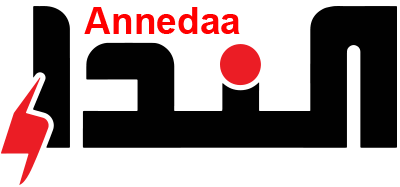هناك رجال/ أسماء لا يليق بنا الحديث عنهم بأفعال الماضي، لأنهم جديرون بالحاضر المضارع السائر إلى المستقبل، وهم فيه أجدر.
رجال/ أصدقاء، قادة، صدوقون، نقشوا ملامحهم في جدارية الحياة، ويغرسون صورهم في أعماق الذاكرة، ويتركون أسماءهم وأفعالهم حضورًا لا يغيب، أمثال هؤلاء هم قلة في حياتنا الخاصة والعامة، ومنهم الأصدقاء القادة الراحلون؛ عبدالحافظ قائد، عبدالجليل سلمان، وعلوان الشيباني.
يصادف تاريخ 8/6/2022م الذكرى الثانية لرحيل الصديق والإنسان، علوان بن سعيد الشيباني، الذي يتوافق مع عيد ميلاد ابنتي علوية، إنها جدلية الحياة والموت، جدلية المهد واللحد..، وهي المعادلة الحياتية الإنسانية الخالدة.
تعودنا ونحن نحتفل بأعياد ميلادنا، أن نطفئ شموع أيامنا الفارطة لنبدأ السطر الأول من صفحة أيامنا الآتية، نحتفل وتغمرنا البهجة ونحن نستقبل عامًا جديداُ، ونودع آخر، ولا ندري ونحن في دهشة الفرحة/ البهجة أننا ومع كل احتفال نقترب، بمفهوم الزمن التاريخي، من حافة الرحيل، وتلكم هي جدلية الموت في الحياة، والفارق هنا، أن هناك أناسًا يرحلون لمعانقة السماء، وكأنهم لم يغادرونا لحظة، وهذه -كذلك- واحدة من صور ثنائية الحياة والموت.
الأصدقاء/ الأساتذة، القادة، الذين ذكرتهم، هم من يعلموننا المعنى العميق للحياة، وكيف نعيشها، لأن الحياة ليست مجرد العيش كيفما اتفق، بل هي كيفية ونوعية، وليس كمًا من السنوات، وهذا الكيف الإنساني هو الذي يبقى كفارق بين حياة وحياة.
كان علوان، يحب الحياة بعمق، ويعشق عيشها والدخول إلى تفاصيلها الإنسانية البسيطة والصغيرة، يحب الحياة ويقبل عليها لا لملذاتها أو طمعًا بما فيها من الغرائز البدائية، بل ليجعل من الحياة مع الناس أجمل.
وكأنني أراه في الممارسة يكرس ويجسد القول الشعري القائل: "نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا".
منذ بدايته كسياسي وثائر نبيل، حتى كونه -لاحقًا- رجل أعمال نظيفًا، كانت احتياجاته من البعد الغرائزي في الحياة في حدود الكفاف الإنساني، بقيت متطلباته الخاصة في حدودها الدنيا، وتكاد لا ترى، لأنه كان يرى أن لا معنى للحياة دون الناس، وكأنه يقول: من أنا بدون الناس الذين يحتاجونني.. من أنا سوى ثري جشع يجري جري الوحوش صوب المال، والمادة، ومثل هذه النماذج كثر في حياتنا، لا يتركون سوى بهيمية صورهم المقرفة، والمقززة في رحلة أيامهم البائسة، يرحلون ويبقى المال يدل على سوء أفعالهم، ولذلك ربط علوان حياته ومصيره بالحرية، وبالعطاء، وبالناس البسطاء، وبالقيم النبيلة، وبذلك دخل إلى صلب المعنى العميق للحياة، وانتصر بذلك على ضعفه الإنساني، بالحلم النبيل في أن يجعل الحياة أجمل، هذا ما تقوله سرديته الحياتية البسيطة والعميقة.
ولذلك أقول: إن الرجال الكبار يعودون إلينا من الموت كلما احتجنا إليهم.. يعودون إلينا ليذكرونا بما نسيناه من وصايا الحب والفرح، وهو حقيقة ما أشعر به أنا شخصيًا مع بعض الأصدقاء، الأساتذة، ومنهم عبدالحافظ قائد، وعبدالجليل سلمان، وعلوان الشيباني، وجميعهم أصدقاء رحلة عمر بدأت رحلتهم في الحياة معًا، في زمن واحد أو متقارب، ومن مواقع مختلفة.. هم حقيقة من رموز الاستنارة والتقدم في الحياة، من رموز العطاء بلا حدود، وجميعهم، رغم رحيلهم، حضورًا في الغياب.
كان الكبير والإنسان، علوان يرى في نفسه جزءًا لا يتجزأ من حياة الناس، ملتصقًا بمن حوله، ومتوحدًا بمن يحب.. متوحدًا بهم في السؤال عن المعنى في الحياة.
كان يعرف ماذا يريد منذ أن كان طفلًا في قرية “المدهف” وحين صار مراهقًا في المدينة عدن.
كان يبحث عن أمرين:
في البداية كان يبحث عن العمل الذي يوصله إلى التعليم، وليجعل بعد ذلك من التعليم قاعدة استراتيجية للوصول إلى الأعمال الكبيرة، لأن التعليم هو ما يجعل للأعمال قيمة ومعنى.
كان رحمة الله تغشاه يدرك ماذا يريد من الحياة، كان ينظر للحياة كفرصة واختيار في أن يكون ما يريد، ولذلك هاجر متنقلًا بحثًا عن التعليم، ولم يجعل التحديات والمصاعب تقهره وتكسره، حولها جميعًا إلى فرص مفتوحة لصناعة الحياة.
من الحياة وتجاربها (أتراحها وأفراحها)، كان يتعلم ويعلم من حوله ليجعل الحياة أجمل، والعيش أرقى، هذا هو علوان بن سعيد الشيباني الحاضر أبدًا في الغياب.
قال محمود درويش: “هزمتك يا موت الأغاني”، ودائمًا كانت الأعمال النبيلة، والذكريات الجميلة أغاني وسيمفونيات راقية تذكرنا بمن رحلوا، وهي التي تساعدنا في الانتصار على ضعفنا، وفي التغلب على متاعب الحياة.
إذا كان الموت هو الحقيقة الخالدة والأزلية، العابرة لكل الأزمان، فإن الذكريات المشحونة بالحب، وبالأعمال الجليلة، قد تكون من عوامل إضعاف سطوة الموت، أو للتقليل من رهبته، وهي التي تجعل البعض ممن يرحلون قريبين منا بأفعالهم الحانية.. إنها الذكريات الجميلة حين تجعل من الموت صديقًا أليفًا، ومن الضعف الإنساني قوة، في صورة ذكريات تحفظ لنا صورة وأسماء من رحلوا وكأنهم لم يغادرونا أبدًا، ليبقوا حضورًا في الغياب، أقوى حضورًا ممن يعيشون بيننا بأجسادهم، ولكنهم، حقيقة، في عداد الموتى في الحياة.. فما أكثر الموتى الأحياء في أيامنا.
هناك أسماء يمكننا استعادتهم للحياة في كل حين، لأن هناك ما يدل عليهم بما صنعوه وتركوه للأجيال، وعبدالجليل سلمان، وعلوان الشيباني، وعبدالحافظ قائد، ونظراؤهم في صدارة هذه الأسماء.
اليوم، رغم سنوات البعد وتقادمها مع بعضهم، فإننا مانزال نتذكرهم بما تركوه وما صنعوه سواء في حياتنا الخاصة، أو في حياة مجتمعهم وبلادهم، ولذلك هم حضور في الغياب.
إنهم يعودون من الموت، أو نستعيدهم منه، كلما احتجنا إليهم، ليحلوا ضيوفًا علينا نستأنس بهم، ونستمد منهم طاقة تعيننا على مواجهة تحديات ومصاعب الحياة، لنصنع منها فرصًا لسلامنا الداخلي، للسلام المجتمعي.. السلام مع أنفسنا ومع من حولنا.
كان علوان يحب وَجْز القول، وفصل الخطاب في الكلام، فقد علمته السياسة المبكرة، كما علمته إدارة الأعمال والنشاط التجاري، الاقتصاد في اللغة، وقول ما يلزم من القول في عبارة موجزة مكثفة، لأنه كان على يقين أن الأفعال والأعمال الطيبة المباشرة هي التي تقربه من الله والناس معًا، فكان ما يريد.
كان يرحمه الله، يعمل من أجل “يومٍ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون”، كما يقول النص القرآني الكريم، ولذلك كان يمشى الهوينى في الأرض، كان يعمل ويقدم على ما ينفع الناس، ويمكث في الأرض، لأن “الزبد يذهب جفاء”، ولذلك عمل مع رفيقة دربه الإسبانية/ اليمنية، والإنسانة، أولًا، لتكون الحياة أجمل، ولذلك عاشا معًا، بتوافق وانسجام كما أرادا من الحياة أن تكون.
كان الإنسان في علوان كبيرًا، ولذلك كان يقول إنه يريد أن يلقى الله “بقلب سليم”، وفقًا لنص الآية القرآنية “يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم”، وليس فحسب بقلب صحيح معافى من العلل، هذا ما سمعته منه كثيرًا من المرَّات، ولذلك كان متصالحًا مع نفسه، كما كان متصالحًا مع الموت، ولم يخشَ الموت يومًا، بل كان يقابله بقلب سليم، مستعدًا له بالإيمان بلا حدود، وبالأعمال الجليلة، التي جعلته قريبًا من الناس، بقدر ما جعلته قريبًا من الله، مثل الصوفي في مراتبه العليا في علاقته بروح الله، حيث كان في حالة رحيل دائم إليه، ولذلك هو الراحل في الحياة بما كسبت يداه.
كان يعمل بالقول القرآني “وما الحياة الدنيا إلا متاعُ الغرور”، ومن هنا بساطته وتواضعه “وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفس بأي أرض تموت” صدق الله العظيم.
فقد هاجر متنقلًا في عواصم الدنيا من أجل التعليم والعمل، وعاد منها ليدفن جسدًا طاهرًا في تراب وطنه، خالدًا في صورة هذا الحضور في الغياب، لأن ما كسبته يداه كان نظيفًا طاهرًا مثل طهارة روحه.
الله ما أروعك وأنبلك أيها الصديق والإنسان الكبير في يوم رحيلك ويوم تبعث حيًا.
علوان إنسان البساطة والتواضع الذي لا تفارق الابتسامة محياه، كان ذا همة عالية، حياته لا تتوقف عن ابتداع المبادرات، والحركة والنشاط. قبل رحيله بأقل من سنة اتصل بي من خارج البلاد، قائلًا: هل تعرف أين أنا الآن؟ أنا في “...”، للبحث عن فرص للحياة، حين تغلق الأبواب أمامنا ما علينا إلا أن نسعى، وهو المعاند والساعي العظيم.
الله ما أروعك يا علوان، علوًا في البقاء وفي الرحيل.
لا أدري لماذا كلما تذكرت علوان يخطر في ببالي -كما سبقت الإشارة- شريط ذكريات يعيدني إلى بعض الأسماء الكبيرة في حياة اليمن الثقافية والوطنية، هل لأنهم أصدقاء كبار ونبلاء نقشوا صورهم حضورًا دائمًا في الذاكرة الخاصة لنا، أو لأنهم من جيل واحد، جيل التضحيات، أو للصفات الذاتية والأخلاقية والوطنية الكامنة فيهم، أو بسبب أدوارهم الجليلة في حياتنا الخاصة والعامة، أو لأن أمثال عبدالحافظ قائد، وعبدالجليل سلمان قد نالهما من الظلم والنكران أكثر مما يحتمله تاريخ القهر من الرفاق (ذوي القربى)، ومن البلاد، وهو ما كان يردده ويشعر به علوان تجاه كل من أحبهم وعرفهم، وخذلتهم الصداقات والأيام، بمن فيهم تحديدًا هذان الاسمان، ولذلك سيبقى دين وواجب الكتابة عنهم/ عنهما وغيرهما، معلقًا على أسنة وألسنة سنان أقلامنا، وبعض من هذا الحديث هو ما كان يدور في بعض حواراتي مع علوان -ومع غيره- حين يتعلق الأمر ببعض الأصدقاء.
إنها عادة الوفاء للأصدقاء ولكل الناس.. حتى وأنت في سماء الخلود يا علوان، تذكرنا بمن تلهينا عنهم هموم وضغوط الحياة.
مثلك أيها الكبير والنبيل علوان قطعًا يبقى حضورًا في الغياب.
وإلى جنة الخلد إن شاء الله مع الطيبين والصالحين والصديقين، علوًا ومقامًا وإقامة.