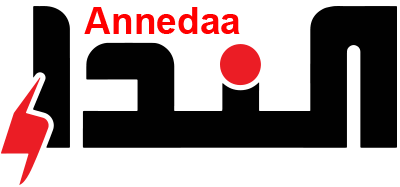كنا نتبادل النظرات ولا شيء غير الصمت تخترقه بعض التنهدات التي كان يقتلعها الحزن من أعماق قلوبنا، مصحوبة بدموعٍ حرّى تحرق أوجاننا، بينما لسان الحال يقول:
أنا من مات ومن مات أنا
لقي الموت كلانا مرتين
كانت الجنازة ترتفع على الأعناق، تمضي مسرعة إلى مرفئها الأخير، وبوابة العبور إلى جنات الفردوس الأعلى، إلى حيث تنتظر ملائكة السماء لروحه النقية والطاهرة، التي كانت تحضرنا في تلك اللحظة التراجيدية في ذاكرة الجميع، ممن حضروا أو تقاسموا معه أفراح الأيام وأتراحها.
لقد تابعت كغيري من المحبين لهذه الهامة الفكرية والوطنية، البيان الصادر من جامعة ذمار، والذي أكد على خسارة الجامعة أحد علمائها وكوادرها الأفذاذ، لكنني رأيت أن الخسارة أكبر من أن يشملها ذلك النص، إذ لم تقتصر خسارة رحيله على الجامعة فحسب، بل على الوطن بكل جغرافيته، بجباله وسهوله، ستفتقده حتى تلك الصخور المنقوشة باللغة السامية التي كان يداعبها بأنامله السحرية لتخبره عن تلك الحضارة السبئية والحميرية العريقة، وتحدثه عن أسماء الأسلاف الذين نقشوا تاريخهم على تلك الصخور، وستحن إليه تلك التماثيل التي كان يقف أمامها فيستنطقها لتحدثه عن وقائع تاريخ الأجداد المجيد، وكيف وطأوا بأقدامهم حضارات وشعوب أخرى في هذا العالم، ونقشوا أسماءهم في صفحات التاريخ.
لقد ترك رحيله المبكر حزنًا أبديًا في جدار الوعي الحقيقي والبحث العلمي للآثار اليمنية، فقد كان عرّاب الآثار في ذمار، وأحد فرسانها في جنوب شبه العربية، وأحد أعمدتها الذي أسهم بشكلٍ فاعل في الحفاظ على الإرث الذي خلفه الأجداد، فأصبح جديرًا بثقة بأن يجعل اسمه ضمن أحفاد ملوك سبأ وحمير.
لقد كان الفقيد مثابرًا نشطًا وذا إحساسٍ مرهف تجاه تخصصه.
ولقد شكل حبه لوطنه وإحساسه بالمسؤولية، وحرصه الشديد على مواصلة مسيرته العلمية والعملية رغم شحة الإمكانيات، ورغم المعاناة التي أرهقت الجميع من أبناء هذا الوطن، والتي لم تستثنِ حتى الأكاديميين وأصحاب الدرجات العلمية، لكن كل تلك الظروف لم تشكل عائقًا أمام مسيرته، ولم تستطع ثني عزيمته وكسر إرادته الفولاذية، فلقد آثر أن تكون مهامه المهنية جزءًا من همومه التي كان يحملها تجاه أسرته وعائلته التي كان يعيش معها ظروفًا قاسية للغاية لا تليق بمستواه الفكري والوظيفي.
فخلال سنوات الحرب ظل الفقيد يعمل بجد في حقل العملية الأكاديمية في كلية الآداب بجامعة ذمار، لتسير كما يجب، وماتزال على عواتق الأكاديميين الحقيقيين الذين وجدوا في التعليم ملاذًا أخيرًا لصناعة وعي المجتمع وبناء الإنسان.
رحل الدكتور خلدون وهو مايزال في وهج عطائه، رحل وقد ترك أثرًا بالغًا وذكرى خالدة وعصية على النسيان من أذهان كل من عرفه، فقد كان صاحب أخلاقٍ حميدة، تغلب عليه البساطة، وتعلوه البشاشة والابتسامة، وحبه لزملائه، لا يميل إلى الخلافات والعداوات والمشاحنات.
كان قريبًا بتعامله مع طلابه، وصديقًا جيدًا لزملائه.
مازلت أتذكر عندما تم تدمير متحف ذمار الإقليمي، كان ضمن اللجنة المكلفة بالتنقيب عن القطع الأثرية التي طمرت تحت مخلفات المبنى، وجمعها وترتيبها وتوثيقها وإعادة حفظها، كان يمضي الليل والنهار متنقلًا بين مكان المتحف المدمر وقسم الآثار بجامعة ذمار، يحرص على لملمة ما خلفه القصف للقطع، وإعادة تركيبها وتجميعها وتأهيلها للعرض على رفوف المتاحف، لتكون شاهدةً على تاريخنا وعلى جهود الفقيد الجبارة والمتميزة.
ولقد شهدت له قبل ذلك شهاداته وخبراته والجوائز التي حصدها في كثير من المحافل الدولية، وكذلك مؤلفاته التي أخذت نصيبها في رفوف المكتبات العامة، وأبحاثه المعتمدة والمحكمة في مجلات دولية.
ويعد مؤلفه "دراسة النقوش العربية الجنوبية من منطقة ذمار"، من أهم الكتب التي صدرت للفقيد، والذي حصل بموجبه على جائزة "الاتحاد العام للآثاريين العرب".
إضافة إلى كونه عضوًا مؤسسًا في فريق المدونة الإلكترونية للنقوش العربية التابع لجامعة بيزا الإيطالية (DASI).
عرف خلدون في الأوساط العلمية العالمية بفضل عشرين نقشًا مؤرخًا قدمها عام 2012م، ضبطت التاريخ السبئي بشكل مذهل.
كما حصل خلدون نعمان على الدكتوراه في اللغات السامية من قسم الدراسات الشرقية والعالم القديم من جامعة بيزا الإيطالية، تحت إشراف البروفيسور الإيطالية أليساندرا أفانزيني، وحصل على جائزة الشيخة إليازية بنت مبارك آل نهيان، 2022م، وكان يعمل حتى تاريخ وفاته أستاذًا في تخصص اللغات السامية بقسم الآثار في جامعة ذمار.
إن من المحزن أنه لم يتذكر الجميع الدكتور خلدون نعمان إلا بعد وفاته، إذ ترك غيابه المفاجئ صدمة للجميع بعد أن انسل من بين أيدينا دون أن نشعر، رحلت يا دكتور خلدون مبكرًا ومبكرًا جدًا، رحلت ومازلت أنتظر زيارتك لمشروعي الصغير الذي كنت أطمح أن تغوص بي إلى عالم الآثار وتاريخ الأجداد، كما كل مرة نلتقي.
رحمة الله تعالى تغشاك، وأسكنك الله فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.