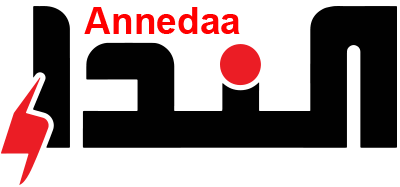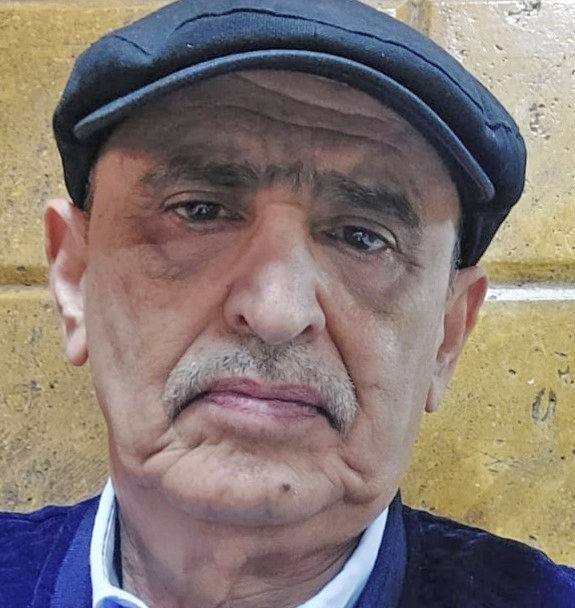من المهم التأكيد أن النظم التعليمية في الدول العلمانية تختلف بتعدد تلك الدول، غير أن بينها قواسم مشتركة تشكل جوهر فكرة الحرية.
التعليم العلماني، بوصفه حاملًا لرسالة وطنية جامعة، يهدف إلى تنمية مواطنين يصعب إخضاعهم، كما عبّر عن ذلك الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل. هؤلاء المواطنون يدركون حقوقهم الأساسية بوضوح، ويتمتعون بوعي نقدي تجاه من يمارسون السلطة، ويملكون الاستعداد الطبيعي للدفاع عن حقوقهم والعمل من أجل العيش المشترك واحترام السلم الاجتماعي.
يتعلم الطلبة في هذا النظام كيف يصبحون مستقلين فكريًا، بحيث لا يحتاجون مستقبلًا إلى المعلم أو الواعظ أو المرشد أو إمام المسجد. إذ يزودهم التعليم بمهارات التفكير العقلي والنقدي، ويمنحهم حرية التأمل والاستنتاج، بهدف تحقيق الغاية الكبرى: بناء مواطن حر ومسؤول.
وقد وصف الفيلسوف الفرنسي ميشيل مونتين هذه العملية بأنها "تأسيس الإنسان الحر في الطفل"، أو بتعبير أدق: تمكين الطفل من تأسيس ذاته بنفسه عبر ثقافة تعليمية ترفض الإكراه الأيديولوجي، والتلقين الديني، والوصاية الروحية.
في التعليم العلماني، لا يمارس المعلم أي شكل من أشكال التبشير. بل يلتزم تمامًا بالفصل بين قناعاته الشخصية وما يجب عليه نقله لطلابه، بخاصة في المراحل المبكرة من التعليم، حيث يكون الطلبة أطفالًا لم يكتسبوا بعد النضج الكافي أو الاستقلال الذهني.
هذا لا يعني مطلقًا إقصاء القيم الدينية الإنسانية المشتركة، كالسلام والحرية والمساواة والحب والإيثار والنظافة، فهي قيم كونية تتفق عليها الأديان جميعًا. لكن الدولة تضع حدودًا واضحة تحول دون تسرب أفكار أية جماعة دينية أو مذهبية إلى المنظومة التعليمية، سواء لأغراض التبشير أو تعزيز الولاء الطائفي.
في هذا الإطار، يُمنح الفكر الإنساني مساحة متوازنة إلى جانب الثقافة الوطنية والتاريخ المجتمعي، استنادًا إلى قيم إنسانية يتقاسمها البشر جميعًا.
نلاحظ أن الخلط بين دور المعلم وبين الدعوة إلى رؤيته الشخصية للعالم، هو إحدى أبرز سمات الأنظمة التعليمية الاستبدادية غير العلمانية؟
من هنا، فإن علمانية التعليم تعني رفض كل أشكال التبشير العقائدي، وكل تعظيم لعقيدة مذهبية، وكل ترويج لأيديولوجيا سياسية. وهي ترفض أيضًا، وبحزم، أية محاولات لفرض الإلحاد أو تسريبه إلى المؤسسات التعليمية.