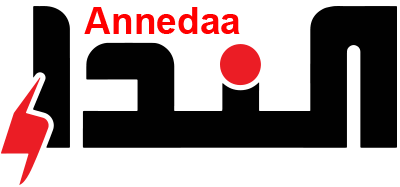الحراك الجنوبي بين الشكل الانفصالي والمضمون الوحدوي
* إلى منصور راجح المنفي قسراً عن وطنه
*طاهر شمسان
يتعذر علينا أن نفسر ظاهرة الوحدة والتجزئة في التاريخ اليمني القديم والوسيط والحديث ما لم نميز تحت مسمى اليمن بين «اليمن الحضاري والثقافي» و«اليمن السياسي». فاليمن الحضاري الثقافي هو نتاج التاريخ المشترك لكل اليمنيين، وهو الذي شكل هويتهم ووجدانهم الوطني عبر آلاف السنين. واليمن بهذا المعنى واحد موحد غير قابل للتجزئة.
فاليمنيون جميعاً من أقصى شمال البلاد إلى أقصى جنوبها ومن آخر قرية في شرقها إلى آخر قرية في غربها، يقفون على مسافة واحدة من الملكة بلقيس وسيف بن ذي يزن وامرئ القيس ومعد بن كرب الزبيدي والسيدة بنت أحمد الصليحي... الخ. فهؤلاء وأمثالهم ليسوا مجرد أسماء عابرة في تاريخهم، وإنما رموز استقرت مع مرور الزمن في الذاكرة الجمعية لليمنيين مثلما استقرت معين وسبأ وحمير وحضرموت... الخ. بهذا المعنى سنطلق على اليمن الحضاري الثقافي في هذا المقال مسمى «الكيان» بما هو مستودع المقدس الوطني «المشترك» لكل اليمنيين الذي أبقى على الهوية اليمنية الجامعة حية تقاوم التجزئة وتؤكد على الوحدة.. وعندما نضع كلمة المشترك بين مزدوجين فإننا نشير مبكراً إلى خطورة احتكار «الوطنية اليمنية» من قبل طرف أو أطراف ضد طرف أو أطراف أخرى في الصراعات الداخلية على السلطة، وتحويلها إلى سلاح سياسي يسوغ استخدام القوة العسكرية أو قوة النفوذ والسيطرة لقهر الخصوم وإقصائهم مادياً ومعنوياً.
أما اليمن السياسي فلم يكن واحداً دائماً. فواحدية الكيان الحضاري الثقافي كانت تفتقر في كثير من الأحيان إلى واحدية التعبير السياسي المهيكل في دولة واحدة.. ففي الأزمنة القديمة كانت الدولة تنشأ عن اتحاد مجموعة من القبائل إذا اختلف أصحاب النفوذ فيها تفككت الدولة وتعددت بالتالي التعبيرات السياسية عن الكيان الحضاري الثقافي الواحد، وبسبب هذا التعدد نشأت ظاهرة عدم الاستقرار داخل هذا الكيان فتراجع اقتصاده واضمحلت حضارته.
عندما قويت شوكة الإسلام بعد فتح مكة لم يكن اليمن مستقراً سياسياً في ظل تعبير سياسي واحد، وكان في معظمه يعيش حالة فراغ سياسي، ولهذا تعددت وفوده إلى يثرب لتصل إلى أكثر من 30 وفداً قاسمهم المشترك الأعظم اليمن الحضاري الثقافي. فهم «أهل اليمن» رغم تعدد مسمياتهم وعصبياتهم القبلية من كندة إلى مذحج إلى همدان... الخ. وقد وجدوا في الفتوحات الإسلامية فضاء جديدا اندمجوا في تياره العام وصاروا جزءاً من نسيجه.
وفي ظل دولة الخلافة الراشدة كان اليمن عبارة عن مخاليف على رأس كل منها «عامل» معين من قبل أمير المؤمنين في المدينة المنورة. وقد استمر الحال على ما هو عليه في زمن الأمويين. وبسبب الصراعات والتحديات التي واجهت دولة الخلافة الإسلامية، شكلت جغرافية اليمن الصعبة عامل إغراء للراغبين في الخروج على بغداد زمن العباسيين، ومن حينها عاش اليمن عصره الوسيط المعروف بعصر الدويلات الذي لم يخل من ظهور تعبيرات سياسية جديرة بمسمى الدولة سواء من حيث الامتداد المكاني والزمني أو من حيث الإنجازات المتحققة على الأرض كما هو الحال مع دولة الرسوليين.
غير أن أهم ملمح ميز العصر الوسيط هو الصراع بين الدويلات التي حكمت اليمن متزامنة أو متعاقبة.. وفي أتون هذا الصراع كانت القوة وليس الجغرافيا هي التي تحدد حدود الدول المتزامنة داخل اليمن الحضاري الثقافي.. فقدرة الدولة على التعبئة والحشد والقتال وكسب الأنصار والتمدد على حساب غيرها هي التي تعين حدودها، وكلما اتسعت مساحة الدولة أي مساحة التعبير السياسي عن الكيان الحضاري الثقافي، ارتفع رصيدها المعنوي في الوجدان الوطني لليمنيين المعاصرين كما هو الحال بالنسبة للدولة الرسولية، ولكن هذا لا يعني أن اليمنيين الذين عاشوا في ظل تلك الدولة وخضعوا لسلطتها كانوا ينظرون إليها مثلما ننظر نحن إليها اليوم. فنحن نراها بعيون اليمن الحضاري الثقافي، ونتعامل معها كماض لم تعد له علاقة بالصراع المادي على السلطة والثروة في حاضرنا، ولهذا نقف حكاماً ومحكومين على مسافة واحدة منها، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لمعاصريها الذين لا يمكن أن ينظروا إليها إلا بعيون اليمن السياسي باعتبارها حاضراً له تأثير مباشر على حياتهم اليومية.
نحن إذن نحكم على الدولة الرسولية من خلال مقولتي الوحدة والتجزئة، وأداة قياسنا قدرتها على التمدد داخل اليمن الحضاري الثقافي أي داخل «الكيان». ومن هذه الناحية هي محل إجماعنا كدولة «أنموذجية».. بينما حكم عليها معاصروها من خلال مقولتي العدل والظلم، وكان نصيبهم من السلطة والثروة والكرامة والاستقرار المادي والمعنوي هو أداة القياس، ومن المستحيل أن يحصل عندهم إجماع عليها. فهذا الشيخ الصوفي الشهير أحمد بن علوان المتوفى سنة 665 هجرية، يصدع –بحق أو بغير حق- في وجه السلطان يوسف بن عمر الرسولي، ويطالبه بالعدل بين الناس على غرار العمرين ابن الخطاب وابن عبدالعزيز.
يا ثالث العمرين افعل كفعلهما
وليتفق فيه منك السر والعلن
واستبق ملكا يقول الناظرون له
نعم المليك ونعم البلدة اليمن
عار عليك عمارات تشيدها
وللرعية دور كلها دمن
في عصر الدويلات كانت التعبيرات السياسية تنشأ وتتطور وتتوسع على قدر حظها من عوامل القوة، ثم يأتي زمن تبدأ فيه عوامل الضعف والاضمحلال التدريجي إلى أن يتلاشى التعبير السياسي نهائياً، ويقوم على أنقاضه تعبير آخر كان هو نفسه أحد عوامل ضعف واضمحلال الأول إن لم يكن أهمها.. ويستثنى من هذه القاعدة «الدولة الزيدية» التي كانت تتوسع على حساب غيرها وعندما يظهر منافس قوي لها تضمحل وتتلاشى ويتراجع حاملها الاجتماعي إلى جبال شمال الشمال حيث كان يجد موطئ قدم دائم يتربص داخله إلى أن تأتي فرصة مواتية فينقض، ولهذا قدر لهذه «الدولة» أن تراوح بين الظهور والضمور حتى عام 1962. ولعل ظاهرة الشباب المؤمن والحوثية التي أخذت منحى عسكرياً في صعدة لها علاقة بهذه المراوحة كدليل على أن النظام الجمهوري أخفق في إحداث قطيعة ثقافية وسياسية مع «الدولة الزيدية» التي يفترض أنه ثار على تقاليدها وقام على أنقاضها. فالنظام الجمهوري في اليمن الشمالي آل إلى صيغة محسنة للإمامة الزيدية من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فهو نسخة منه مع إسقاط حق «البطنين» من شروط الإمامة، وهو الشرط الذي يرفض بدر الدين الحوثي التفريط به باعتباره سلاحاً لا يستطيع أحد في القبيلة أن ينافسه على احتكاره. أما بالنسبة لشرط «العلم» فكثير من أئمة «الدولة الزيدية» كانوا جهلة.
آخر تعبير سياسي استطاع أن يتسيد اليمن الحضاري كله هو «الدولة الزيدية» في عهد المتوكل على الله إسماعيل، ولكن لمدة 42 عاماً فقط (1644 - 1686). وبعدها تفككت اليمن إلى مشيخات وإمارات وسلطنات في الجنوب وإمامات متصارعة في شمال الشمال، بينما استقرت مناطق الوسط تحت نفوذ الوجهاء المحليين الذين لم تتوفر لأي منهم في ما يبدو إمكانيات تأسيس دويلة باستثناء إمارة آل الرصاص في البيضاء التي مثل ظهورها أول خروج على دولة المتوكل على الله إسماعيل في عهد خلفه.
يلاحظ على المشهد السياسي اليمني عبر التاريخ أن التعبيرات السياسية التي قدر لها أن تملأ كامل فضاء اليمن الحضاري الثقافي كانت تعود فتتفكك لصالح تعبيرات أقل شأناً تتزامن وتتصارع داخل هذا الفضاء.. ومن أبرز أسباب هذا التفكك أن هذه التعبيرات كانت تقوم على مبدأ الغلبة والقوة لا على التوافق.. فكل تعبير سياسي كان تعبيراً مهيمناً على الفضاء الحضاري الثقافي لا مجانساً له ولا متوافقاً معه.
ولا شك أن هناك فرقاً كبيراً بين الهيمنة والتوافق. ففي حالة التوافق تتقاطع الجغرافيا مع التاريخ وتتسق الوحدة مع التعدد في عملية تكاملية، ويكون التعبير السياسي محل إجماع نسبي يساعده على الاستقرار ومن ثم الاستمرار.. أما في حالة الهيمنة تشتغل الجغرافيا ضداً على التاريخ ويميل التعدد إلى مقاومة الوحدة فتنهار الدولة.. وهذا ما لم يحدث في بلد مثل مصر التي حكمت دائماً بدولة مركزية واحدة آلاف السنين رغم الطابع الاستبدادي لهذه الدولة التي لم تتأثر واحديتها بتنوع أهل السلطة والنفوذ الذين توارثوا الهيمنة عليها عبر القرون.. ففي مصر كانت الجغرافيا ساندة للتاريخ ونشأ عن هذا التساند أمة متجانسة نسبياً تعيش على ضفاف النيل وبفضله، ولهذا قيل «مصر هبة النيل». أما في اليمن فالجغرافيا كانت دائماً عامل إعاقة للتاريخ، ونشأ عن ذلك مجتمع تعددي رغم واحديته.
الملاحظ في التاريخ اليمني إذن أن «التعبير السياسي» عن «الكيان» الواحد لم يكن دائماً واحداً، وآخر تعبيرين سياسيين تزامنا داخل هذا الكيان هما دولة «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» ودولة «الجمهورية العربية اليمنية». مع فارق أن الجغرافيا وليست القوة هي التي رسمت لأول مرة في التاريخ حدود هذين التعبيرين، وهذا عائد إلى عوامل غير يمنية في المبتدأ، ثم كرسته طبيعة النظام الدولي المعاصر القائم على مبدأ «سيادة الدول» كشخوص اعتباريين وأعضاء في هذا النظام، وأي اعتداء على حدود أي دولة من قبل دولة أخرى هو اعتداء على النظام الدولي برمته.. لهذا لم تكن الوحدة اليمنية ممكنة بواسطة القوة وإنما على أساس طوعي وبالإرادة الحرة لكل من التعبيرين السياسيين اللذين تزامنا داخل الكيان الواحد ضداً على واحديته وذهبا إلى الوحدة للتوافق معها.
ومعنى ذلك أن وحدة 22 مايو 1990 قامت من حيث «المبدأ» و«الاتفاق» على التراضي والقبول المتبادل، وعلى الإدانة «الضمنية» للتعبيرين السياسيين الشطريين «جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» و«الجمهورية العربية اليمنية»، وعلى أنقاضهما لصالح تعبير سياسي ثالث هو دولة «الجمهورية اليمنية» التي أعطاها اتفاق الوحدة وحدها ودون غيرها حق التمدد داخل الكيان وحق السيادة عليه، وهذا يختلف عن الوحدة الألمانية التي قامت على الإدانة «الصريحة» للتعبير السياسي المهيمن على الجزء الشرقي لصالح التعبير السياسي المتوافق مع الجزء الغربي من البلاد. فسكان ألمانيا الشرقية -وليس جيش ألمانيا الغربية- هم الذين حطموا سور برلين وانتصروا لواحدية الكيان الحضاري الثقافي الألماني، ومنحوا التعبير السياسي في الغرب حق التمدد إلى الشرق باسم الأمة الألمانية.. أما في الحالة اليمنية فالشعب كان مغيباً في الشمال والجنوب، وإنما جرى استدعاؤه للخروج إلى الشارع وإظهار التأييد للقيادة السياسية في أجواء احتفالية تسيدتها العاطفية وغابت عنها العقلانية، وكان للقيادة فيها حق الخطابة التعبوية المسطحة، وعلى الشعب واجب التصفيق للقيادة «الملهمة».
لم تقم الجمهورية اليمنية منذ البداية على الاندماج والتلاحم، وإنما نشأت بموجب اتفاق سياسي جمع بشكل ميكانيكي بين حقائق دولتين مختطفتين لكل منهما سلطة غير ديمقراطية.. وطبقاً لاتفاق الوحدة كان على هاتين السلطتين أن تعملا خلال الفترة الانتقالية على نقل حقائق الدولتين من حالة الجمع والتجاور إلى حالة الاندماج والتلاحم. غير أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، والذي حدث أن حقائق الدولتين انتقلتا من حالة التجاور إلى المواجهة العسكرية في حرب صيف 1994، التي اتضح أنها لم تكن ضد الحزب الاشتراكي كسلطة فحسب، وإنما ضده كحزب سياسي وضد الجنوب برمته كدولة لها حقائق جرى التنازل عنها طوعاً لصالح دولة الوحدة التي يجب بمقتضى الاتفاق الوحدوي أن تجانس «الكيان» وتتوافق معه مقابل أن تتنازل دولة المشال عن حقائقها هي الأخرى لصالح دولة الوحدة.
وإذا كانت الأمور في السياسة تقاس بالنتائج لا بالمقدمات، فإن نتائج حرب 1994 أفضت عملياً إلى تدمير كل حقائق دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفرض الحقائق العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية والتربوية والرمزية... الخ لدولة الجمهورية العربية اليمنية على «الكيان»، أي على اليمن الحضاري الثقافي، فصار رمز دولة الشمال «صانعاً للوحدة وحامياً لها»، بينما وضع رمز دولة الجنوب في مربع «الانفصال والخيانة!». وبمقتضى هذه القسمة يكون الشمال أصل الوحدة ومركزها وحاملها الطبيعي وصانعها وحاميها. أما الجنوب فدخيل طارئ عليها ليس بينه وبينها مودة تؤهله للشراكة. فهو يرتمي في حضنها إذا ضاق به الحال ويتمرد عليها إذا اتسع، ولابد من اقتلاع شأفة التمرد بوضعه كلياً تحت وصاية الجمهورية العربية اليمنية مثله مثل محافظات الشمال المضبوطة وفقاً لعقارب ساعة صنعاء.
لقد فرضت الجمهورية العربية اليمنية نفسها بالقوة على «الكيان» ضداً على اتفاقية الوحدة التي أدانت ضمنياً الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ولم تعترف لأي منهما بحق التمدد داخل «الكيان»، ولا بحق انتحال مسمى الجمهورية اليمنية وتسويق نفسها على أنها هي دولة الوحدة.
نحن هنا إذن أمام تعبير سياسي واحد يتسيد داخل «الكيان». ولأن هذا التعبير السياسي قام على الغلبة والقوة لا على التوافق، فهو تعبير مهين على الكيان لا مجانس له ولا متوافق معه.. فنتائج حرب 1994 على مستوى الجنوب تبدو للمراقب المنصف كما لو كانت حرباً مضمرة منذ ما قبل 22 مايو 1990، وإنما جرى تأجيلها إلى ما بعد إعلان الوحدة تحايلاً على النظام الدولي للتغطية على حقيقتها كحرب بين دولتين وتمريرها دولياً كحرب داخلية بين شرعية وحدوية ومتمردين انفصاليين، والمنتصر يكتب التاريخ على حساب الحقيقة، واليمن تفيض بعقول أنتجها تعليم معاق تصدق مجاناً، وبضمئر ميتة تناصر بمقابل.. وهنا بالتحديد تكمن أزمة الوحدة المهددة بالتفكك بما هي أزمة تعبير سياسي مهيمن على الكيان لا متوافق معه ولا مجانس له.. فإذا اتفقنا على أن «الكيان» هو مستودع المقدس الوطني المشترك، فإن التعبير السياسي الملائم له لابد أن يكون من جنسه، وأن يقوم على الشراكة لا على الإقصاء والإبعاد، وهذا ما لا يتوفر في التعبير السياسي الراهن الذي سبق أن هيمن منذ أغسطس 1968 على ما يعرف باليمن الشمالي، ولم يكن متوافقاً معه ولا مجانساً له. وهو بالأحرى غريب عن اليمن الجنوبي ودخيل عليه حتى وإن انتحل مسمى «الجمهورية اليمنية» وسوق نفسه باسم الوحدة.. وهذا ما يفسر ظاهرة «الحراك الجنوبي» الذي أخذت بعض تجنحاته منحى انفصالياً هو في شكله ضد «الكيان» وفي جوهره ضد التعبير السياسي المهيمن على الكيان باسم الكيان.
إن حرب 1994 لم تكن من أجل الوحدة -الكيان، وإنما من أجل فرض حقائق الجمهورية العربية اليمنية كتعبير سياسي مهيمن على الكيان.. لكن الذين خططوا لهذه الحرب وخاضوها أنتجوا خطاباً إعلامياً وسياسياً تضليلياً لشرعنتها. وأخطر ما في هذا الخطاب أنه قام على احتكار المقدس الوطني والديني المشترك، واستخدامه سلاحاً معنوياً فتاكاً للتهيئة للحرب وتكريس نتائجها وخلق رأي عام يقبل بهذه النتائج. ويبدو أن هذا الخطاب حقق نجاحاً ملموساً على مستوى الشمال حيث الأغلبية لا تزال تعتقد أن حرب 1994 كانت مبررة.. والأنكأ من ذلك أن أكبر أحزاب المعارضة الآن لا يزال يكرس هذا الاعتقاد للتغطية على اشتراكه القوي في حرب 1994 تهيئة وتنفيذاً، رغم علمه أن الحاكم الذي يعارضه الآن يستمد معظم شرعيته من اعتقاد أغلبية سكان الشمال بأنه فعلاً صانع الوحدة وقاهر الانفصال. مع أن حربه دمرت ثقافة الوحدة -التي أيقظتها الحركة الوطنية اليمنية وظلت تراكمها وترعاها منذ ثلاثينيات القرن الماضي- وأنتجت ثقافة مضادة لها في الجنوب على الأقل، حيث أصبحت المجاهرة بحب الوحدة والاستعداد للدفاع عنها ضرباً من ضروب المزاودة السياسية المدفوعة الأجر. إذ لا يوجد اليوم جنوبي واحد سليم العقل والحواس يدافع عن وحدة 1994 المعمدة بالدم بلا مقابل.
إن التمجيد الرسمي لحرب 1994 ومجاراة معظم أهل الشمال على مستوى الشارع والنخب لهذا التمجيد ولأكثر من 15 عاماً، ورفعها إلى مستوى «فتح مكة» خلق حالة إحباط عند أهل الجنوب افتقروا معه إلى الشعور بالتضامن والتعاطف من قبل أهلهم في الشمال. وضاعف من هذا الإحباط أن معظم الكتابات والتنظيرات التي تصدت لتفسير نتائج الحرب وانعكاساتها على حياة السكان في الجنوب كانت تنافق المنتصر وتبرر سياساته وتصرفاته في المحافظات الجنوبية، وتلقي باللائمة على المهزوم في حرب 1994، وفي أحسن الأحوال تسميها مجرد «أخطاء» -مع أنها نهج مقصود ومخطط له- وتستكثر على الجنوبيين التعبير عن أوجاعهم بحجة أن المعاناة واحدة والظلم الواقع على المحافظات الشمالية هو نفسه الواقع على المحافظات الجنوبية، وكأن الوحدة لا تستقيم إلا إذا تماثل السكان في الشمال والجنوب مثلما يتماثل الموتى في المقابر!
إن غياب التعاطف الشمالي مع أهل الجنوب أو ضعفه في أحسن الأحوال، وتواطؤ المعارضة مع المنتصر خلق مع الوقت حالة انسداد عند بعض تجنحات الحراك الجنوبي تجلى من خلال التمحور حول الذات الجنوبية والحديث عن جنوب عربي وعن فك الارتباط... الخ. فبدا الحراك كما لو كان موجهاً ضد «الكيان» لا ضد التعبير السياسي المهيمن بالقوة على «الكيان»، وهذا رد فعل طبيعي، لأن العصبية التي تحتكر المشترك الوطني تنتج عصبيات مضادة متمردة على هذا المشترك. ومثل هذا ينطبق على المشترك العقدي، فاحتكار الدين لاستخدامه في الصراع السياسي يؤدي إلى خلق اتجاهات مناوئة للدين، وقل مثل ذلك بالنسبة للدولة التي هي قاسم مشترك بين كل مواطنيها. فعندما يتسيد الحاكم فضاءات الدولة ويخطف الجيش والأمن والمال العام والوظيفة العام، ويكرس كل ذلك لتأبيد سلطته وتجويع خصومه وإثراء حاشيته وإغناء أزلامه على حساب التنمية، ويستقوي على المجتمع وقواه السياسية يتحول العداء للحاكم إلى عداء للدولة يؤدي في بعض حالاته إلى الاستعانة بالأجنبي أو استقدامه أو تمني قدومه. فلكل فعل رد فعل مساوٍ له في القوة ومضاد في الاتجاه.
إن جوهر المشكلة يكمن في تدمير دولة الجنوب المختطفة لا لصالح دولة الوحدة وإنما لصالح دولة مختطفة أخرى هي دولة الشمال التي جرى بعد حرب 1994 إعادة صياغة كل بنيانها لخدمة حقائق التفوق السياسي للحاكم الفرد الذي صنعته ملابسات الصراع السياسي على السلطة في الجمهورية العربية اليمنية منذ ما بعد أغسطس 1968، وساهمت معظم قوى الشمال الفاعلة والمؤثرة في صناعته، ثم تحالفت معه للتنكيل بالحزب الاشتراكي وتدمير دولة الجنوب باسم الوحدة، ومن أجل تعميم ثقافة اللادولة على كل اليمن. وعندما خلت له الساحة أدار ظهره لحلفائه وانصرف نحو مشاريعه الخاصة! وهذا درس بليغ ما لم نتعلمه نحن اليمنيين سنظل ندور في حلقة مفرغة نكرر أزماتنا وحروبنا الداخلية القذرة إلى ما شاء الله.
وأول درس يجب أن نتعلمه أن نسلم بوجود مشتركات لا يحق لأي طرف كان أن يحتكرها لنفسه أو يختطفها لاستخدامها كسلاح سياسي ضد خصومه ومنافسيه في الصراع السياسي. إنها: الدين والدولة والوطنية اليمنية.. فاختطاف الدين معناه تكفير الخصوم السياسيين. واختطاف الوطنية اليمنية يؤدي تلقائياً إلى تخوين الآخر. أما اختطاف الدولة فهو أم الكبائر لأنه اختطاف لكل المشتركات والمقدسات والممتلكات والحقوق والحريات، وتحويل الوطن إلى زنزانة والحاكم إلى سجان مريض نفسياً وعقلياً يتلذذ بعذابات شعبه.
الدرس الثاني الذي يجب علينا تعلمه أن نعيد صياغة بنيان الدولة على نحو نتخلص معه من كل أمراضنا ومشاكلنا التي نصنعها بأيدينا وبدافع من مصالحنا الضيقة الحقيقية أو المتوهمة.. دولة تجتث جذور حروبنا السابقة والحالية والمحتملة.. دولة تقف على مسافة واحدة من كل اليمنيين، وتساعدهم على الاندماج الوطني الحقيقي في عملية التنمية الشاملة، وتمكنهم من العيش كأمة متمتعة بصحة مستدامة.. دولة تنتصر لقيم العدل والتكافل الاجتماعي والحرية والعقلانية والسلام والخير والجمال والكسب الشريف والترقي الشخصي المتسق مع حاجات التنمية.. دولة تحمينا من الغنى الفاحش السفيه ومن الفقر المهين ومن التهميش المذل ومن تسلط بعضنا على بعض أحزاباً ومناطق وقبائل، وتحمينا قبل كل شيء من حماتنا.. وإذا كان في اليمن من يعتقد أن هذه الدولة يمكن أن تكون غير فيدرالية فعليه أن يسلك إلى عقولنا كل طرق الإقناع وسنكون إلى جانبه لأننا لا نريد الفيدرالية لذاتها، وكل ما نستطيع أن نقوله أن الفيدرالية تقطع الطريق على اختطاف المشتركات لتوظيفها في الصراع السياسي.
بقي درس ثالث لا يحتاج كي نفهمه إلى ذكاء خاص، وهو أن الشعوب لا تنهض من أجل التغيير ومن أجل القضايا الكبرى إلا بنخب ناهضة تقودها.. وفي حدود ما نرى وما نعلم أن النخب التي يعول عليها من أجل التغيير منتظمة في إطار اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني.. لكنا نأخذ على هذه النخب أنها تتسول التغيير المستحيل من الحاكم ولا تريد أن تدفع فاتورة التغيير الممكن بالنزول إلى الشارع.. وهي تتوجس خيفة من شعارات الحراك الجنوبي المطالبة بفك الارتباط، وليس لديها استعداد لصناعة حراك شمالي يلتحم مع الحراك الجنوبي في حراك يمني واحد يُشعر الجنوبيين أنهم ليسوا وحيدين، ويزيل بالتالي الشرخ السياسي القائم بين الشارع الشمالي المستسلم والشارع الجنوبي الرافض، ويعيد الاعتبار للتاريخ النضالي المشترك لكل اليمنيين، الذي هو أساس وحدتهم وأهم مكون في يمنهم الحضاري الثقافي.. وإذا كانت وحدة 22 مايو 1990 قد نُكبت لأنها تأسست من أعلى، فإن الحراك اليمني سيعيد تأسيسها انطلاقاً من القاعدة الشعبية ومن أجلها. وفي الوقت نفسه سيكشف عن ألغام كثيرة مزروعة الآن داخل الحراك الجنوبي، وسيبطل مفعولها.
الحراك الجنوبي بين الشكل الانفصالي والمضمون الوحدوي
2009-12-28