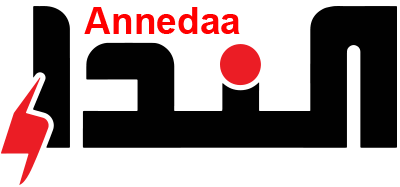في جحيم حرب الإبادة على غزة، والاجتياحات اليومية في الضفة الغربية من الجيش الإسرائيلي، وتمدد الاستيطان، طرحت أمريكا سؤال ما بعد اليوم التالي! وهو السؤال المطروح منذ العام 1947، والقرار 181 لا يعني غير التقسيم، ويتكرر عقب كل حرب.
ونضع اليوم تساؤلات أخرى:
ماذا بعد الانتفاضة الفلسطينية المسلحة في الضفة والقطاع؟
هل الدولتان حل؟
وماذا عن وضع فلسطينيي الداخل -أرض 1948؟
وماذا عن حل لا يأخذ بعين الاعتبار وضعهم في ظل انتقاص المواطنة؟
وما هي رؤيتكم لما بعد حرب السابع من أكتوبر ٢٠٢٣؟
أسئلة طرحتها على قادة الأحزاب السياسية، وقادة الرأي في المجتمعين: المدني والأهلي والفاعليات السياسية وفي صفوف الشباب والمرأة في اليمن والمنطقة العربية.
وما دفعني لطرح هذه الأسئلة هو تسابق الدول الداعمة للحرب أو بالأحرى الأطراف الأساسيين في صنع أداة الحرب الدائمة -إسرائيل، منذ 1948 وحتى اليوم.
وهنا أترك لأصحاب وصاحبات الرأي الإجابة، مع ملاحظة أن البعض أجاب على كل الأسئلة، واكتفى البعض بالإجابة على بعضها.
الشكر والامتنان للعزيز رئيس تحرير "النداء" الصحفي القدير سامي غالب ولصحيفة "النداء" التي يتسع صدر صفحاتها دومًا لكل الآراء، والتي ستنشر تباعًا آراء النخبة اليمنية وردودها على الأسئلة.
هل حَلُّ الدَّولتين استعادةٌ للحق العربي الفلسطيني، أم إقرارٌ بالهزيمةِ العربية؟
نترككم مع أول ردود مع الأستاذ الدكتور أحمد قايد الصايدي:
وهو مفكر ومؤرخ، وعالم اجتماع درس مادة التاريخ كلية الآداب جامعة صنعاء، تولي مناهج البحث في الجامعة له العديد من المؤلفات والابحاث من أهمها رسالته الحركة الوطنية اليمنية قبل 48، والعلاقات اليمنية الألمانية وله العديد من الأبحاث والدراسات، يرأس حاليا جماعة نداء السلام:
عندما قررت دول أوروبية، وعلى رأسها بريطانيا، أكبر قوة استعمارية في ذلك الحين، عندما قررت منح فلسطين للصهاينة، لإقامة دولتهم الخاصة على أرضها وتشريد شعبها، كانت تهدف، في ما تهدف إليه من وراء ذلك، إلى وضع حاجز في قلب الوطن العربي يفصل شرقه عن غربه، ورأس جسر لهيمنتها على المنطقة واستغلالها للثروات العربية، واستئثارها بالموقع الجغرافي المتميز، المتحكم بطرق المواصلات العالمية، البحرية والجوية.
وبعد تجميع أعداد متزايدة من الصهاينة من أنحاء العالم، ولا سيما من البلدان الأوروبية، وتدريبهم وتنظيمهم في عصابات إرهابية، أشهرها الهاجانة (تأسست في عام 1921م) والأرجون (تأسست في عام 1931م) وأشتيرن (تأسست في عام 1940)، أخذت هذه العصابات المسلحة تتنافس في ممارسة أبشع صور الإرهاب بحق الشعب الفلسطيني، فأوغلت في سفك الدماء وتدمير المساكن وحرق المزارع والقرى، ومارست عمليات إبادة جماعية للمدنيين المسالمين، دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل وشاب وشيخ، بهدف إرهاب الفلسطينيين، ودفعهم إلى النزوح عن وطنهم، وتخليهم عنه للغرباء القادمين من شتى بقاع الأرض.
ومن أشهر عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، التي قامت بها المنظمات الإرهابية الصهيونية، والتي دون المؤرخون بعض تفاصيلها: مجزرة بلدة الشيخ (في عام 1947م)، ومجزرة دير ياسين ومجزرة أبو شوشة ومجزرة اللد ومجزرة الطنطورة (أربعتها في عام 1948م)، ومجزرة قلقيلية ومجزرة كفر قاسم ومجزرة خان يونس (ثلاثتها في عام 1956م) ومجزرة الأقصى (في عام 1990م) ومجزرة الحرم الإبراهيمي (في عام 1994م) ومجزرة جنين (في عام 2002م). وتواصلت المجازر وامتدت إلى أقطار عربية أخرى: إلى مصر (إبادة الأسرى المصريين في سيناء بعد انتهاء حرب يونيو عام 1967م، ومجزرتي قرية أبو زعبل ومدرسة بحر البقر في عام 1970م). وإلى لبنان (مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982م، ومجزرتي قانا في عام 1996م وفي عام 2006م). وإلى تونس (مجزرة حمام الشط في عام 1985م).
وشرع الكيان الصهيوني في عمليات اغتيال منظمة. فاغتال العشرات من الرموز والقادة الفلسطينيين، داخل فلسطين وخارجها، من أبرزهم كمال عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار وخليل الوزير وصلاح خلف وغسان كنفاني وأحمد ياسين وياسر عرفات وعبدالعزيز الرنتيسي.
ورغم المجازر المتلاحقة، التي أقدم على ارتكابها الكيان الصهيوني منذ عشرينيات القرن الماضي، والاغتيالات المتكررة للرموز والقادة الفلسطينيين، فإن المستعمرين الغربيين، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، يتعمدون تجاهل هذا كله، وتجاهل تاريخ القضية الفلسطينية، وكأنها بدأت بطوفان الأقصى، في السابع من أكتوبر الماضي 2023م، ولم تبدأ قبل أكثر من قرن من الزمان، بوعد الحكومة البريطانية المشؤوم، على لسان وزير خارجيتها بلفور (في نوفمبر 1917م)، بمنح فلسطين العربية للصهاينة، من مختلف الجنسيات والدول، لإقامة دولتهم الخاصة على أرضها.
وحتى ما حدث في السابع من أكتوبر الماضي وما تلاه، يتعمد المستعمرون أن يروه على غير حقيقته وخارج سياقه التاريخي، ويصرون على تزوير وقائعه وتضليل الرأي العام العالمي، بتقديم صورة زائفة عنه، لإخفاء جرائمهم وجرائم الكيان الصهيوني بحق المواطنين الفلسطينيين، الذين تقتل الآلة العسكرية الصهيونية آلاف المدنيين منهم، خدجًا ورضعًا وأطفالًا، شبابًا وشيبًا، نساءً ورجالًا، وتدفنهم تحت أنقاض بيوتهم وتحت ركام أحيائهم السكنية، في عملية إبادة جماعية هزت ضمائر شعوب العالم، بما فيها شعوب الحكومات الضالعة في جرائم الإبادة الجماعية هذه. فخرجت الملايين إلى الشوارع في مختلف البلدان، تستنكر عمليات الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وتطالب بالوقف الفوري لها، ومحاسبة مرتكبيها وشركائهم وداعميهم. وتحت الضغوط الشعبية على امتداد العالم، عقد مجلس الأمن، الجمعة، 8 ديسمبر 2023م، جلسة خاصة لمناقشة مشروع (وقف فوري لإطلاق النار في غزة، لدواعٍ إنسانية). ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت المشروع، باستخدام حق الفيتو، لتواصل مع الكيان الصهيوني عملية الإبادة الجماعية كما خططا لها، مستحضرة أبشع ما في تاريخها الآثم من عمليات إبادة للشعوب.
وبقدر ما أثبتت المعارك الدائرة في فلسطين والفيديوهات والصور الموثقة بسالة المقاوم الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة، وما يتمتع به من قيم سامية وأخلاق عالية، في معاملة الأسرى لديه، من صهاينة وأمريكيين وغيرهم، أكدت دموية الكيان الصهيوني وإرهابه وهمجيته ونزوعه إلى القتل والتدمير وساديته في معاملة الأسرى الفلسطينيين، وفضحت في الوقت نفسه وحشية ولاإنسانية الحكومات الغربية، المشاركة لهذا الكيان في عدوانه، المبررة لجرائمه، المنكرة لما يرتكبه بحق المدنيين الفلسطينيين من إبادة جماعية ممنهجة وحصار بري وبحري وجوي شامل، ومنع لوصول الغذاء والدواء والماء والكهرباء إلى بشر حُرموا من كل مقومات الحياة.
وهذا لا يقدم مثالًا صارخًا وصادمًا على إرهاب الصهاينة وأحقادهم المزمنة، بمقابل أخلاق الفرسان التي يتمتع بها الفلسطينيون، فحسب، بل يقدم مثالًا على توحش الغرب الاستعماري وانحطاط قيمه وانحراف سلوكه وزيف ادعاءاته وإمعان دوائره العليا وكبار مسؤوليه في ممارسة الكذب والتزييف، دون كوابح أخلاقية أو روادع إنسانية، وبصورة يتأفف منها ويترفع عنها ويخجل من ممارستها الإنسان العادي، مهما كان انحرافه، ومهما بلغ انحطاطه. ولو كنا نعيش في أوضاع طبيعية لخجلنا نيابة عنهم، ونحن نرى أفعالهم ونسمع تصريحاتهم وأحاديثهم، التي تثبت أنهم قوم لا يخجلون.
وقد ظهرت المقاومة الفلسطينية، كحركة تحرر وطني، مسلحة بالحق قبل كل شيء، ظهرت في خط موازٍ للإرهاب الصهيوني الأمريكي الأوروبي المنظم والمدروس. وأخذت تتصدى للمشروع الاستيطاني الصهيوني المحمي غربيًا، وتعمل على استعادة وطنها المغتصب، وسط عالم لا يرحم، منقسم بين متواطئ وداعم، وبين متجاهل لما يرتكبه الصهاينة والضالعون معهم من جرائم ومجازر متواصلة، وما يمارسونه من تضليل للرأي العام العالمي ومن تزوير للتاريخ وترويج للأوهام وتشويه للأحداث والوقائع. وسارع الصهاينة وداعموهم والمتواطئون معهم بإلصاق صفة الإرهاب بالمقاومة الفلسطينية فور ظهورها، كعادتهم في إلصاق هذه الصفة بكل من يقاوم شرورهم، وهم أحق بأن تلصق بهم. فهم صانعو الإرهاب العالمي وأسياده وأساتذته، بالدلائل والوقائع، وبالأحداث التاريخية المعروفة.
ومع اشتداد عود المقاومة الفلسطينية ظهر مشروع جديد لتقسيم فلسطين، نشك في إمكانية تحقيقه، وهو "حل الدولتين"، أي إقامة دولة فلسطينية "قابلة للحياة" كما يقولون، على جزء من فلسطين، استولى عليه الصهاينة في حرب عام 1967م. دولة تُقام بجوار الدولة الصهيونية القائمة فعلًا. ومبعث الشك لدينا في إمكانية تحقيق هذا الحل، يمكن توضيحه في ما يلي:
1. ظهر مشروع التقسيم (حل الدولتين) لأول مرة في شهر يوليو من عام 1937م، على شكل مقترح، تضمنه تقرير اللجنة الملكية البريطانية (لجنة بيل) المكلفة بالتحقيق في أسباب انتفاضات الشعب الفلسطيني المتكررة. وقد تحول ذلك المشروع المقترح في ما بعد إلى قرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر من عام 1947م. وواجه الشعب العربي الفلسطيني، بجماهيره وقياداته السياسية، ذلك المشروع بالرفض المطلق، وتمسك بحقه في تحرير أرضه الفلسطينية كلها. وإذا جازت المقارنة بين مشروعين سيئين، فإنه يمكن القول بأن ذلك المشروع القديم كان أقل سوءًا من مشروع التقسيم الجديد الذي يجري الترويج له اليوم. ورغم أنه كان أقل سوءًا، فقد رفضه الشعب العربي الفلسطيني في حينه، واستمر يتمسك بأرضه كاملة. فهل يمكن أن يكون هذا المشروع الجديد، الأكثر سوءًا من المشروع القديم الذي رفضه قبل ستة وسبعين عامًا، مناسبًا له ولمستقبل أبنائه فعلًا؟
2. هذا الجزء من فلسطين، الذي يجري الترويج لإقامة دولة فلسطينية عليه، كان بيد العرب حتى هزيمة عام 1967م. وكانت إقامة دولة للفلسطينيين عليه حينذاك أكثر سهولة من إقامتها الآن. فلماذا لم يتم ذلك، إذا كان هذا هو فعلًا ما يطالب به الشعب العربي الفلسطيني ويناضل من أجله ويكتفي به؟
3. يبدو الأمر غريبًا، عندما تظهر الأنظمة الحاكمة العربية تمسكها بمطلب إقامة الدولة الفلسطينية على هذا الجزء من فلسطين، الذي فرطت به في عام 1967م، ولم تحسن الدفاع عنه، ونراها اليوم تستعطف عالم أمريكا (الحر) وما يسمى المجتمع الدولي، لإقناع الصهاينة بالسماح للفلسطينيين، طواعية وعن طيب خاطر، بأن يقيموا دولة على هذا الجزء المحدود من وطنهم. دولة ستكون أشبه بإدارة ذاتية تحت الهيمنة العسكرية والأمنية والاقتصادية للكيان الصهيوني. فهل هذا ما يطمح إليه الفلسطينيون؟ وهل يمكن أن يتخلى الصهاينة طواعية عن مشروعهم الهادف إلى السيطرة على فلسطين كلها، إذا لم يُجبروا على ذلك؟
4. تستمر الأنظمة العربية بالمطالبة بإقامة دولة فلسطينية على هذا النحو، وبهذه المواصفات، وهي تعلم أنه حتى لو تحقق مطلبها في إقامة دولة كهذه، جنبًا إلى جنب مع دولة صهيونية مجاورة مستقوية بالدعم الغربي غير المحدود، فإن هذا لا يمثل حلًا نهائيًا لمشكلة شعب اغتُصبت أرضه وأُقيم عليها كيان عنصري، لا ينتمي إلى الأرض العربية ولا إلى تاريخها ولا إلى مجتمعاتها، ولا تؤهله طبيعته وعداؤه الفطري لغيره من البشر للتعايش والتفاعل الإيجابي مع محيطه العربي، وسيستمر وجوده عامل إقلاق وعدم استقرار في المنطقة كلها. وما جرى ويجري اليوم من أهوال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، لهو أكبر دليل على أن هذا الكيان غير قابل بطبيعته للتعايش مع محيطه والعيش بسلام مع جيرانه، وسيبقى عامل إقلاق ومثير حروب، داخل فلسطين وخارجها، حتى يأذن الله بزواله.
5. يصبح الأمر أكثر غرابة، عندما تروج دول استعمارية غربية شاركت في إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين، وواصلت دعمها له والضلوع في جرائمه كلها حتى الآن، يصبح الأمر أكثر غرابة عندما تروج لحل الدولتين، ترويجًا يصعب تصديقه. إذ لو كانت صادقة في ذلك، لاستطاعت أن تفرض هذا الحل على الكيان الصهيوني قبل عقود من الزمن، طالما أن هناك من القيادات الفلسطينية من تعب من النضال وآثر قبول أي حل ينهي مأساة شعبه، على أي وجه من الوجوه.
ولكن هذه الدول لا تهدف من وراء ترويجها لحل الدولتين، إلا تخدير الشعب العربي الفلسطيني، وإضعاف روح المقاومة لديه، وجعله يتعلق بالوهم، حتى يكمل الكيان الصهيوني استيلاءه على كامل الأرض الفلسطينية. وهذا ما يؤكده الإصرار على استمرار التوسع في بناء المستوطنات على امتداد الضفة الغربية، وتؤكده التصريحات التي أدلى بها بعض القادة الصهاينة بضم غور الأردن إلى فلسطين المحتلة، والخطط التي وضعوها لتحقيق ذلك. وعندما يكمل الكيان الصهيوني استيلاءه على كامل فلسطين، سيصبح الاعتراف بالأمر الواقع هو الأرجح، بالنسبة للدول الاستعمارية الغربية، التي ستباركه وتعترف به وتدعمه، وتدفع باتجاه توطين الشعب الفلسطيني في الدول العربية المجاورة، كحل إنساني يليق بإنسانية الغرب الاستعماري المشهود له بها.
وأمام حل الدولتين هذا، الذي تشتد وتيرة الحديث عنه، كلما تأزمت الأوضاع في الداخل الفلسطيني، تقف النخب العربية، السياسية والثقافية والإعلامية، موقفًا مشوشًا ومرتبكًا. فالبعض يبدي اقتناعًا بهذا الحل، على قاعدة "ليس بالإمكان أحسن مما كان". والبعض لا يرتاح له، ولكنه يخشى أن يُظهر موقفه منه، فيبدو كأنه يسبح عكس التيار. وللسباحة عكس التيار مخاطرها وأثمانها، التي لا يقوى على تحملها كثيرون من البشر. فحجم وقدرات القوى المروجة لهذا الحل، والتأثير الطاغي للآلة الإعلامية الصهيونية والغربية، واختراقات الأجهزة الأمنية الغربية للأنظمة العربية الحاكمة ولبعض النخب العربية المؤثرة، تجعل السباحة عكس التيار بمثابة شذوذ وانحراف وخروج على أمر يبدو في الظاهر كما لو أنه يحظى بإجماع عربي وإقليمي ودولي.
فهل المروجون لحل الدولتين جادون في ما يروجون له، وقادرون على فرض هذا الحل على الكيان الصهيوني؟ وهل ترويج النظام الرسمي العربي لهذا الحل يمثل مسعى لاستعادة الحق العربي الفلسطيني، أم هو إقرار بالهزيمة العربية وتكريس لها؟ وهل تملك الحكومات العربية، ولا سيما المطبِّعة منها مع الكيان الصهيوني والمتجهة منها نحو التطبيع، هل تملك المسوغات الأخلاقية، للتعامل مستقبلًا تعاملًا طبيعيًا مع كيان غير طبيعي، ارتكب ويرتكب جرائم الإبادة الجماعية بحق إخوانهم الفلسطينيين، على النحو الذي جرى منذ إنشاء العصابات الإرهابية الصهيونية في عشرينيات القرن الماضي، ويجري اليوم أمام أعيننا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية؟
وهل يُعتبر التمسك بالبديل الآخر، المتسق مع الحق والعدل، وهو استعادة الشعب العربي الفلسطيني وطنه فلسطين كلها، مع عودة الصهاينة إلى أوطانهم الأصلية، وبقاء من يريدون منهم البقاء في فلسطين والعيش فيها كمواطنين، لهم ما لغيرهم من حقوق وعليهم ما على غيرهم من واجبات، هل يُعتبر التمسك بهذا البديل شذوذًا وانحرافًا وإرهابًا؟ وهل نحن كأفراد وهيئات ومنظمات شعبية عربية، ملزمون بأن نجعل موقفنا مطابقًا للموقف الرسمي العربي المتبني لحل الدولتين الوهمي، الذي لا تستطيع الحكومات العربية فرضه على الكيان الصهيوني، أم أننا في حِلٍ منه، وغير مقيدين به، وغير ملزمين بتبنيه والتعبير عنه؟
وأخيرًا: ألا تستحق أسئلة كهذه أن تظل مطروحة وغير مستبعدة، ولو حتى على مستوى التفكير والتداول؟