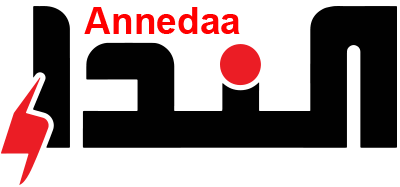الإهداء:
إلى علي محمد خان، الصديق ورفيق رحلة العمر، والقائد الطلابي والسياسي، الحاضر والفاعل في كل التظاهرات الاحتجاجية الطلابية في قلب مدينة تعز، منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وصولًا إلى ساحات المدينة صنعاء.
علي محمد خان، الكبير بدوره وبتفانيه وبقيمه النبيلة، كان قائدًا سياسيًا شجاعًا من طراز فريد.. فدائيًا حقيقيًا ينسى كل همومه وخصوصياته وأشيائه الخاصة، في سبيل من حوله، صاحب نزعة إيثار عجيبة، قل مثيلها في الحياة، لا تستطيع إلا أن تحبه وتحترمه.
علي محمد خان، يذكرك بالفوارس القدماء في تاريخ التضحية والفداء، تجاه وطنهم.
أعتز أنني عرفته، وعشت معه سنوات كان فيها رائدنا، ومثالنا القيمي والنموذج الأخلاقي والإنساني.. عشت معه سنوات كفاح سياسي مدني، في قلب جامعة صنعاء، وفي قيادة "الفرقة الطلابية"، في "حزب الطليعة الشعبية"؛ كان بسلوكه وأفكاره وقيمه نموذجًا يحتذى به في كل شيء، لم أسمعه يومًا يغتاب أحدًا، ما في عقله وقلبه على لسانه، هكذا كان في الحزب، وفي علاقاته الشخصية، وفي الحياة العامة.
اعتقلنا في يوم واحد (٢٨ فبراير ١٩٧٨م)، وكنا قبلها بيوم أو عدة أيام، ندير اجتماعاتنا الحزبية معًا، تحت قيادة الرفيق الفقيد عبدالجليل عبدالمجيد سلمان، أمين عام "حزب الطليعة الشعبية".
خرجنا من السجون المختلفة، باستثنائه، والقائد السياسي والوطني الكبير، سلطان أمين القرشي، والنقيب، السياسي المحنك والمثقف، عبدالعزيز أحمد عون، الذي اعتقل قبلنا بعدة أشهر، ومن ذات الحزب، إلى جانب عشرات المخفيين قسريًا، وعلى رأسهم القائد السياسي النبيل، عبدالوارث عبدالكريم المغلس، الذي تشرفت بمعرفته في السجن "دار البشائر"، لفترة قصيرة، وكان نموذجًا للصلابة والشجاعة التي أخافت سجانيه.
ومطلوب من الحزب، وكافة القوى السياسية، ومن جميع منظمات المجتمع المدني الحقوقية والقانونية، المطالبة بهم جميعًا، ذلك أنهم، قانونيًا وواقعيًا وسياسيًا، مايزالون في عداد المخفيين قسريًا.
للصديق والقائد علي محمد خان، عميق المحبة وخالص التحايا حيث هو الآن، وحتى يعرف ويعلن رسميًا عن مصيره، من الجهات الرسمية المعنية، وجميع الرفاق المخفيين قسرًا، حتى ينظر في كيفية حل ومعالجة قضاياهم ومصائرهم: أين هم بالضبط؟ وكيفية النظر في شأنهم سياسيًا وقانونيًا وحقوقيًا وإنسانيًا، وهذا واجب الجميع تجاههم.
لك صديقي ورفيقي علي بن محمد خان، خالص المحبة والسلام.
إن جماعة "التطبيع الإبراهيمي" إنما يحاولون استكمال السير على ما بدأه السادات في محاولتهم إضفاء طابع ديني "تسامحي" على مشروعهم السياسي التطبيعي الكارثي، أي على طريقة سلفهم السادات حين تحدث عن الأهمية والضرورة لبناء "مجمع الأديان" الذي يجمع في منطقة واحدة المسجد الإسلامي، والكنيسة المسيحية، والمعبد اليهودي، كدليل على "التسامح والسلام"، وهو الذي كان قائمًا ومعاشًا في كل تاريخ المنطقة العربية طيلة قرون، منذ بداية عهد الرسول الكريم محمد (ص)، وتحديدًا من خلال "صحيفة الرسول" أو "صحيفة المدينة" أو تحت تسمية "دستور المدينة" التي خلقت وأنجزت ما يشبه صيغة مواطنة متساوية، متقدمة على كل شروط ذلك الزمان، بل حتى شروط هذا الزمان، في حكم التعامل مع أبناء الأديان المختلفة، وصولًا لحكم المسلمين في الأندلس، وهي أزهى وأبهى وأجمل فترات التعايش والتسامح الديني بين الأديان السماوية المختلفة، وهي الفترة التي يفخر بها أبناء جميع الأديان، وتحديدًا أبناء الديانة اليهودية، وهو ما تحكيه المصادر التاريخية المختلفة.
ودعوة الرئيس أنور السادات، إلى ما سماه "مجمع الأديان"، ليست أكثر من افتعال مشكلة وهمية لا أساس لها في الواقع، هي محاولة بائسة لكي الوعي، ولحرف مسار الصراع والفكر السياسي والاجتماعي عن الجذر الحقيقي للصراع، ومن أن التناقض والصراع مع الكيان الصهيوني لا صلة له بالدين، هو تناقض بين السكان الأصليين، الفلسطينين، وبين مستوطنين، مستعمرين، متجاهلًا -الرئيس السادات- أن المسألة ليست دينية، ولا يدور الصراع مع الكيان الصهيوني على قضية دينية مطلوب الجمع والتقريب في ما بين مكوناتها، بل إن الصراع يجري مع مشروع احتلال استيطاني استعماري، يريد أن يتحول عبر توسيع الاستيطان من احتلال استيطاني، إلى "إحلال"، "تطهير عرقي، وتهجير قسري، أبارتهايد"، صراع يجري حول احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، وأراضٍ عربية أخرى، واستمرار لرفض قرار التقسيم وفقًا للقرار الدولي، في حق الفلسطينيين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو الرفض المستمر حتى يوم الناس هذا، بدعم أمريكي، أوروبي، وليس قرار أمريكا الأخير، نوفمبر ٢٠٢٣م، بالتصويت بـ"الفيتو" ضد إيقاف حرب الإبادة، والتطهير العرقي، ضد أبناء غزة/ فلسطين، سوى تأكيد إضافي لمعنى الإصرار الأمريكي على استدامة الاحتلال ومجازره، وإعلان صريح لرفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي قيام دولته الوطنية المستقلة، وفقًا لحدود الرابع من حزيران/ تموز ١٩٦٧م. الاحتلال الذي مايزال يطمع في استكمال احتلال ما تبقى من الأرض الفلسطينية، بدليل توسع العمليات الاستيطانية، التي توسعت أكثر من بعد عقد اتفاقية "كامب ديفيد"، وحتى اللحظة. ولذلك سقط مشروع السادات حول "مجمع الأديان" الذي كان ينوي إقامته في "واحة" في سيناء. والكارثة أن جماعة "التطبيع الإبراهيمي" الذين أوكل إليهم عبر عصا "ترامب" وصهره "جاريد كوشنير"، تمرير ما تسمى "صفقة القرن" ، يحاولون جاهدين استكمال التفريط ببيع ما تبقى من الأرض الفلسطينية على طريق التصفية النهائية للقضية الفلسطينية، كقضية سياسية وطنية وقومية وإنسانية، يذهبون إلى "التطبيع الإبراهيمي" المجاني، وهم تلك الدويلات التي لا تجمعها بفلسطين حدود، ولا صلة لهم بقضية الصراع العسكري مباشرة، وليس مطلوبًا منهم تحريك قواتهم للدفاع عن الأراضي المحتلة، لأنهم في الأصل لا يملكون "جيوشًا وطنية" للدفاع عن أراضيهم المحتلة، بعد أن صارت أراضيهم محتلة، بالقواعد العسكرية الأجنبية، بحجة حماية عروشهم من شعوبهم، كما هو الحال مع بعضهم.. فكيف بهم في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ ولكنها التبعية المطلقة للاستعمار، والعداء الفاضح لأي أفق ولو بسيط لمشروع عربي قومي تحرري ديمقراطي، حتى وصل بهم الموقف للمعاداة العلنية للمقاومة الفلسطينية، وتصوير المقاومة الفلسطينية "إرهابًا"، ومن أن "حماس" "إرهاب داعشي"، في محاولة لـ"دعشنة" حركة التحرر الوطني الفلسطينية، تحت غطاء العداء لـ"حماس الإخوانية". ولم يكتفوا بذلك، بل يدعمون الكيان الصهيوني سياسيًا في هذا الاتجاه، بل إن بعضهم يشارك في إعمار المستوطنات المحتلة، دعمًا للمستوطنين ضد أصحاب الأرض العرب الفلسطينيين (مسيحيين ومسلمين)، بل في التعاون العسكري والأمني والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، كما هو الحال مع الإمارات! حتى ملاحقة قادتهم وأنصارهم، وإيداعهم السجون، ووضعهم تحت التعذيب الشديد، كحالنا مع محمد بن سلمان، الذي يلاحق قادة المقاومة داخل الأراضي السعودية، ويتآمر عليهم مع الأجهزة الأمنية الأجنبية المعادية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وتحرير أرضه.
ولذلك جن جنونهم بعد عملية السابع من أكتوبر 2023م، التي تحولت إلى عملية فدائية، وإلى انتفاضة ثورية مسلحة، شملت كل الأراضي الفلسطينية، في مقاومة الكيان الصهيوني، وصل من خلالها الصوت والحق الفلسطيني إلى كل العالم.
حاولت جاهدًا أن أجد تفسيرًا مقنعًا ومفهومًا لحالة العداء، بل الكراهية الدفينة لدى حكام الإمارات والسعودية تحديدًا، للمقاومة الفلسطينية، فلم أجد شيئًا له معنى، سوى تبعيتهم المطلقة لأمريكا والكيان الصهيوني؛ لقد بزوا في كراهيتهم وعدائهم للمقاومة، حتى غلاة الصهاينة، فلقد أعطوا الكيان الصهيوني غطاء سياسيًا لكل ما يفعله في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة: غزة والضفة الغربية، وحتى فلسطين 1948م. لا يكفي أنهم يحاصرونهم سياسيًا وإعلاميًا، ولا يدعمونهم ماليًا بشكل جدي وحقيقي، في الوقت الذي يدعم بعضهم الكيان الصهيوني، ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا، بل يجاهرون في تبني الخطاب السياسي والإعلامي الصهيوني والاستعماري في اعتبار المقاومة الفلسطينية حركة إرهابية، بل تنظيمًا "داعشيًا"، كما يفعلون مع حركة التحرر الوطني "حماس".
وجاءت عملية أو انتفاضة السابع من أكتوبر 2023م، لتفضحهم، وتعري مواقفهم وزيف سياساتهم التي تصب في طاحونة الأيديولوجية الصهيونية والاستعمارية. لم يبقَ سوى إعلان قولهم مثل "بايدن" و"بلينكن" و"نتنياهو": إن من "حق إسرائيل الدفاع عن نفسها"! أمام المقاومة الفلسطينية، وإن كانوا يمارسون بالفعل تنفيذ هذا الخطاب في واقع الممارسة.
جاءت عملية أو انتفاضة السابع من أكتوبر لتضعهم في زاوية حرجة من القول والفعل، وكشفت زيف خطابهم ومواقفهم المنحازة عمليًا للكيان الصهيوني، وهو ما زاد ورفع من درجة حنقهم وغضبهم على المقاومة، والانتفاضة التي عرت وكشفت أزمة "التطبيع الإبراهيمي" "صفقة القرن"، التي دخلوها بأمر أمريكي/ صهيوني، متوهمين أن هذا الطريق هو سبيل حفاظهم على عروشهم وعلى استمرارهم في الحكم، ولو على حساب أنبل وأشرف القضايا القومية والإنسانية العادلة في كل التاريخ العالمي، أعظم مظلومية في التاريخ العالمي، وماتزال مستمرة، وهي القضية الفلسطينية التي وقف معها العالم الإنساني، وكل الدول المحترمة التي تمتلك قرارها السياسي والسيادي بيدها، من آسيا، إلى إفريقيا، إلى أمريكا اللاتينية، حتى بعض قادة دول أوروبا، إلا حكام الخليج المطبعين على "الطريقة الإبراهيمية" للتطبيع، تحت غطاء التسامح الديني و"حوار الأديان"، الذي فشل فيه الرئيس أنور السادات الذي دعا -قبلهم- إلى إنشاء "مجمع الأديان" في سيناء/ مصر، كما سبق أن أشرنا.
إن المطبعين "الإبراهيميين" دعاة "الدين الجديد"، يحاولون عبثًا تجريب المجرب الخطأ، وكأنهم ملكيون أكثر من العصابة الصهيونية، أو في مستوى واحد معهم في الرؤية والموقف.
لقد وصل بهم قوس التطبيع المجاني من السادات إلى "الجماعة الإبراهيمية"، إلى منتهاه.. وهنا يجد محمد بن سلمان نفسه، بعد السابع من أكتوبر، في وضع صعب داخليًا وعربيًا، بل مع كل العالم الإنساني الحر، كيف سيذهب إلى التطبيع بعد أن أدانت دول العالم المستقلة والحرة "حرب الإبادة الجماعية" و"التطهير العرقي"، وأعلن رؤساء دول أجنبية قطع علاقاتهم الدبلوماسية والسياسية بالكيان الصهيوني، والاحتجاجات المدنية السلمية من كل العالم تغطي الشوارع؟!
وهو الذي لم يجرؤ حتى اللحظة على إعلان وقف حركة الطيران الصهيوني في سمائه! كيف لابن سلمان أن يذهب للتطبيع، بعد هذه "النازية" و"الفاشية الصهيونية والاستعمارية" التي حولت أرض فلسطين المحتلة إلى موت وإلى خراب، بعد أن هدمت أحياء، بل مدنًا بكاملها على رؤوس ساكنيها، وقتلت عشرات الآلاف خلال شهر ونصف، أكثر من خمسة وعشرين ألف شهيد، وأكثر من خمسين ألف جريح، وحرمت علنًا الشعب الفلسطيني من الغذاء والدواء والماء والكهرباء والوقود، ومئات الآلاف منهم يعيشون ويقيمون في العراء بين صقيع هذا البرد القارس، والمطر، وبين الأوبئة والأمراض الفتاكة، وبعد أن دُمرَت كل المستشفيات، حتى انتشرت الجثث وتحللت في الشوارع، وتحت الأنقاض.. قتل مشهدي علني وتلفزيوني بخلاف لكل القوانين الدولية والإنسانية، مما أرعب وأفزع وأذهل العالم كله.. كيف لابن سلمان العولمي الجديد (النيوليبرالي)، أن يذهب بعد كل ذلك إلى استكمال الحلقة الثانية والأخيرة من جريمة "التطبيع الإبراهيمي"؟! وهي في تقديري الحلقة الأوسخ والأعنف والأخطر، لأن السعودية ليست الإمارات، ولا هي البحرين، ولا هي المغرب، أو السودان المحترب مع بعضه البعض، والذي يبحث عن شرعية من أي مكان، ولو من الكيان الصهيوني، كما هو الحال مع عبدالفتاح البرهان، ورفيقه في تدمير السودان "حميدتي"! ومن هنا حساسية وخطورة التطبيع السعودي، من خلال محمد بن سلمان، الملك غير المتوج اليوم في السعودية، باعتبار المكانة التاريخية الروحية والدينية لمكة المكرمة، وللمدينة، عاصمة الدولة الإسلامية الأولى، باعتبار أن الملك السعودي يسمي نفسه، "خادم الحرمين الشريفين".. فكيف يكون خادمًا للحرمين الشريفين، وهو يدنس قبلة ومقدسات المسلمين بمثل هذا التطبيع، مع من يهين ويدنس ويعتدي على المسجد الأقصى الشريف، وقبة الصخرة، والقدس، والمعادي لكل الأديان!
ومن هنا تأكيدنا على حساسية وخطورة مثل هذه الخطوة المغامرة للأمير (ولي العهد) محمد بن سلمان.. مقامرة لا بد أن تستفز مشاعر المسلمين في كل مكان، وقد تكون سببًا لجر مملكة آل سعود، وكل المنطقة، إلى ما هو أسوأ.
لقد قطعت عملية أو انتفاضة السابع من أكتوبر على محمد بن سلمان حلمه بتتويجه ملكًا على السعودية، وقائدًا للمنطقة العربية من بوابة التطبيع المجاني مع الكيان الصهيوني-كما يتوهم- بقوة المال والتآمر على القضايا العربية، من فلسطين إلى اليمن، ومن هنا حقد "الجماعة الإبراهيمية"، وقيادة المملكة (الشابة العولمية/ النيوليبرالية) تحديدًا على المقاومة الفلسطينية عامة، وعلى حماس خاصة، بل على كل من يتعاطف مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما تمارسه أجهزتهم الأمنية ضد كل من يدعم ويؤيد، ولو بالكلام، المقاومة الفلسطينية، بمن فيهم بعض أئمة المساجد الذين لم يلتزموا بخطاب التطبيع.
كان قتل السادات بسبب تجاوزه كل الخطوط الحمراء الوطنية والقومية والدينية، وكانت مقاطعة الشعب المصري الشاملة والكاملة للتطبيع بكل صوره السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، بمثابة عقاب شعبي مصري له وضد سياساته الداخلية والخارجية.
وأتمنى على ابن سلمان الشاب العجول على امتلاك السلطة/ الملك، ألا يراهن على بعض التخطيطات والمخططات السياسية والأمنية العابرة للاستخبارات العالمية، التي قد تأتي -إلى جانب عوامل أخرى مساعدة- على كل آمال العائلة السعودية في الاستمرار بالحكم، فالسعودية -كما سبقت الإشارة- ليست الإمارات، ولا هي مملكة البحرين، هي، كما يقولون: "خادم الحرمين الشريفين"، فحالة الرفض والمقاومة ضد خطوة ابن سلمان نحو التطبيع، ستكون مختلفة لا تشبه ما قبلها، ليس على مستوى الداخل السعودي، بل من كل الخارج العربي القومي والديني، بل حتى من النطاق الإسلامي الواسع.
أتمنى -ثانية- على ابن سلمان، ألا يغامر ويقامر في هدم وتدنيس المحرمات والمقدسات، وأن يكتفي بالانفتاح الاجتماعي والفني والغنائي والرقص والموسيقى، في نطاق "هيئة الرفاهية الاجتماعية"، ولا يتجاوز الخطوط الحمراء التي ستنقلب عليه عاجلًا أو آجلًا؛ فلا يراهن -كما قلت- على المعطيات والتقارير الأمنية والسياسية الخارجية، التي لن تخدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السعودية، وستفتح أبواب الاضطرابات في داخلها، وفي كل المنطقة، ليس مما يسمى "محور المقاومة"، بل من كل المعارضات لهذا المشروع الصهيوني والاستعماري.
لقد حاول السادات قبلكم إحداث تغييرات فكرية وثقافية وتربوية وتعليمية ونفسية، تغييرات تطال شعور ووجدان وثقافة الشعب المصري والعربي، فوجد نفسه وحيدًا ومعزولًا، دون سند وطني مصري، وبدون سند عربي.
يكفي لابن سلمان أن يقرأ الدلالات السياسية والاجتماعية التي فجرتها العملية الفدائية أو انتفاضة السابع من أكتوبر، التي أجبرت الصهاينة والمستعمرين الجدد، على الرضوخ لشروط المقاومة الفلسطينية، لأن ما يحصل في المنطقة والعالم كله أكبر من أحلام المطبعين "الإبراهيميين الصغار".
أؤكد على ذلك حتى لو تمكن الجيش الصهيوني، بالدعم الأمريكي، من الدخول إلى غزة، وإعادة احتلالها، كما يحلم بعض الحكام العرب المطبعين!
إن العالم أمام تحولات بنيوية وجيوبوليتكية، جيوسياسية/ اقتصادية تطال العالم كله، باتجاه صياغة عالم دولي جديد متعدد القطبية، ومن هنا حساسية وخطورة حركة ابن سلمان في استكمال الحلقة الثانية والأخيرة من مشروع
"التطبيع الإبراهيمي"، الذي قد يأتي على كل مستقبل النظام السعودي برمته، ولو بالتدريج، وعلى مراحل، إن لم يتمكن من قراءة صورة المشهد الآتي بعقل استراتيجي مفتوح على التحولات الإقليمية والدولية.
لقد رفض المجتمع المصري (الشعب) برمته، التطبيع، وقاومه، وأعلن مقاطعته العلنية والواضحة، وكانت المقاومة والمقاطعة على المستوى الاجتماعي والثقافي، واسعة، ومصر الدولة والمؤسسات، وهي من هي! من التاريخ ومن القوة ومن الديموغرافية، ومن الدور والموقع.. فما بالكم مع "دويلات" وممالك لم تتأسس بعد كدول، وبعضها بدون تاريخ، وتبحث عن تاريخ تلفيقي، ومهددة بكل أنواع الاضطرابات والتوترات الداخلية، المذهبية والطائفية والقبلية والسياسية والطبقية والديموغرافية (الاختلالات الديموغرافية، لصالح الكتل السكانية الاجنبية)، ناهيك عما سيأتيها من خارجها العربي، والعولمي.
لقد توهم حملة راية "التطبيع الإبراهيمي" من شيوخ الإمارات، وملك البحرين -وقبلهم السادات- بقدرتهم على تغيير محتوى معطيات الوعي والفكر الصهيوني العنصري القابع في عقل القيادات الصهيونية الحاكمة، غير مدركين أن هذا هو الوهم بعينه، أو أنهم دون أن يعلموا -أو يعلمون- ينتجون رؤية عنصرية مقابلة ومكملة للرؤية الصهيونية والاستعمارية، وتصب في خدمتها أيديولوجيًا وسياسيًا وعمليًا.
إن الجماعة الصهيونية المحتلة للأرض الفلسطينية مشبعة بنصوص أيديولوجية "دينية توراتية"، ومحملة ببنية أيديولوجية عنصرية صراعية، "أيديولوجية مقدسة" أبدية وخالدة، هي أيديولوجية "شعب الله المختار"، لا تقبل بالآخر إلا تابعًا أو مقتولًا (الفلسطيني الميت)، كما تعلنه بعض قياداتهم، أيديولوجية كامنة في عقلهم الباطني العميق منذ نشأتهم المبكرة، وبعدها ينتقل ذلك الوعي والفكر والتفكير للتنفيذ في الواقع، منطق تفكير يجمع بين الأيديولوجي العنصري، وبين القومي، والديني، والطبقي، على طريق قيام "دولة قومية" أساسها ديني، وهي إحدى أخطر مشاكل الكيان الصهيوني.. الكيان الذي يسعى في معاندة مع حقائق الواقع والتاريخ والحياة، في صورة تجميع مستوطنين من أعراق وإثنيات وبلدان مختلفة متناقضة تحت مسمى "القومية اليهودية"! قومية وهمية يجمعهم "الدين السياسي اليهودي الصهيوني"، كـ"قومية افتراضية"، وليس قومية واقعية وتاريخية، كما هو الحال مع كل القوميات في التاريخ العالمي.
وهو ما يمارس منذ أكثر من مائة عام، منها الخمسة والسبعون عامًا من عمر النكبة التي نعيش مراراتها ووحشيتها في صورة ما يجري اليوم في غزة والضفة الغربية، وما يسمى "الخط الأخضر".
إن "كامب يفيد" الساداتية هي أول أخطر المؤامرات على القضية الفلسطينية، وعلى القضية المصرية الوطنية، بل على كل البلاد العربية، وهي التي أفرغت "الأمن القومي العربي"، من معناه، وجردته من مضمونه الأيديولوجي والسياسي والقومي التحرري.. وليس "التطبيع الإبراهيمي" البائس والمجاني في صورة ما تقوم به بعض دويلات وممالك الخليج، سوى الشكل الأكثر بؤسًا وسوءًا كتمظهرات كسيحة للتطبيع الساداتي.. تطبيع مجاني تحاول من خلاله بعض دول الخليج الإعلان عن حضورها واسمها في المنطقة خدمة للمصالح الصهيونية والاستعمارية الغربية، وهو ما يحاول محمد بن سلمان (ولي العهد/ والملك الفعلي) استكمال أخطر حلقاته التي قد تؤدي به وبكل المنطقة إلى الخراب العظيم.. مطبعون يبيعون بالمجان -وليس حتى بالدَّين- كل شيء: الإرادة، والسيادة، والكرامة، والأرض، والاستقلال الوطني، دون مقابل، سوى التأكيد لمزيد من التبعية المطلقة لأمريكا وللكيان الصهيوني، الذين يتوقعون أنه الحامي المستقبلي لهم ولعروشهم ومصالحهم، وجاءت العملية الفدائية أو انتفاضة السابع من أكتوبر 2023م، لتكشف كذب وزيف أسطورة "الجيش الذي لا يقهر" الذي يحاولون الاحتماء به من شعوبهم.
واسمحوا لي في ختام هذا الموضوع، في حلقته الثانية، أن أتشارك معكم في ما كتبه الروائي والكاتب اللبناني، إلياس خوري، في صحيفة "القدس العربي" (٢ أكتوبر ٢٠٢٣م) في قوله:
"هناك تطبيعان: تطبيع شرقي قادته مصر وتبعها الأردن، وهو تطبيع بارد راعت فيه الحكومتان المصرية والأردنية الحد الأدنى من مشاعر الناس.
وتطبيع خليجي قادته الإمارات وتبعتها البحرين والسودان والمغرب، وهو تطبيع ساخن، خصوصًا من قبل الإمارات، كأنهم اكتشفوا قارة جديدة اسمها إسرائيل.
أما التطبيع الثالث الذي نحن على أبوابه، فهو التطبيع السعودي الإسرائيلي. وهو التطبيع الأكثر خطورة، لأنه يهدد بجر العالم العربي بأسره إلى الهاوية"، وهو ما حاولنا قوله في هذه المقالة، في حلقتيها، مع أنني لا أرى التطبيع السعودي باعتباره التطبيع الثالث، كما ذهب إلى ذلك، الكاتب والروائي، إلياس خوري، بل هو الفصل الثاني وقد يكون الأخير من المسرحية العبثية "للتطبيع الإبراهيمي".
إن العملية الفدائية أو انتفاضة السابع من أكتوبر، هي التي وجهت ضربة قاتلة "للتطبيع الإبراهيمي"، وأسقطت أزعومة "الجيش الذي لا يقهر"، باحتجاز أكثر من مائتين وخمسين ضابطًا وجنديًا، وقتل المئات منه بعد أن خفرتهم المقاومة مذلولين، إلى غزة، وهي التي أسقطت آخر ورقة توت عن اتفاقية "أوسلو مدريد" 1993م، اتفاقية "التنسيق الأمني"، التي غيبت صوت المقاومة الفلسطينية، وأضعفت فعلها لأكثر من عقدين، بخاصة من بعد استشهاد القائد ياسر عرفات.
إن انتفاضة السابع من أكتوبر، هي التي وحدت جميع الفلسطينيين حول المقاومة، وهي التي أكدت ورفعت من سقف شرعيتها الوطنية والقومية والعالمية، وأوصلت صوت المقاومة الفلسطينية إلى كل مدن العالم الغربي والعالم كله، وأحدثت تحولًا كبيرًا في الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وهي التي فرضت في الأخير شروطها على الكيان الصهيوني، ومنعت -وماتزال تمنع- تهجير الشعب الفلسطيني ودخوله إلى مرحلة "النكبة الثانية"، وهي بالنتيجة التي أسقطت -حتى الآن- جميع أوراق التطبيع من السادات، إلى تطبيع محمد بن زائد، وصولًا لتطبيع محمد بن سلمان.
هل نستوعب الدرس؟!