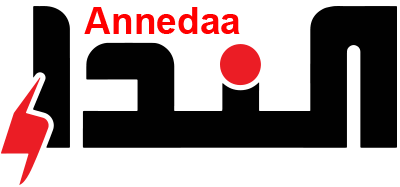الإهداء: إلى عمر بن عبدالله الجاوي، أحد أبرز رموز وأبطال حصار صنعاء، وأحد أهم قيادات المقاومة الشعبية، في كل مراحلها، المقاومة التي صنعت مع الجيش الوطني الحديث ملحمة فجر نصر السبعين يومًا.
لا يمكننا أن نتحدث عن حصار صنعاء في غياب اسم عمر الجاوي، في تقديري أن فك الحصار عن صنعاء هي دقائق وساعات، وأيام عاشها عمر الجاوي لحظة بلحظة، كان في قلب الأحداث مشاركًا وصانعًا ومفكرًا في كل ما يجري، هو أحد أهم العقول السياسية والوطنية، إلى جانب سيف أحمد حيدر، وعبده علي عثمان، وعلي مهدي الشنواح، ومالك الإرياني، وعلي محمد هاشم، وأمين النزيلي، وغيرهم من القيادات السياسية والعسكرية. ارتبط اسم عمر الجاوي بالوحدة وبالسياسة الوحدوية، وبالوطنية اليمنية، وبالثقافة، وتحمل الدور الأبرز والريادي في تأسيس وقيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ويتجاهل البعض اليوم الدور السياسي والوطني المحوري للمناضل عمر الجاوي في صناعة مجد النصر في السبعين يومًا، ومجد الاستقلال الوطني في جنوب اليمن.
إنه الجاوي (عمر بن عبدالله) الذي كتب بدم قلبه، وبمداد نور عقله الناقد مذكرة "المقاومة الشعبية" في رفض وجود "اللجنة الثلاثية" على أرض صنعاء البطلة.. المذكرة التي صوبت الرؤية الضبابية عند البعض، والتي حفزت الناس أكثر على الصمود، وأكدت أن انتصار المقاومين حتمي، لأن اليمنيين قرروا اقتحام السماء مثل أبطال "كومونة باريس"، والتعبير السالف، للأستاذ القائد، عمر الجاوي.
إذا كان عبدالرقيب عبدالوهاب نعمان، هو الرمز القيادي العسكري لفك حصار صنعاء، فإن عمر الجاوي، هو الرمز السياسي والثقافي والوطني، لفك حصار صنعاء.
عمر الجاوي من الأسماء السياسية والثقافية، والوطنية النادرة الفدائية، التي تمتلك جرأة وشجاعة القول، وروح الفداء والتضحية بالذات قل أن تجدهما في إنسان، دون ادعاء، هو بحق رجل سلام ووطنية يمنية، منه تعلمنا أبجدية الوطنية اليمنية الديمقراطية، عاش مقاومًا من أجل السلام الحق، والوحدة الديمقراطية، ومن أجل التعددية، وضد تحويل السلام إلى مجرد شعار للمزايدة الكلامية وكان دائمًا في صف الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته الشخصية والوطنية. لك الرحمة والخلود يا عمر، الإنسان.. المقاوم والفدائي مع الصديقين والشهداء الخالدين.
لقد قمعت المبادرات الشعبية الجماهيرية التلقائية للفلاحين الفقراء في رفض دفع الإيجارات ولطرد رموز المشايخ وشبه الاقطاع، والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا جزءًا من بنية المنظومة الأيديولوجية/ السياسية للإمامة، بعد تصوير تلك الدعوات والتحركات الشعبية الفلاحية العفوية بأنها اشتراكية ومعادية لروح الدين الإسلامي، بل شيوعية، مما جعل عودة المشايخ، وشبه الإقطاع، والقضاة إلى مواقعهم، تتخذ صورة قمعية وعنيفة وشديدة القسوة ضد الفلاحين، والرموز السياسية التي دعمت، وساندت هذه الإجراءات، وصلت حد القتل والسجن، وجلد الفلاحين وقهرهم بصورة أعنف، من قبل المشايخ الكبار، وشبه الإقطاع السياسي (بخاصة في بعض ارياف البلاد الثائرة)، وهو الأمر الذي قطعًا حد -نسبيًا- من اندفاعة الحركة الشعبية والجماهيرية.
وهو -في تقديري- أحد أبعاد وأوجه أزمة قيادة الثورة، وبالنتيجة أزمة تطور العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثورية في قلب ثورة 26 سبتمبر 1962م.
ولذلك لا غرابة -انسجامًا مع ما سبق ذكره- أن يتم تشكيل "المجلس الأعلى لشيوخ القبائل" (شيوخ الضمان) وبدرجة وزير، وبمرتب وزير، وهو ما فتح شهية المشايخ وشبه الإقطاع، ومشايخ الدين السياسي، الذين توافدوا إلى صنعاء من مختلف المناطق القبلية، وهو الإجراء السياسي/ الاقتصادي والطبقي الذي عمل على تمييز مشايخ القبائل عن بقية فئات، وشرائح وطبقات المجتمع، في صورة القرار الجمهوري الذي ثبت في الإعلان الدستوري الذي صدر في 31 أكتوبر 1963م.
ومع ذلك القرار أصدر في 2 يناير 1963م، مرسوم بإنشاء "المجلس الأعلى لشؤون القبائل من 12 شخصًا"(1)، حتى ترسيم وزير لشؤون القبائل، وصولًا لتثبيت ميزانية خاصة مستقلة لشؤون القبائل، بدءًا من بُعيد الثورة مباشرة في العام 1963م، وكلها إجراءات سياسية اقتصادية تصب في اتجاه تعزيز وترسيخ دور ومكانة البنية المشيخية القبلية في قمة السلطة، كمؤسسة سياسية..
فبعد يومين على قيام الثورة، أعلن في 28 سبتمبر 1962م، عن تشكيل "مجلس قيادة الثورة"، وجميعهم من الضباط العسكريين الشباب، والكبار (8 أعضاء). وبعد يومين من إعلان هذا التشكيل، تم الإعلان عن تشكيل جديد "مجلس قيادة الثورة" في 30 سبتمبر 1962م، ضم إلى جانب الأعضاء العسكريين (الثوار) مجموعة وازنة من المشايخ، ورموز شبه الإقطاع، وبقايا الأحرار، وبعض الضباط الكبار، وهم: د. عبدالرحمن البيضاني، القاضي عبدالرحمن الإرياني، القاضي عبدالسلام صبرة، العقيد حسن العمري، الشيخ محمد علي عثمان، عبدالغني مطهر، عبدالقوي حاميم، الملازم سعد الأشول، محمد مهيوب ثابت، علي محمد سعيد، الطيار وعبدالرحيم عبدالله.
بل إنه وفي موازاة "مجلس قيادة الثورة"، القيادة العسكرية الثورية الخالصة، أصدر قرار بتشكيل "مجلس رئاسة" برئاسة الشيخ محمد علي عثمان، وكلها خطوات وإجراءات سياسية تمييزية للقوى السياسية الاجتماعية التقليدية، بل رفعهم إلى قمة السلطة السياسية العليا، وهو الذي أسس ورسخ لاحقًا الدور السياسي المركزي للمشيخة القبلية، وللقبيلة كقوة سياسية اجتماعية في قمة السلطة الجمهورية، وهي قطعًا إجراءات عقّدت من "أزمة القيادة الجمهورية"، أكثر فأكثر، لصالح القوى السياسية الاجتماعية التقليدية، وعلى حساب إزاحة أو إضعاف وتحجيم دور ومكانة القوى السياسية والاجتماعية الحديثة. وفي هذا السياق والجانب، اشتركت القيادة السياسية والعسكرية المصرية في تعزيز وترسيخ مكانة الجناح الجمهوري القبلي..
وكانت المؤتمرات السياسية القبلية المعارضة الأولى هي البداية، بدءًا من مؤتمر "عمران" سبتمبر 1963م، و"خمر" مايو 1965م، والجند، حتى اتفاق "الطائف" أغسطس 1965م في السعودية، لتؤكد وترسخ واقع حالة "ازدواجية السلطة"، في رأس قيادة الصف الجمهوري، ولصالح -بدرجة أساسية- الجناح الجمهوري القبلي.. وعلى حساب وحدة الإرادة السياسية اليمنية.
ولذلك برزت حالة تغيير الحكومات، والوزراء المتكرر، نتيجة للصراعات السياسية في رأس قمة القيادة الجمهورية، وبدأنا نرى خصوصًا من 65/1966م حالة الانشقاقات عن الصف الجمهوري لصالح الجناح الجمهوري القبلي، بعد صعود دور مشايخ القبائل في رأس قمة السلطة..
ولذلك لم نسمع بعد فرض البيضاني، والإرياني -من مواقعهما السياسية المختلفة- لرؤيتهما الأيديولوجية الخاصة، حول المسألة الاجتماعية/ الاقتصادية، أية إمكانية للحديث التنفيذي عن "إزالة الفوارق بين الطبقات"، مع استمرار بقائه كشعار، وكل ما تم، هو إلغاء "العبودية المنزلية"، للإمامة وبعض رموز شبه الإقطاع في بعض المناطق التهامية، ومدينة إب، الذين التحقوا بالإمامة، ومصادرة أملاك بيت حميد الدين، التي استولى على بعضها، البعض من كبار المشايخ "بيت الأحمر" الذين كانوا ضمن "لجنة حصر أملاك بيت حميد الدين"، تأكيدًا لاستمرار حالة وظاهرة "ثنائية الإمامة، وشيوخ القبيلة"، وكأنهم بالفعل "ورثة الإمامة الجدد" -أي شيوخ القبائل- تحول معها بقايا الأحرار اليمنيين تحديدًا بعد انقلاب 5 نوفمبر 1967م، بمن فيهم بعض الشباب التقدميين، عسكريين ومدنيين، إلى ورقة سياسية تحت شعار "الأطراف المعنية"، التي استثمرت جيدًا لصالح جناح أو طرف الجمهورية القبلية، لأنهم في معادلة القوة السياسية والمالية والقبلية، كانوا الحلقة الأضعف في السلطة -أقصد بقايا الأحرار وبعض شباب الثورة..
ومع انقلاب 5 نوفمبر 1967م، الذي وضع على رأسه أحد رموز حركة الأحرار، كرئيس "للمجلس الجمهوري"، في صورة القاضي الإرياني، ورفض الأستاذ أحمد محمد نعمان قبول عضوية المجلس الجمهوري، بعد فترة قصيرة، بل هو لم يزاول أو يمارس أية سلطة أو دور سياسي على رأس ذلك المجلس الجمهوري، فقط، وضع القاضي عبدالرحمن الإرياني كـ"زينة" أو "مشقر"، بعد أن أنجز المهام المطلوبة منه، في إنجاح انقلاب ٥ (خمسة) نوفمبر ١٩٦٧م، والدليل، حالة الاتفاق المؤقت "التكتيكي"، والاختلاف الدائم، مع الجماعة النافذة في سلطة نوفمبر ١٩٦٧م، بدليل تقديم القاضي الإرياني استقالاته المواربة والخجولة المتكررة -للضغط- حتى إعلانه تذمره مما يجري بمغادرة العاصمة صنعاء، إلى تعز، وإلى سوريا/ اللاذقية، وبصورة نهائية، بعد أن اكتشف من خلال تجربته في رئاسة "المجلس الجمهوري"، من ١٩٦٧م إلى ١٩٧٤م، أنه لا يمكن القبول به كرئيس مقرر (حاكم)، لأنه قادم، وآتٍ من خارج العصبية، ومن خارج "دويلة المركز التاريخية"، في صورة "ثنائية الإمامة والمشيخة القبلية"، في تمظراتها الجمهورية، وكان القبول به على رأس قيادة "المجلس الجمهوري"، بصورة مرحلية، ولمهمة محددة، التخلص من الجناح الجمهوري الثوري، ولذلك كان القبول به، كـ"مشقر" على رأس المجلس الجمهوري، لأن "مركز القرار" في مكان آخر، أي أن ورقة ولعبة "الأطراف المعنية" التي اشتغل عليها القاضي الإرياني -وغيره- لم تؤهله/ تؤهلهم، رغم كل ما قدموه/ قدمه، لانقلاب خمسة نوفمبر١٩٦٧م، سوى ليكونوا، ليكون "مشقر/ زينة" على رأس المجلس الجمهوري، وما ينطبق على القاضي عبدالرحمن الإرياني، ينطبق على جميع بقايا الأحرار.
إن معادلة "الأطراف المعنية"، هي موازنة سياسية طبقية/ طائفية/ مناطقية في قمة السلطة الجمهورية تحت شعار "الأطراف المعنية"، "الحكومة العريضة" - كما جاء في أحد البيانات السياسية الهامة لسلطة، خمسة نوفمبر، ١٩٦٧م، يتحكم بها، ويديرها طرف "العصبية" ورموز "دويلة المركز"، ولا صلة لها بالشراكة والمشاركة السياسية ا الفعلية في السلطة.
إن جزءًا هامًا من عدم القبول بالسلال رئيسًا -كما هو في العقل السياسي والطبقي للبعض- يعود لمنبته الاجتماعي/ الطبقي الفقير، "ابن حداد"، وليس من جماعة المشايخ، والقضاء، وشبه الإقطاع السياسي، انظر إلى رأي اللواء عبدالله جزيلان، في كتابه المذكور، حين مناقشته الأمر مع المصريين، ومع الرئيس عبدالناصر، حين قال له ما معناه، أن الشعب اليمني "لن يقبل بحارس أبواب البدر.. وأنه من عائلة كذا.. وصفته كذا،.. وأنهم سيذيعون بين القبائل وشبابها"(٢) ذلك، أي أنهم لن يقبلوا لتلك الأسباب بالسلال رئيسًا للجمهورية، يمكنكم العودة للكتاب المذكور!
كانوا يرفعون شعارات الشراكة والمشاركة في السلطة للاستهلاك السياسي اليومي، ويرفعون في وجه السلال والقوات العربية المصرية، شعارات "الذاتية اليمنية"، وأسطوانة "السلام" و"إيقاف الحرب"، وكأنهما -السلال، ومصر- من فجرا الحرب على الجمهورية! وهدفهم السياسي العميق، استبدال الوجود العربي المصري، بالوجود السعودي "الريع النفطي"، حتى القول عن السلال: بأنه ديكتاتور، وعميل لمصر، ومستبد، لا يقبل بالديمقراطية وبـ"القيادة الجماعية"، وهم تابعون وقابعون في قعر مستنقع الاستبداد، الذي تحكمه وتتحكم به قوى وعقلية مشيخية، وشبه إقطاعية.
ومن هنا غرابة هذه الدعاوى السلاموية، والديمقراطية! في ظروف بلاد ماتزال محاصرة من الخارج، ومن الداخل، وماتزال عاصمتها السياسية صنعاء محاصرة بمنظومة أيديولوجية إمامية، وبـ"القبل السبع"، وهي واحدة من إشكالات عاصمة الثورة صنعاء، في الأمس وحتى اليوم، وأحد أبعاد أزمة قيادة الثورة بالنتيجة، لأن طرفًا أساسيًا في قمة الجناح الجمهوري القبلي، ويستند في قوته إلى ذلك التاريخ من القوى، والقوة السياسية الاجتماعية المتخلفة، لا يمكنه أن يكون في صف التقدم/ المستقبل، ومع فكرة وقضية المواطنة المتساوية، ومع قضية بناء الدولة، وليس المؤتمرات السياسية القبلية التي انفجرت في وجه الثورة من السنة الأولى لقيامها، وما بعدها: عمران (سبتمبر 1963م)، خمر (مايو 1965م) الجند، والطائف (31 يوليو- 10 أغسطس 1965م)، سبأ (3/3/1967م) في منطقة "نهم"، سوى عنوان لتلك الأزمة في قيادة الثورة دون إنكار الدور السلبي للقيادة العسكرية والسياسية المصرية في المساهمة في إنتاج الأزمة في قيادة الثورة طيلة سنوات 62-1967م، بدءًا من فرض حالة من الوصاية على القرار السياسي الجمهوري اليمني، وصولًا إلى قرار منع الحزبية في العام 1964م، وحتى ما بعد ذلك من تحول الحزبية إلى خيانة وجريمة، في قول القاضي عبدالرحمن الإرياني، عن الحزبية بأنها عمالة، وخيانة، في خطابه المشهور في "المدرسة الفنية" (الصينية)، في مؤتمر الخريجين أو الطلاب اليمنيين، وذلك بعد أشهر قليلة من انقلاب 5 نوفمبر 1967م.
ليس في الحديث عن أزمة القيادة الجمهورية، بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، أي انتقاص أو تقليل من دور ومكانة ثورة 26 سبتمبر في حياة اليمن واليمنيين، فقد نقلت ثورة سبتمبر اليمن واليمنيين من تاريخ البدائية والقروسطية الإمامية "الكهنوتية"، إلى رحاب التاريخ المعاصر، من ما قبل التاريخ، إلى فضاء التاريخ الحديث، وأدخلت اليمنيين، ولأول مرة، للمشاركة الفعلية في الإصلاح والثورة والتغيير، بعد قرون طويلة من العيش في العزلة، والجمود والركود والظلام، فقط، التأكيد لمحاولة المساهمة في تقديم قراءة جديدة لأزمة القيادة الجمهورية، ولرؤية الواقع السياسي الاجتماعي بعين الرؤية الموضوعية النقدية التاريخية.
وأعظم دليل ورد على من يتطاولون على الإنجاز السياسي والاجتماعي والاقتصادي والوطني لثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 أكتوبر ١٩٦٣م، هو ما يجري ويحصل في البلاد اليوم، شمالًا وجنوبًا، من محاولة للعودة باليمن القهقرى إلى العصور الوسطى البليدة: في السياسة، والاجتماع، وفي الاقتصاد، مع توقف للتنمية الاقتصادية والإنسانية، وبدون دولة، سوى سلطة تابعة وبدون أية شرعية في كل مناطق الجنوب، وسلطة جبايات مليشوية طائفية، سلالية، في مناطق الشمال، لا تسمية لها في صورة التشكيلات الاجتماعية الاقتصادية التاريخية التي عرفها العالم، سوى القول: إن القاموس السياسي والسوسيولوجي، والفلسفي والاقتصادي، والتاريخي يعجز عن وصف وتسمية ما هو حاصل اليوم في شمال البلاد، سوى أننا أمام "هاشمية سياسية معاصرة"! تريد نقض ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م، بـ"الإمامة"، في صورة الحديث عن ثورة ٢١ سبتمبر ٢٠١٤م.
إن أجمل وأعظم رد على رموز الإمامة البغيضة اليوم، هو رد الفعل العفوي والتلقائي، في الاحتفال بالذكرى الـ٦١ للثورة (ثورة العلم الجمهوري)، التي تحولت إلى استفتاء شعبي وثوري للقيمة الوطنية والواقعية لثورة سبتمبر في وجدان الناس، ورفض للحالة السياسية الإمامية القائمة "الهاشمية السياسية"، في مناطق شمال البلاد، بل وفي جنوبه. وهذا يكفي.
وعودًا على بدء حديثنا، عن أزمة القيادة الجمهورية، في ثورة ٢٦ سبتمبر ١٩٦٢، يمكنني القول: إن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الهجينة والخليط بين أكثر من تشكيلة اقتصادية اجتماعية: بقايا "عبودية منزلية"، واقتصاد شبه إقطاعي، واقتصاد برجوازي تجاري، كمبرادوري (رأسمالية مشوهة وتابعة)، إن هذا الوضع لم يكن بإمكانه بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، سوى إفراز تلك الخلطة التركيبية السياسية والاجتماعية والطبقية المتعارضة، والمتشابكة والمتناقضة في نفس الوقت، وهو ما كان يحول فعليًا دون حدوث فرز أيديولوجي سياسي اجتماعي طبقي واضح، بين أطراف القوى السياسية الاجتماعية المشاركة في الثورة وفي السلطة الجمهورية، بعد انقلاب نوفمبر، وهو ما يشرح ويفسر حالة التذبذبات والتأرجحات في المواقف السياسية بين الأطراف المختلفة "الأطراف المعنية"، وغير المعنية على رأس القيادة الجمهورية، في صورة تلك الانتقالات والإزاحات وحتى الانشقاقات السياسية بين المواقع المختلفة في قمة السلطة الجمهورية، مع السعودية في السر، وضدها في الإعلام (جماعة ٥ نوفمبر)، ومع السلال، وضده في نفس الوقت، في أقل من سنة..
كما كان الحال مع الفريق حسن العمري، وغيره، وهكذا دواليك، وآخرها انتقال واصطفاف مجموعة من النواة السياسية الصلبة التي اصطفت مع الرئيس السلال من أول وهلة للصراع السياسي في قمة السلطة الجمهورية، فوجدت نفسها خلال أيام "مؤتمر الخرطوم/ واللجنة الثلاثية" تنتقل إلى صف الموافقة على "اتفاقية الخرطوم"، بعد انقلاب خمسة نوفمبر ١٩٦٧م، رفضًا لموقف السلال المتشدد والرافض لاتفاقية الخرطوم، وهي مجموعة الوزراء الذين كانوا قريبين من الموقف السياسي المصري -أقصد موقف الرئيس عبدالناصر- وعلى رأسهم العميد محمد الأهنومي، وزير الداخلية، ومحمد عبدالعزيز سلام، وزير الخارجية، ويحيى بهران، وزير الإعلام، والرئيس المؤقت المكلف "للمؤتمر الشعبي الثوري"، وقاسم غالب، وزير التربية والتعليم، ومحمد علي الأسودي، وزير شؤون الجنوب اليمني المحتل(3)، والوزراء المشار إليهم تحول موقفهم ليتطابق مع موقف القيادة المصرية بعد هزيمة حزيران 1967م وخروج الجيش المصري من اليمن..
وهكذا أنتج الوضع الاقتصادي الاجتماعي الخليط الهجين بين أكثر من بنية تشكيلة اقتصادية اجتماعية (هشة، وتابعة ومتداخلة)، على مستوى البناء الفوقي، أنتج تلك الحالة من السيولة السياسية، ومن الاضطرابات والارتباكات في المواقف السياسية -بدرجات متفاوتة- عند وبين الجميع، وهي -في تقديري- حالة وظاهرة كانت حاضرة من بداية العام 67 إلى 1968م، وهي أحد أوجه أزمة القيادة الجمهورية على مستوى السلطة، بين الطرفين: الجناح الجمهوري الثوري، والجناح الجمهوري القبلي، وحلفائه، الذي أنتج سياسيًا وموضوعيًا انقلاب 5 نوفمبر 1967م.
يمكنني القول إن أزمة القيادة الجمهورية السبتمبرية، ولدت في أحشاء بنية النظام السياسي الجديد، وليس كما يرى اللواء عبدالله جزيلان، من "أن أول خطوة للصراع على السلطة في اليمن.. كان من جراء تعيين السلال رئيسًا للجمهورية، والدكتور البيضاني، نائبًا له، خلال غيابه في زيارة للعراق وتونس والجزائر، ومعه القاضي عبدالرحمن الإرياني، وهذه القراءة من اللواء عبدالله جزيلان، هي -في تقديري- وجه من وجوه أزمة القيادة الجمهورية.
ومن المهم والمفيد في هذا السياق، الإشارة إلى أن القوى المحافظة التقليدية كانت هي الأكثر وعيًا وإدراكًا للواقع ولمصالحها التاريخية، من الجناح الجمهوري الثوري، ومن شباب الأحزاب العسكريين والسياسيين الحالمين، الذين وجد البعض منهم، أنفسهم يقفون في صف انقلاب خمسة نوفمبر ١٩٦٧م.
ولذلك رجحت كفة الصراع كفتهم السياسية -أقصد القوى السياسية والاجتماعية المشيخية، وشبه الإقطاعية- ووجد بعض شباب الثورة عسكريين ومدنيين أنفسهم يقفون مع وفي صف انقلاب 5 نوفمبر 1967م.
إن تناقض المعرفة، بالمصلحة في وعي وتفكير وعقل القوى السياسية والاجتماعية الحديثة (عسكريين/ مدنيين)، هو الذي قادهم إلى أن تتناقض معرفتهم (رؤيتهم) الخطأ، بمصالحهم الواقعية والتاريخية، فوجدوا أنفسهم نتيجة لذلك الخطأ في الرؤية/ القراءة، وفي الموقف كنتيجة، يغلبون تعارضاتهم الذاتية (الثانوية)،على التناقض الأساسي، ويقفون ضد مصالحهم السياسية الواقعية والتاريخية، ويصطفون مع انقلاب 5 نوفمبر 1967م، الرجعي في جوهره العميق، أو يسهلون أمر تمريره..
الانقلاب الذي لم يمهلهم طويلًا -عدة أشهر فقط- حتى تخلص منهم بالتدريج، وعلى مراحل، وهو ما يشير إليه، الأستاذ عمر الجاوي، أبرز قيادات المقاومة الشعبية، في كتابه "حصار صنعاء"، وهو -كذلك- ما أشار إليه، ضمنًا، بل وصراحة، اللواء علي محمد هاشم (4) في صورة نقده خطاب القاضي عبدالرحمن الإرياني ضد الحزبية، وفي مساهمة القاضي عبدالرحمن الإرياني، السياسية والعملية، في التخلص من القوى الجديدة، في تشجيع ترحيلهم للجزائر، للتخلص منهم، حسب رأي اللواء علي محمد هاشم، في كتابه، وفي نفس الصفحة.. تخلصوا من البعض غير المرغوب فيهم سياسيًا، ليعود البعض الآخر إلى مواقع السلطة السياسية، والعسكرية، وليتعرض من عاد من أبطال فك الحصار عن صنعاء، ليس للقتل فحسب، بل للسحل في شوارع صنعاء، كما تم مع رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، عبدالرقيب عبدالوهاب، من قبل رموز سلطة ٥ نوفمبر ١٩٦٧م.
ومن المفارقات السياسية العجيبة التي لها صلة بأزمة القيادة الجمهورية، وأزمة تطور العملية السياسية والوطنية، هو أن جميع الأطراف المتصارعة والمشتبكة مع بعضها البعض طيلة سنوات 62-١٩٦٧م، وجدت نفسها جميعًا -بدرجات متفاوتة- مشاركة في انقلاب 5 نوفمبر 1967م -باستثناء الماركسيين المستقلين- أي أنه ليس انقلابًا بعثيًا خالصًا، كما يروج البعض، وهو ما سمعته من القائد السياسي والوطني الكبير عبدالحافظ قائد، ومن حمود ناجي سعيد، قائد قوات المظلات في حصار صنعاء، ومن غيرهما، وهو فعلًا ما يحتاج إلى بحث ودراسة مستقلة.
هذه صورة بانورامية مجردة وعامة، من المهم أن تفتح أمامنا زوايا ونوافد لقراءة جديدة لانقلاب نوفمبر ١٩٦٧م، بل لقراءة الثورة اليمنية: ثورة 26 سبتمبر 1962م، وثورة 14 أكتوبر 1963م.. قراءة جديدة بعيدًا عن الأحكام التعميمية والإطلاقية المجردة "اللاتاريخية"، بإعادة جذر أزمة القيادة الجمهورية، إلى أصلها السياسي/ التاريخي، الذي ألمحنا إليه في الحلقة الأولى من هذه القراءة، وليس إلى دور الرئيس السلال، أو إلى القيادة المصرية كما تقولها بعض أدبيات المؤتمرات السياسية القبلية: "عمران"، "خمر"، "الجند"، "الطائف"، "سبأ"... إلخ.
خلاصة القول: إن الأزمة بقدر ما هي معقدة ومركبة، داخلية وخارجية (إقليمية ودولية)، هي كذلك -وبدرجة اساسية- أزمة ذاتية وموضوعية وتاريخية، والسلال في قلب تلك المعادلة، والقيادة، هو من أنبل وأجمل رموز هذه الثورة بإيجابياتها وسلبياتها، بما فيها مشكلة وخطيئة تسليم الملف العسكري المصري في اليمن إلى المشير عبدالحكيم عامر، وخطيئة تسليم الملف السياسي للسيد أنور السادات.
إن بقايا الأحرار وتحديدًا الأستاذ أحمد محمد نعمان، ومحمد محمود الزبيري، ومعهم شباب الثورة (أبطال الثورة والحصار)، كانوا هم الخاسرين الأعظم -بدرجات متفاوتة ومن مواقع ومواقف مختلفة- لأنهم لم يربحوا سوى الاستشهاد البطولي، والخلود الرمزي في وجدان الشعب (النعمان، الزبيري، وعلي عبدالمغني، ومحمد مطهر زيد، وصالح الرحبي، ومحمد الشراعي [الذي قتله حارس البدر، عبدالله طميم، وهو في دبابته]، والحبشي، وعبدالرقيب عبدالوهاب، ومحمد صالح فرحان، ومحمد مهيوب "الوحش"، وعلي مثنى جبران، وأحمد عبدالوهاب الآنسي، ومحمد فيروز، وطه فوزي، وغيرهم)، ولم ينل من تبقى منهم سوى الخذلان والخسران، والسجون، وهم الذين خرجوا من قلب السياسة والصراع والحرب، ولم يتلوثوا بفساد السلطة والحكم، ولم يشاركوا في لعبة الدم، والقتل، لأنهم كانوا عبارة عن "مشاقر زينة"، في قمة السلطة -أقصد بعض بقايا الأحرار- مثلما دخلوا السياسة والمعارضة والثورة، خرجوا منها بطهارة أرواحهم وسمو نفوسهم.
ولا أرى في استقالات الأستاذ أحمد محمد النعمان المتكررة على اختلافها بين المراحل والمواقف السياسية المختلفة -بصرف النظر عن الأسباب في كل حالات الاستقالة- سوى تعبير عن الاحتجاج الذاتي على ما آلت إليه الأمور.