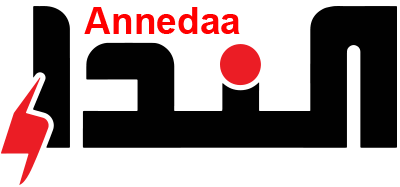الإهداء:
إلى عمر بن عبدالله الجاوي، أحد أبرز رموز وأبطال حصار صنعاء، وأحد أهم قيادات المقاومة الشعبية، في كل مراحلها، المقاومة التي صنعت مع الجيش الوطني الحديث ملحمة فجر نصر السبعين يومًا.
--------------------------------------------------------------------------------
 عمر عبدالله الجاوي(منصات التواصل)
عمر عبدالله الجاوي(منصات التواصل)لا يمكننا أن نتحدث عن حصار صنعاء في غياب اسم عمر الجاوي، في تقديري أن فك الحصار عن صنعاء هي دقائق وساعات، وأيام عاشها عمر الجاوي لحظة بلحظة، كان في قلب الأحداث مشاركًا وصانعًا ومفكرًا في كل ما يجري، هو أحد أهم العقول السياسية والوطنية، إلى جانب سيف أحمد حيدر، وعبده علي عثمان، وعلي مهدي الشنواح، ومالك الإرياني، وعلي محمد هاشم، وأمين النزيلي، وغيرهم من القيادات السياسية والعسكرية.
ارتبط اسم عمر الجاوي بالوحدة وبالسياسة الوحدوية، وبالوطنية اليمنية، وبالثقافة، وتحمل الدور الأبرز والريادي في تأسيس وقيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، ويتجاهل البعض اليوم الدور السياسي والوطني المحوري للمناضل عمر الجاوي في صناعة مجد النصر في السبعين يومًا، ومجد الاستقلال الوطني في جنوب اليمن.
إنه الجاوي (عمر بن عبدالله) الذي كتب بدم قلبه، وبمداد نور عقله الناقد، مذكرة "المقاومة الشعبية" في رفض وجود "اللجنة الثلاثية" على أرض صنعاء البطلة.. المذكرة التي صوبت الرؤية الضبابية عند البعض، والتي حفزت الناس أكثر على الصمود، وأكدت أن انتصار المقاومين حتمي، لأن اليمنيين قرروا اقتحام السماء مثل أبطال "كومونه باريس"، والتعبير السالف، للأستاذ والقائد، عمرالجاوي.
إذا كان البطل الشهيد، عبدالرقيب عبدالوهاب نعمان، هو الرمز القيادي العسكري لفك حصار صنعاء، فإن عمر الجاوي، هو الرمز السياسي والثقافي والوطني لفك الحصار عن صنعاء.
عمر الجاوي من الأسماء السياسية والثقافية، والوطنية النادرة الفدائية، التي تمتلك جرأة وشجاعة القول، وروح الفداء والتضحية بالذات، قل أن تجدهما في إنسان، دون ادعاء، هو بحق رجل سلام ووطنية يمنية، منه تعلمنا أبجدية الوطنية اليمنية الديمقراطية، عاش مقاومًا من أجل السلام الحق، والوحدة الديمقراطية، ومن أجل التعددية، وضد تحويل السلام إلى مجرد شعار للمزايدة الكلامية، وكان دائمًا في صف الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان وكرامته الشخصية والوطنية. لك الرحمة والخلود يا عمر، الإنسان.. المقاوم والفدائي، مع الصديقين والشهداء الخالدين.
إذا كانت أزمة قيادة ثورة 23 يوليو 1952م، هي السبب السياسي المباشر لنكسة أو هزيمة 5 يونيو (حزيران) 1967م، والتي أوصلت مصر/ السادات إلى حالة الردة السياسية والاقتصادية (سياسة الانفتاح الاقتصادي)، وإلى حالة الردة القومية (زيارة السادات إلى الكيان الصهيوني في العام 1979م)، فإن أزمة القيادة الجمهورية في ثورة 26 سبتمبر
1962م، وطريقة إدارتها الخطأ من قبل البعض، هي سبب نكسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 1967م، وهي التي أوصلتنا إلى قتل وتصفية أبطال حصار صنعاء، في جريمة 23/24 أغسطس 1968م، وصولًا إلى الذهاب إلى عقر دار "العدو التاريخي" السعودية، لاستكمال التنازل المباشر عن الإرادة السياسية والوطنية اليمنية، والتنازل الضمني عن الأرض اليمنية المغتصبة، وصولًا إلى ارتهان القرار السياسي اليمني بالكامل للسعودية باسم "اتفاقية المصالحة" جدة، مارس 1970م، وهي بالفعل "مصالحة" وهمية.. هي اتفاقية إذعان وارتهان للعدو الذي حارب جمهورية الثورة طيلة سنوات 62-1969م، اتفاقية "مصالحة" مع العدو.. وما نعيشه اليوم هو استمرار لتلك الأزمة، ولكن في تجليات وتمظهرات سياسية معاصرة، هي الأكثر بؤسًا ومأسوية عما كان، وكأننا نقول: ما أسوأ الليلة، من البارحة، وكأن التاريخ يعيد إنتاج نفسه في صورة مأساة وملهاة معًا.. ملهاة هي تعميق للكارثة/ المأساة.
تمسك الضباط الأحرار في مصر بدور سياسي وتنظيمي للتنظيم العسكري، في الوقت الذي تخلى الضباط الأحرار في اليمن عن أي دور للتنظيم، واستعاضوا عنه في الارتهان لدور الرموز السياسية التقليدية الكبيرة -بقايا الأحرار- في الوقت الذي وظف الضباط الأحرار في مصر الأسماء الكبيرة -على الأقل في سنواتها الأولى الحرجة- لصالح إنجاح الثورة.
لقد تميزت المرحلة الإمامية التاريخية (طيلة قرون طويلة)، بالتخلف السياسي، وبالجمود، والعزلة عن الداخل وعن العالم، وبالركود الاقتصادي، عند حدود "الاقتصاد الطبيعي"، والأهم والأخطر بالعداء لفكرة وقضية بناء الدولة، وكأن الحالة/ الظاهرة الإمامية، لحظة منسية، ومستمرة في الوقت نفسه في التاريخ، هي ما تبقى من تاريخ القرون الغابرة "القروسطية" في التاريخ المعاصر.. متحف للآثار والأوابد التاريخية! حيث وجدت قيادات ثورة 26 سبتمبر 1962م، العظيمة، نفسها أمام مهمات أولية وبدائية لتنظيم المجتمع، ولبناء الدولة من الصفر! فلم تكن هناك مبانٍ عمرانية لما يمكننا تسميته مقرات، ومواقع للحكومة/ والوزارات الموجودة اسميًا، فالإمام يدير أموره من منزله الخاص الذي يصعب عليك تسميته بـ"القصر"، فلم تكن للإمامة كسلطة في كل تاريخها السياسي، دواوين ومؤسسات تشير إلى معنى الدولة، كما كان في زمن الخلافة الإسلامية: الأموية والعباسية، قبل قرون سحيقة.. والمأساة أننا كشعب دخلنا النصف الثاني من القرن العشرين بدون أدنى وجود لمقومات النظام السياسي، ناهيك عن الدولة، فلم تكن هناك محاكم مختلفة للتقاضي، ولا بنية إدارية ومؤسسية لما يمكننا تسميته بالقضاء، كانت "وزارة المالية تجاوزًا" وأوراقها الهامة محفوظة في جيب الإمام الخاص، وموزعة بعض معاملات "الدولة" في جيوب ملابسه الداخلية، وعلى ذلك قس كل أمور السلطة والدولة.. وضع غرائبي يدخل في نطاق "اللامعقول" والخرافة.. انظر ما كتبه أمين الريحاني في كتابه "ملوك العرب"، من رؤية وتحليل لما شاهده في يمن الإمامة الحميدية، وستدرك أنها الخرافة بعينها.. الخرافة تمشي على قدمين!
ومن هنا نفهم ونقرأ مقدمات وتراكمات الأزمة الذاتية والموضوعية والتاريخية في قلب القيادة الجمهورية.. ثورة فجرها ضباط شباب، حالمون "مثاليون" يحملون في أعماقهم تطلعات روح "ثورية رومانسية" للإصلاح والتغيير، ولكن بدون رؤية برنامجية عملية قابلة للتنفيذ، حتى التنظيم الثوري العسكري "تنظيم الضباط الأحرار" تم التخلي عنه مباشرة -كما سبقت الإشارة- بعد إعلان قيام الثورة، وذهبت قياداته الأساسية إلى جبهات المعارك الصعبة، مأرب/ صرواح، صعدة حجة.. إلخ، كما كان الحال مع قائد التنظيم الشهيد علي عبدالمغني، وقبله الشهيد صالح الرحبي، وبعدهما، الشهيد محمد مطهر زيد، وغيرهم، ومن هنا فقدانهم للدور السياسي القائد، والمحرك في قيادة التنظيم العسكري، وبالنتيجة في إدارة السلطة والثورة في قلب العملية السياسية والثورية، بعد أن ارتهن من بقي من الضباط الشباب إلى دور محوري للقيادة التاريخية في صورة "بقايا الأحرار اليمنيين" كزعامات تقليدية تاريخية، وهو ما أشار إليه العديد من الضباط الأحرار في حوارات معهم في كتاب "ثورة 26 سبتمبر"، الصادر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني.. ضباط شباب مثاليون حالمون، دون رؤية لما بعد الثورة. لقد اكتفى الضباط الأحرار الشباب، بإعلان أهداف الثورة الستة، ومبادئ وأهداف الثورة العامة، دون رؤية استراتيجية لما بعد الثورة، حتى أهداف الثورة الستة التي تم الإعلان عنها، على جلالها وعظمتها، لم تجد من ينفذها في واقع الممارسة، بل إن البعض من الضباط الأحرار، وبعد سنوات خمسين من قيام الثورة، يجادل ويساجل حول أن الثورة لم تقل بـ"إزالة الفوارق بين الطبقات"! بل "إذابة الفوارق بين الطبقات"، لأن القول بإزالة الفوارق يعني دعوة اشتراكية، ماركسية، طبقية! وهذا ما قاله وسمعته مباشرة من اللواء حمود بيدر، في مكتب د. عبدالعزيز المقالح، حين كلفت من مجموعة من الضباط الأحرار بكتابة بيان سياسي تاريخي شامل حول الذكرى الذهبية الخمسين للثورة، الذي نشرته الصحف الرسمية للدولة (صحيفة 26 سبتمبر وغيرها)، ومازلت أحتفظ بالنسخة بخط اليد حول ذلك البيان، الذي أصر الغالبية على تثبيت عبارة "إزالة الفوارق بين الطبقات"، وليس إذابة الفوارق...".
إن أزمة القيادة الجمهورية السبتمبرية، وجدت من بعد قيام الثورة مباشرة، وذلك لطبيعة ذلك الخليط العجيب، حد التناقض أحيانًا، بين القوى الاجتماعية الطبقية والسياسية المشاركة في الثورة، باستثناء الضباط الأحرار الشباب الذين أعدوا للثورة حتى تفجيرها، والذين -للأسف- تخلوا بعد الإعلان عن قيام الثورة، عن أي دور قيادي، سياسي أو عسكري لـ"تنظيم الضباط الأحرار"،
وبذلك استكملوا فقدانهم بوصلة الرؤية السياسية والتنظيمية والعسكرية، لصالح القوى التي التحقت بتيار الثورة، لأسباب خاصة بها، في صورة مشايخ القبائل والقضاة وكبار الضباط، وقوى شبه الإقطاع، إضافة إلى بقايا الأحرار، والبرجوازية التجارية والكمبرادورية، الذين رأوا في أنفسهم، أنهم "الورثة" الحقيقيون للإمامة، وتحديدًا مشائخ القبائل، وكأننا استبدلنا الإمام بـ"العكفي" والشيخ، وشبه الإقطاعي المتخلف والمعادي في واقع الممارسة لقضية بناء الدولة المركزية الحديثة.. الشيخ وشبه الإقطاعي المعادين من حيث المبدأ لفكرة المواطنة، التي لا يكون فيها التمييز والتميز، إلا على قاعدة "التقوى"، "المساواة وفقًا للمبدأ القرآني الإسلامي.. وهي وضعية أو حالة، جمعت تاريخيًا بين الإمامة، والمشيخة القبلية، في صورة "ثنائية الإمامة والقبيلة"، ولذلك فإن الصراع أو التعارضات التي كانت تصل حد التناقض داخل قلب الصف الجمهوري، تحددت حول ثلاثة أمور: الأول "العدل الاجتماعي" أو "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، و الأمر الثاني، المواطنة (الحرية السياسية والاجتماعية) ضدًا على الاستبداد والرعوية، والأمر الثالث بناء الجيش الوطني، والدولة المركزية الحديثة.
إن مبدأ أو هدف "إزالة الفوارق بين الطبقات"، وهو هدف ثوري تقدمي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تم التنازل عنه بعد أسبوعين -أو أقل- من قيام الثورة، وحول تنفيذ هذا الهدف والمعنى وصل أكثر مندوب من الرئيس جمال عبدالناصر إلى اليمن، لبحث قضية "الإصلاح الزراعي" بتوزيع خمسة أفدنة للفلاحين المعدمين، وقابل وزير التجارة المصري، حسين خلاف، الدكتور عبدالرحمن البيضاني، لطرح وبحث تنفيذ هذا المبدأ/ الهدف، باعتبار البيضاني، ممثل مصر في اليمن، وهو الذي فرضه الأستاذ أنور السادات والقيادة المصرية على رأس القيادة اليمنية، وكان نائبًا للرئيس السلال في كل مناصبه ومواقعه:
نائبًا لرئيس الجمهورية، نائبًا لرئيس الوزراء، وزيرًا للخارجية، وزيرًا للاقتصاد والتجارة والتعدين، ورفض د. عبدالرحمن البيضاني هذا الرأي والطلب بتوزيع خمسة فدادين للفلاحين المعدمين، والذي كان يمكن أن يساعد بداية في تشكيل نقلة سياسية اجتماعية ثورية في بنية السلطة والمجتمع والدولة الجمهورية، إجراء كان يمكن أن يحدث تغييرًا عميقًا في تركيبة المجتمع الاجتماعية والطبقية، لصالح أوسع فئات جماهير الشعب، حيث الريف يشكل أكثر من 75% من نسبة السكان، ومعظمهم عاملون في الأرض، ورفض وبإصرار د. البيضاني ذلك الأمر بحجج واهية من منظور رؤيته الرأسمالية للعملية الاقتصادية. كما عارض فكرة بناء قطاع عام قوي، وإقامة تعاونيات زراعية(1) إنتاجية، وهو سياسيًا وعمليًا التوجه والرأي المتفق والمنسجم مع رأي ورؤية أنور السادات، الذي نفذه عمليًا بعد انقلابه السياسي والاقتصادي على تجربة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، في مرحلة الرئيس جمال عبدالناصر. وفي هذا السياق، وحول هذا الموضوع، وحتى لا نظلم د. عبدالرحمن البيضاني، ونحمله لوحده كل المسؤولية، فإن هذه الرؤية حول المسألة الاقتصادية الاجتماعية "العدالة الاجتماعية"، تشاركه فيها القوى السياسية والاجتماعية "المشيخية القبلية"، ورموز شبه الإقطاع، وجماعة الإسلام السياسي، وكبار الضباط، فضلًا عن بقايا الأحرار، ومن الضباط الكبار كان يقف ضمنًا مع هذه الرؤية اللواء، عبدالله جزيلان، الذي كان مع دور سياسي محوري لمشايخ القبائل، ومن ضرورة تجميعهم وتوحيدهم سياسيًا في أطر تنظمهم، وتدخلهم للمشاركة في السلطة والدولة، وفي كتابه "التاريخ السري للثورة اليمنية"، ستجد حوارًا له مع الرئيس جمال عبدالناصر، حول هذا الموضوع(2). وتأكيدًا لهذا المعنى، فقد كان د. البيضاني، والقاضي عبدالرحمن الإرياني -مع غيرهما- مع تشكيل "المجلس الأعلى لشيوخ القبائل (شيوخ الضمان)، ومع وزارة لشؤون القبائل، بل إن الإجراءات الجماهيرية/ الشعبية العفوية والتلقائية، وحتى شبه المنظمة، التي تمت بعيد الثورة مباشرة، بطرد بعض مشايخ القبائل والأعيان الكبار، وحكام وقضاة الألوية في بعض المحافظات في المناطق المختلفة:
تعز، إب -وفي غيرهما من المناطق- حيث رفض الفلاحون دفع الإيجارات لمشايخ الأرض، جميع هذه التحركات الشعبية، قوبلت بالرفض والإدانة والمعارضة من المشايخ والقضاة، ومن بقايا الأحرار، وعلى رأسهم القاضي عبدالرحمن الإرياني الذي بعث برسالة يرفض فيها تلك الإجراءات، وطالب الفلاحين بدفع الإيجارات؛ وهي دعوة سياسية وعملية لرفض أية خطوة باتجاه الإصلاح الزراعي (بتوزيع بعض الأراضي على الفلاحين المعدمين)، ولو في نطاق محدود ومن أراضي الدولة، وفي "رسالته -القاضي الإرياني- يطمئن الملاك بأن الثورة لا تهدف إلى الاشتراكية"(3)، ذلك أن الأفق الأيديولوجي/ السياسي/ الطبقي للقاضي الإرياني، وبقايا القضاة التقليديين، ناهيك عن مشائخ القبائل وشبه الإقطاع السياسي وبعض الضباط الكبار الذين لم يكونوا مع هذه الفكرة والقضية، ومن هنا معارضتهم ورفضهم لتحركات الفلاحين الثورية العفوية، وكذا الموقف الموارب من بعض الضباط من مبدأ "إزالة الفوارق بين الطبقات" الذي أعلنته ثورة 26 سبتمبر 1962م، نفسها كما سبقت الإشارة!
بعد أن استغرق الضباط الأحرار الشباب والحركة السياسية الثورية المنظمة دورهم وجهدهم في الدفاع عن الثورة في قلب ذلك الصراع السياسي والاجتماعي "المصالحي"، الذي لم يولوه العناية والاهتمام الكافيين، لأن حرب الدفاع عن الجمهورية استغرقتهم، والعديد منهم استشهدوا في الأيام والأسابيع الأولى للثورة، في تلك المعارك الطاحنة، لأنهم ليس لديهم مصالح "ذاتية" حياتية خاصة بالسلطة، ولأنهم -كذلك- لم تكن لديهم رؤية لما بعد تفجير الثورة، كل همهم انحصر في تفجير الثورة، والتخلص من كابوس النظام الكهنوتي الإمامي "القروسطي".. مع أن الصراع حول الثورة والجمهورية اتخذ أبعادًا سياسية واجتماعية واقتصادية ووطنية وقومية، إقليمية ودولية، فحتى الكيان الصهيوني الإسرائيلي، كان مشاركًا في العدوان على ثورة ٢٦ سبتمبر، وليس مجرد "حرب أهلية" كما تصورها بعض المقالات التي تستسهل الكتابة عن ثورة ٢٦ سبتمبر، وكذلك بعض الكتابات الأيديولوجية الاستعمارية، مثل كتاب المرتزق "ديفيد سمايلي"(٤) الذي يكرر ترديد عبارة ومصطلح "الحرب الأهلية"، لأكثر من أربع مرات، حتى يوحي لمن يقرأ ما يكتب أننا أمام مشكلة داخلية، صراع بين الجمهوريين، أو بين الجمهوريين وبقايا الإمامة!
وهنا من المهم الإشارة، ونحن بصدد الحديث عن أزمة القيادة الجمهورية، في ثورة ٢٦ سبتمبر، إلى أن الصراع (الناصري/ البعثي/ المصري/ السوري/ البعثي/ الحركي)، قد لعب ليس دورًا سلبيًا فحسب، في تعقيد الأزمة في رأس القيادة الجمهورية، بل هو دور خطير في تعويق مسار تطور العملية السياسية والثورية في كل البلاد شمالًا وجنوبًا بعد ذلك.
الهوامش:
1- د. محمد علي الشهاري، "مجرى الصراع بين القوى الثورية والقوى اليمنية"، مطبعة 14 أكتوبر/ عدن، 1990م، ص49-50.
2- عبدالله جزيلان، "التاريخ السري للثورة اليمنية"، دار العودة/ بيروت، 1/2/1977م، ص155.
3- د. محمد علي الشهاري، "مجرى الصراع بين القوى الثورية والقوى اليمنية"، ص53.
4- ديفيد سمايلي، "مهمة في جزيرة العرب"، ترجمة: حامد جامع، جزء 2، اليمن، إصدار اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين، عدن، ص9+13.