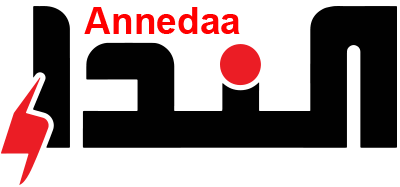وفي هذا الحوار ا الذي أجرته "النداء" معه، يثير أحمد السلامي الأديب والشاعر والروائي والصحافي والناقد، بشجاعة أدبية، الكثير من القضايا الأدبية والثقافية، وشيئًا من القضايا السياسية، وهو الذي عُرف كثيرًا بمواقفه الواضحة المناهضة للاستبداد السياسي.
عمل السلامي محررًا ثقافيًا في عدد من الصحف والمجلات في صنعاء، وأدار تحرير مجلة "الثقافة"، ومجلة "صيف"، وأسس موقعًا على شبكة الإنترنت باسم "عناوين ثقافية"، وأصدر أربع مجموعات شعرية هي: حياة بلا باب، ارتباك الغريب، دون أن ينتبه لذلك أحد، وقدِّيس خارج اللوحة. وهذا الإصدار الأخير، احتفى به مؤخرًا عدد من النقاد والأدباء والكتاب في شبكات التواصل الاجتماعي.
لدى السلامي، أيضًا: كتاب جمع فيه مقالات وقراءات في تجارب بعض أدباء جيل التسعينيات في اليمن، بعنوان: "الكتابة الجديدة.. هوامش على المشهد الإبداعي التسعيني في اليمن". له أعمال أخرى (سردية ونقدية وشعرية) غير منشورة، بينها رواية.
حوار - محمد الصُّهباني:
متى بدأ الشاعر أحمد السلامي يكتب شعرًا؟
قراءات البدايات كانت عندي أهم وأفضل من كتابات البدايات، حيث انتقلت من ريف صنعاء إلى العاصمة، وهناك اكتشفت كنز دار الكتب، وأنا في الـ15 بدأت بقراءة أعمال نزار قباني الذي أغرمت بأسلوبه وببساطة قاموسه وذكاء نبرته المباشرة في مخاطبة الجمهور، وكان أمين مكتبة دار الكتب يتذمر ويستغرب من انتظام طالب صغير في المكتبة، وبحثه عن كتب غير مناسبة لسنه، وبخاصة أنني انتقلت من نزار إلى نازك الملائكة، ثم إلى بدر شاكر السياب، ثم أدونيس، ولم يعجبني الأخير في البداية أو لم أفهمه، ثم اكتشفت أُنسي الحاج، وبدأت الكتب تدل على كتب غيرها، والأسماء ترشد إلى أخرى. وقرأت في البدايات ما أدهشني في النقد، مثل كتاب الشاعر كمال خير بك "حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر".
كما أعجبني التموسق في شعر التفعيلة منذ قراءاتي الأولى، وحتى الآن رغم كتابتي لقصيدة النثر وتوسع قراءاتي فيها، أستطيع اكتشاف أي خلل في الوزن أو اعتساف للتفعيلة يظهر نشازًا في القصائد الموزونة.
وقادتني علاقتي بموسيقى الشعر إلى العزف على آلة عود، حيث أجيد الأساسيات إلى حد ما، وإن كنت غير محترف، وأدين لهذه العلاقة التي نشأت بيني وبين الموسيقى، للريف والراديو والأغاني، وبيئة القرية المموسقة التي يمتزج فيها كل عمل بالغناء والأصوات والإيقاعات التي تدوزن الحياة من حولك، وتجعلك تحمل حس التموسق في ذاكرتك. لكني مع ذلك تمكنت من الفصل بين الشعر والموسيقى، وكتبت قصيدة النثر، وعندما أقرأ قصيدة موزونة أحتاج إلى مطالعتها أكثر من مرة، بحيث أستمتع في المرة الأولى بموسيقى النص، وفي القراءة الثانية أبحث عن الشعر العاري بعيدًا عن المؤثرات الإيقاعية والضجيج.
من هو الشاعر برأيك؟ وما رسالته؟
حدث انزياح وتحول في تعريف الشاعر ووظيفته، فقديمًا كان الشاعر في ثقافتنا العربية لسان حال قومه، فهو المؤرخ والراصد والمدون والموثق والشاكي والمحفز والعاشق والحكيم والصعلوك، وصاحب مهام أخرى مثل الرثاء والمديح والبكاء على الأطلال، وعلى مر القرون كانت بعض وظائف الشعر والشاعر تختفي أو تتراجع حسب زمنه، واليوم الشاعر كائن شبه منقرض يشعر بغربة داخل المجتمع وداخل حقل الأدب، وفي مشهد الطباعة والنشر والجوائز والإعلام ومعارض الكتب.
أظن أن الشاعر هو المتأمل المصغي بصمت رهيف لجوهر ما يحدث في عالمه الصغير والكبير، ورسالته معنية بالتدوين ليخبر نفسه أولًا أنه مازال حيًا وشاهدًا على ما يجري حوله من عبث أو ما يشع من جمال أو ما يقطر من عرق أو ما تُسمع من صرخات الألم. وأخيرًا -وهذا هو الأهم- عليه أن يكتب ليترك أثرًا لقراء محتملين سوف ينقبون الحفريات الشعرية في المستقبل.
الشاعر أحمد السلامي القادم من جبال اللوز في خولان، حسب وصف أحد الكتاب، فمن صنعك شاعرًا: الريف أم المدينة؟
جبل اللوز في خولان، حيث ينتمي الأجداد كما قيل لنا، والريف صنع إحساسي بالموسيقى، وعرفني على قيمة الأداء الجماعي للغناء في الحقول والأعراس، حيث ممارسة الفرح أو الحزن لا تكون إلا بصورة جماعية، بينما المدينة ألهمتني كيف أغني بمفردي، وكيف أكتب وحيدًا، وأعزف وحيدًا، وأبني كينونة فردية، وأختار ما أريد من الفرح والحب والإيمان والفكر.
هل أنت شاعر، أم ناقد، أم صحافي، أم كاتب؟ وأين تجد ذاتك بين كل هذه الصفات؟
لا أقلق من اختفاء لقب الشاعر، ولا أحاول أن أُكرس نفسي كما يفعل البعض، ويجتهدون بإلحاح في الحفاظ على هذا اللقب، وأشعر بحرية أكبر عندما أنتمي للكتابة من عالمها الفسيح. وبالطبع لست صحافيًا متفرغًا لهذه المهنة، وإن كان مصدر عيشي وعملي المهني حتى في غربتي، قائمًا على العمل الذي لا يخلو من استخدام عدة الصحافة وقوالبها.
لذلك أفضل الكاتب أكثر من أية مهنة أو صفة أخرى، لأن مهنة الشاعر صعبة للغاية، ومحصورة في فن تكثيف الكلمات والمعاني والصور والأحزان والمسرات والتأملات والاستبطان الداخلي والرؤية للماحول، بينما مساحة الكاتب أوسع وأشمل، وأشكال الكتابة تحت هذا التوصيف غير مقيدة، حيث يمكنك أن تكتب رواية أو مراجعات أو مقالات أو قصصًا أو نقدًا، وصفة الكاتب جامعة لكل ما سبق، وأجد نفسي فيها، أو بالأحرى أتمنى أن أكون كذلك، لأستمتع بحرية الكتابة بدون قيود أو تأطير.
أين تجد نفسك تسلسلًا في قائمة شعراء اليمن الحداثيين؟
لست مهتمًا بالتموضع في نقطة أو في ترتيب محدد، ولستُ في منافسة مع أحد سوى نفسي، ولدي إيمان راسخ بأن الإبداع فردي، وأن من ينتمي للإبداع لا يحتاج إلى أن يحسب بالضرورة على مجموعة، أو أن يقف ضمن طابور ليحصل على شرعية لإبداعه. كما أجد نفسي محبًا لكل من يتميز من أبناء جيلي، بشرط أن يتحلى بالتواضع، وأن تكون نفسه كريمة، وأن تكون روحه عند مستوى اللغة والفن الجميل، وبالطبع أن يكون مؤمنًا بحرية الإبداع والمبدعين، وأن يستوعب التمايز والاختلاف والتنوع، أما أولئك الذين يشعرونك بأنهم في الأصل كانوا قطاع طرق، لكنهم تثقفوا، وتمكنوا من إجادة مهارة العبث بالكلمات، فإنهم يظلون من وجهة نظري قطاع طرق وغوغاء و(بلاطجة) تسربوا إلى عالم الأدب عن طريق خطأ غير مقصود.
وهذا النوع من الهمجيين والعصابيين الذين تسللوا إلى حرفة الأدب، لا يخلو منهم أي مشهد أدبي عربي، وبعضهم عدوانيون، وعلى استعداد للدخول مع غيرهم في عراك بالأيدي، وربما بالجنابي، وتجدهم ينحازون إلى صف كل سلطة مهما كانت قمعية، لذلك أشجع كل أديب على عدم الاهتمام بالتجمعات الأدبية، وأن يحمي نفسه من الحاجة للانتماء إلى عصابة أو مجموعة، ولا سيما التجمعات التي ترسخ بصورة منهجية ومشبوهة الفصل بين الأدب والفكر أو بين الأدب والموقف، ففي النهاية عندما يصبح الشاعر آلة كتابة دون أن يكون له موقف مما يجري حوله، هذا يجعلني أضع الكثير من علامات الاستفهام، ولا أهتم بالانتماء لمجموعات من هذا النوع، باستثناء العمل النقابي المبني على لوائح واضحة. وفي النهاية فإن الزمن سيحكم على التجارب مهما اجتهد أصحابها في التموضع داخل سياقات أو جماعات أو شلل أدبية.
"الشللية الثقافية" هذا المصطلح الذي أصبح الشغل الشاغل للأدباء وللنقاد، إذ يرى بعض النقاد اليمنيين أن "عهود الشلليات انتهت بمجيء الجيل التسعيني، وما بعده، الذي قاوم ما استطاع مفاهيم الشللية، والصنمية، ووثنية المركز، وأرسى مفاهيم تقوم على الانفتاح، والتجاور بالآخر، وتهوير المركزيات الشللية، وتثبيت مفهوم الإبداعية، مقابل الشللية الصنمية"، وينفي هذا الناقد نفيًا قاطعًا وجودها، رغم استفحالها يومًا بعد آخر، ألا ترى ذلك قفزًا عن الواقع؟
الشللية سمة ملازمة لكل العصور والمراحل الأدبية، وعندما تتطور وتمتلك رؤى وتوجهات جمالية ومفاهيم للكتابة، يكون ذلك أفضل، لأنها تتحول إلى جماعات أدبية منتجة وصانعة لتحولات داخل الكتابة، وما أكثر الجماعات الأدبية التي بدأت بالصداقة، ثم تطورت إلى فهم وإلى حماس مشترك لتصورات فكرية وجمالية مغايرة ومختلفة عن السائد، وهذا هو النوع المفضل بالنسبة لي، لكنه لا يوجد في اليمن، الموجود في اليمن هو الشللية التي تجمع أدباء لأسباب غير ثقافية.. قد تجمع البعض مخاوف أو رغبة في الاستئثار بأية مصالح كما يحدث في انتخابات اتحاد الأدباء في الظروف الطبيعية، وقد تجمع الشللية من توحدهم ميول سياسية قائمة على نفي السياسة والتطير منها، والقلق من المتسيسين الذين لهم آراء نقدية معلنة تجاه الواقع الحالي، وتجاه كل واقع مر من قبل، وكما تعلم فإن كل واقع عشناه في اليمن خلال العقود الفائتة، كانت له مراراته التي لا يمكن السكوت عليها أو تجاهلها، ومن أجل أن تحمي كل سلطة نفسها، تحرص على إشغال الجميع بالعداوات، وتخترق كافة النقابات والمهن.
فاحت سخرية في بداية التسعينيات من مصطلح "الشعراء التسعينيين"، هل ترى في ذلك أنه ضمن صراع شعراء تلك الفترة مع شعراء أجيال الحقب السابقة؟
لم تكن سخرية. كان امتعاضًا من حضور التسعينيين الكثيف على صفحات الجرائد والملاحق الثقافية.
ما هو مفهومك للنقد الأدبي؟ وهل تعتقد أنه وجد طريقه في بلادنا، أم أن "النقد الأدبي في اليمن متأخر عن الإبداع"، بتعبير ناقد أكاديمي؟ وكيف تفسر عدم تقبل أدباء يمنيين للنقد حتى وإن كان نقدًا بنّاءً؟
النقد البنّاء مفهوم ملتبس، ولا يوجد نقد بنّاء وآخر هدّام، المهم أن يكون النقد مكتوبًا لا محكيًا، وكل ناقد له تفضيلاته التي تجعله يطلب من النص الذي يقرأه أن يلبي ذائقته واشتراطاته الجمالية. لكنني مع الكتابة النقدية التي توثق وترصد وتحسب على صاحبها، ولست مع الانطباعات المحكية والنميمة والمشافهات التي تظهر الإعاقة في الوسط الأدبي.
وكلما كان النقد مكتوبًا مهما كانت مرجعيات الناقد، سنتجه إلى التعافي وإلى الحوار حول الجماليات والتنوع والثراء والاختلاف الذي لا بد منه كنتاج طبيعي لاختلافنا. وأيضًا لستُ مع النقد "الفيسبوكي" الذي يأتي على شكل أحكام وتعليقات قصيرة لا تختلف عن الثقافة الشفاهية التي تجاوزتها الكتابة.
لمن تقرأ من الشعراء والأدباء اليمنيين والعرب، والعالميين، عمومًا؟ ومن هو الأديب الذي تأثرت به؟
القراءات متنوعة وشاملة لا انحياز فيها إلا لكل ما هو جيد، ولستُ على يقين أنني وقعت تحت سلطة تأثير أديب أو كاتب بعينه. القراءات والسنوات التي تمضي بنا تجعلنا نتأثر بالحياة والكتب والتحولات الإنسانية كلها، وهذا الخليط بداخله أسماء وأحداث وكتب ومواقف وصدمات لها تأثيرها الذي يفوق أي اسم.
هل تعتقد أن ترجمة الأعمال الأدبية اليمنية إلى لغات أجنبية مسوغٌ لارتقائها سلم العالمية، وتستحق الاحتفاء بها إعلاميًا؟
بعض الترجمات تخدم الأديب، ولا سيما التي تكون ثمرة شهرة كتابه في طبعته العربية، وبعضها تتم لأغراض أكاديمية ومبادرات من دور نشر جامعية تابعة لأقسام تدريس اللغة العربية في بعض الجامعات الغربية. وبصورة عامة يحتاج تسويق الأدب العربي داخل اللغات والثقافات الأخرى إلى وكالات أدبية، وإلى تواصل مع دور النشر العالمية يجعلها تثق بالمنتج الإبداعي العربي، لأنها في النهاية تريد أن تضمن تسويقه وبيعه في أوساط القراء.
قلت في مقالة لك نشرتها قبل أكثر من عقدين: "لعل من المبكر جدًا تناول تجربة شعراء التسعينيات الذين يشكلون غابة كثيفة من الأسماء والتجارب المتفاوتة في عمقها ورؤاها وأشكال الكتابة الشعرية، وهذا التفاوت يصل لدرجة التناقض في الوعي وفي طموح الكتابة الشعرية، ثم إن تجربة التسعينيين ككل ماتزال في طور التبلور البطيء"، فهل تعتقد أنها لاتزال في ما ذهبت إليه، وقتذاك؟
كنت ومازلت أرى استحالة النظر إلى الجيل الأدبي (أي جيل وليس التسعينيين فقط) بوصفه كتلة واحدة، فمهما جمعتنا سنوات التسعينيات، إلا أن لنا آراء متعددة واختلافات في الذائقة والقراءات والمرجعيات، وهذا التعدد استمر في البروز، لكنه لم يجد البيئة والمناخ الثقافي والاجتماعي الذي يساعد على ازدهار التجارب، فحرم جيلنا من الإخلاص للكتابة والإبداع، إلا البعض، لكن تجاربهم ظهرت مرتبكة ووفية لأكثر من اتجاه وأكثر من زمن.
وكتبت ذاك بالفعل في سياق الدفاع عن جيل كان في بدايته، ورأيت أن من الظلم الحكم على منجزه أو تقييم أثره منذ البدايات الأولى، ولا سيما أنه حتى الآن خليط من الاتجاهات والأذواق التي تجمع ما بين المحافظ التقليدي والحداثي والشفاهي، واحتوى كذلك على من كان لديهم الوعي بتجاربهم إلى جوار من كانت لديهم رغبة أنانية وفضول، وربما تطفل على الكتابة، لمجرد أنهم يجيدون قواعد النحو والإملاء، وهناك فارق كبير بين النظم وإجادة شكليات الكتابة وتقليد نماذجها الجاهزة أو التأثر بالترجمات من جهة، وبين الإبداع والخلق والابتكار.
متى يمكن تقييم تجارب التسعينيين؟
لا ينبغي أن تحاكم التجارب الأدبية أو يتم تقييمها والنظر إلى منجزها وإلى ما حققته، إلا إذا اكتملت أو قطعت شوطًا كبيرًا في مراكمة إنتاج أدبي يشكل تيارًا أو تظهر له ملامح تميزه، ينجح في تحقيق الإضافة التي يمكن رصدها وملاحظة ما أحدثته من فارق مع ما قبلها من تجارب.
وأرى أن التجارب الجديرة بالتقييم والنظر إلى ما حققه منجزها الأدبي من فارق إبداعي وجمالي، هي فقط التجارب التي رحل أصحابها عن عالمنا، لأنها تكون تجارب منتهية، ولم يعد أصحابها قادرين على إضافة أي جديد، كما لم يعد أحد منهم معرضًا لسوء الخاتمة، سواء بإضافة عمل ركيك أو اتخاذ موقف سياسي بائس، أو تأليف كتاب يضم أفكارًا رجعية.
وبالنسبة لي فإن أولئك الذين يعلنون صراحة انحيازهم لجماعات دينية متطرفة أو طائفية، أو يتحولون إلى كلاب حراسة للدفاع عن توجه سلطوي، لا أثق بما يكتبونه، والبعض بحاجة لتوطين الحرية في داخله، وتنظيف مخيلته من آثار العبودية لسلطة الموروث أو سلطة الجمهور أو سلطة الأصدقاء أو سلطة الواقع السياسي، ويمكنه حينها أن ينجز أدبًا رفيعًا.
وماذا أنجز جيل التسعينيات حتى الآن؟
لايزال الوقت أمام العديد من الأسماء لتبدع، وبخاصة أننا لم نشهد فترة استقرار تساعد على تطور التجارب وإبراز ونشر الجديد، وأكبر فتوحاتنا كجيل تسعيني كانت في ارتياد بعضنا كتابة قصيدة النثر، فأحدثنا هزات صغيرة على مستوى المشهد المحلي، لكننا بالنسبة للمشهد الشعري العربي امتداد لحراك مبكر، ولسنا حتى مؤسسين لقصيدة النثر في اليمن، فقبلنا أسماء، وإن خلط أصحابها بين النص الجديد والنص التقليدي، إلا أن التجريب والخروج على الأنماط التقليدية بدأ قبلنا بعقود، أما عربيًا فالريادة -كما نعلم- كانت من نصيب أولئك الذين نشرت نصوصهم مجلة "شعر" اللبنانية التي أسسها يوسف الخال في بيروت عام 1957. وأرى أن نترك تقييم حصاد التسعينيين لأجيال قادمة، سترى من زمنها من ستبقى كتبهم تحظى باهتمام القارئ والراصد في المستقبل.
هل ترى في حصول أدباء في العالم العربي والخارجي على جوائز استحقاقًا وإنصافًا لأعمالهم الأدبية، أم أن هذه الجوائز مشبوهة سياسيًا كما يشاع؟
في هذا الزمن الذي يصعد فيه صناع الجهل على وسائل التواصل الاجتماعي، من الجيد أن هناك جوائز مخصصة للأدب، لكن على كل كاتب يحترم قيمة الثقافة أن يحذر من تفصيل الكتابة على مقاس الجوائز.
وإجمالًا، لكل فترة زمنية آلياتها لاستقطاب المبدعين، وفي السابق كانت المجلات والمؤسسات الثقافية والمهرجانات والوظائف ووزارات الثقافة هي أدوات إشغال المثقف بالجري وراء مكاسبها، واليوم أصبحت الجوائز هي البديل، ومع الوقت والاستمرارية ستتحول الجوائز إلى مؤسسات صانعة للذائقة وراسمة لخطوط الكتابة ومحاذيرها ومقاساتها، بل إنها قد بدأت بالفعل، لكننا لا نرى منها إلا الجانب الإيجابي، وهو مغرٍ وجيد بالنسبة للكاتب الذي يفوز، إذ يحصل على مكافأة إلى جانب ازدياد مساحة جمهور قراء أعماله، وأقصد بالتحديد الجوائز العربية ذائعة الصيت التي أصبح لها تأثير مشهود على استقطاب القراء، ودفعهم إلى البحث عن الكتب التي يفوز أصحابها بالجوائز، فتعمل ضمنيًا على إعادة بناء تفضيلات الجمهور، وتحفزهم على القراءة، ولو من باب التباهي بكونهم على اطلاع ومواكبة لكل عمل أدبي جديد. لكن من عيوب هذه الجوائز أنها جعلت القراء العرب يعتقدون أن الروايات هي الكتب الجديرة وحدها بالقراءة، على حساب مفهوم القراءة الشامل والمعني بمختلف أشكال المعرفة والعلم والأدب.
الاتحادات الأدبية بأشكالها القديمة فشلت وشاخت
باعتبارك عضوًا في اتحاد الأدباء اليمنيين والعرب، هل تعتقد أن هذين الكيانين أديا دورهما، أم وصلا إلى مرحلة الشيخوخة؟
الاتحادات الأدبية بأشكالها القديمة فشلت وشاخت، وأنا مع الاهتمام بإعادة بناء مفهوم وشكل جديد لها يقوم على اعتبارها نقابات، لتصبح مهمتها الدفاع عن حرية الكتابة والإبداع، وضمان حفظ كرامة أعضائها بتأسيس صناديق لدعمهم، والارتقاء بها إداريًا وهيكليًا لربطها بشبكات شاملة للتأمين تكفل حماية الأديب من الفقر والتشرد، وتتكفل بعلاجه، ولا تدعه ينتظر أن ترفع لأجله المناشدات. ولا نريد من اتحاد الأدباء أن يصدر مجلات أو يطبع الكتب أو ينظم مؤتمرات ومهرجانات وحفلات تأبين، لأن العمل النقابي أهم، ودائمًا ما أقول إن نقابات بعض المهن مثال جيد، وعلى الأدباء أن يقتدوا بها لتطوير كيانهم النقابي، وتحديد مهامه بوضوح، لأن التستر وراء الفعاليات الثقافية وإصدار البيانات غير المجدية، كان هروبًا من واجب الاتحاد، ومدخلًا من مداخل تكريس الجهل النقابي، ومن يرغب في أن يقود تنظيم المهرجانات والفعاليات الثقافية، عليه أن يطلق مؤسسة ثقافية خاصة.
لا توجد مؤسسات نشر في اليمن، ولم أسمع بها، إنما توجد مشاريع تجارية تستغل رغبة الأدباء في التخلص من النصوص والكتب المخطوطة، لأنها تفقد قيمتها في نفس الكاتب مع الوقت،
ما رأيك بدور مؤسسات النشر في اليمن؟ وماذا عن سلبياتها وإيجابياتها، برأيك؟ وهل هناك مؤسسة ترى فيها أملًا في احترام الأعمال الأدبية دون البحث عن المصالح المادية؟
لا توجد مؤسسات نشر في اليمن، ولم أسمع بها، إنما توجد مشاريع تجارية تستغل رغبة الأدباء في التخلص من النصوص والكتب المخطوطة، لأنها تفقد قيمتها في نفس الكاتب مع الوقت، وتبعث رؤيتها مخطوطة على الإحباط، لذلك وجدت بعض المشاريع التي تستثمر هذا الوجع أو النقص في غياب النشر المؤسسي. وأرى أن النشر الاحترافي لا يفترض أن يتقاضى مبالغ من المؤلف مقابل طباعة كتابه، أما ما يحدث الآن فهو أن من يسمى الناشر يتحول إلى وسيط بين صاحب الكتاب وبين المطبعة، ومقابل هذه الوساطة يحصل على مبلغ، ويوهم المؤلف أنه نشر كتابه.
يثني الكثير من الكتاب والأدباء عليك على ما قدمته خلال مسيرتك الأدبية، "بأن تعمل بصمت ولا تبحث عن الأضواء"، فلماذا تمتعض من وصفك بالشاعر الكبير.. لطالما وهي للتبجيل والإعلاء من شأن الشخص احترامًا وتقديرًا؟
لستُ متواضعًا عندما أتحفظ على وصفي بالشاعر الكبير، لكني أرى أن هذا توصيف اجتماعي أكبر مني، ولا محل له في النقد، وبالمعنى المتداول والشائع لهذا التوصيف لست شاعرًا كبيرًا ولا صاحب مسيرة أدبية مكتملة، وإن كنت أشعر بالامتنان لكل من يحمل تجاهي نوايا طيبة ويحترمني، لكني لم أتمكن من عمل ما يستحق لنفسي ولغيري في المشهد الثقافي اليمني.
يقول العقاد إن "الشاعر من يشعر فيشعر"، فبماذا تشعر وأنت تكتب قصيدة ما؟
القصيدة الحديثة أصبحت مقترنة بفعل الكتابة، وما يسعى الشاعر إلى تلبيته في الكتابة الشعرية الحديثة، يحتم عليه أحيانًا أن يخلق مسافات شعورية بينه وبين النص، بحيث لا يستسلم لغنائية أو تلقائية من النوع الذي يقتل النص أو يجعله انفعالات طربية تلبي غريزة تشبه غريزة الشاعر الجاهلي في البوح.
وبالنسبة لي أشعر عندما أكتب أنني معني بالاختلاف عن قصائدي وعن قصائد وهواجس غيري، ولا سيما أولئك الذين كلما عثروا على طريقة أو أسلوب في التداعي والتفكير الشعري، تمسكوا بها واستنسخوها في كل أعمالهم، وتوهموا أنها ناقلة للمعرفة، وحين تفتش في نصوصهم تكتشف أنها معرفة سطحية مفتعلة يثقلون بها كاهل النص في محاولة لاستعارة نوع من العمق المصطنع، وهؤلاء يكتبون قصيدة واحدة يعيدون إنتاجها من زوايا مختلفة.
أبرز الصعوبات التي واجهتها في الكتابة؟
الصعوبة الكبرى عدم التفرغ وعدم الاستقرار، وأنا شخص يحب مبدأ الاستقرار في مسكن به مكتبة وموسيقى، ويجد بعد العتبة في الخارج المجتمع الذي ألفه وأحب لهجاته وتكون في عالمه.
برأيك أما آن الأوان لإطلاق صرخة مدوية بصوت جماعي للأدباء والأحرار رفضًا لنزيف الدم في اليمن؟
من الناحية الأخلاقية علينا أن نكون ضد الحرب وضد نزيف الدم، ومن الناحية السياسية يجب الحذر من أي سلام ملغوم يكون الهدف منه تثبيت الضياع الشامل والانقسامات، وتأجيل استعادة أو بناء دولة لكل المواطنين.