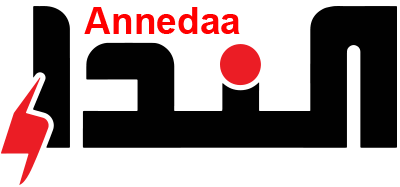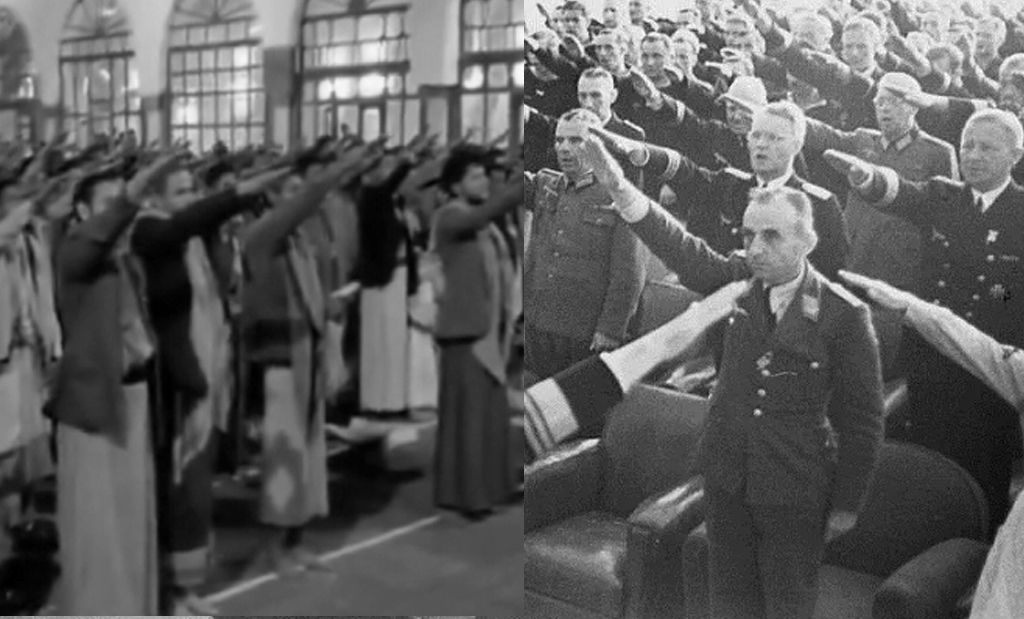جبل بعدان، الحاجب للأرض المسماة "ريمان", المطل على مدينة إب من الشرق حيث تستمد منه ظلها عند ساعات الصباح، ودفئها كلما أحنى هامته للشمس كي ترسل خيوط أشعتها إلى أزقة المدينة وشوارعها، وإلى ما هو أبعد منها.
 حكاية هذا الجبل حكاية مشروع اختمرته الذاكرة عند الصغر عندما كنت حينها غير قادر على بلورته وإسقاطه على الطبيعة رغم اعتقادي ببساطته كون قياساتي كانت مبنية على رؤية ذاك الجبل الشامخ من على سطح منزلي عوضاً عن متابعتي شبه اليومية لأناس يهبطون من على قمته يومياً وقبل طلوع الشمس لا يحملون ساعتها غير متطلبات العمل الذي سيؤدونه في المدينة الذي كان في غالبه فلاحة الأرض والاعتناء بها مع حرصهم الشديد على حمل فطائرهم التي يعدونها لوجبتين بحيث لا يستقطعون من أجرهم اليومي غير ثمن القهوة التي يغمسون فيها تلك الفطائر لتليينها بحيث يسهل تناولها ومن ثم هضمها. عودة هؤلاء بعد عصر كل يوم إلى قراهم الواقعة خلف القمة ولمسافات أبعد منها بكثير كانت لها رؤية مغايرة، إذ كانوا يحملون في طريق عودتهم كل ما يقدرون على حمله من احتياجاتهم غير المتوفرة في قراهم لدرجة أن البعض كان يحمل على ظهره قصب الذرة التي تشكل غذاء أساسيا للأبقار بحيث يتراءى لمن يتابع صعود تلك الأحمال عن بعد أنها تتحرك لذاتها، كون أحجامها من الطول والعرض ما يجعلها كفيلة بإخفاء من يحملها. الأمر الذي كان يحيرني كثيراً بين التصديق أن إنساناً له القدرة على حمل ذلك والصعود به إلى قمة ذاك الجبل أو أن تلك الأحمال تصعد تلقائياً. كما أن لصعود البعض ممن يتأخرون في المدينة فيضطرون للسفر بعد غروب الشمس. قصة أخرى هي أشبه بقصص أدغال الأمازون المرعبة، إذ شكلت لي ولمن هم في سني آنذاك قلقاً ورعباً شديدين عندما كنا نلتم حول أحد القادمين من الجبل إلى السوق التجاري الوحيد في المدينة ليقص علينا كيف تمكن ليلاً من النجاة من الطاهش الذي اعترض طريقه وكيف لجأ إلى الصخور وأوقد النار لإخافته. ما رسخ في عقولنا جدية هذا الكلام ورسم في ذاكرة كل منا شكل الوحش وحجمه بل وتصور المكان المتواجد فيه، أن آباءنا كانوا كثيري التعاطي في هذا الشأن. في فترة من الفترات، وبعد أن تقلصت الحركة في هذا الجبل نتيجة التحول إلى وسائل النقل الحديثة ظلت الحركة اليومية للهبوط والصعود في ذاكرتي. تراودني فكرة القيام برحلة مكوكية إلى القمة للوقوف عن كثب على حقيقة الجهد الذي كان يبذل من خلال مطابقة ما تختزنه ذاكرتي مع الطبيعة التي لا تبعد كثيراً عن موقعي وكذا توقع الأماكن التي كانت تتواجد عندها الوحوش لملاقاة كل من كان يتخلف عن سربه.
حكاية هذا الجبل حكاية مشروع اختمرته الذاكرة عند الصغر عندما كنت حينها غير قادر على بلورته وإسقاطه على الطبيعة رغم اعتقادي ببساطته كون قياساتي كانت مبنية على رؤية ذاك الجبل الشامخ من على سطح منزلي عوضاً عن متابعتي شبه اليومية لأناس يهبطون من على قمته يومياً وقبل طلوع الشمس لا يحملون ساعتها غير متطلبات العمل الذي سيؤدونه في المدينة الذي كان في غالبه فلاحة الأرض والاعتناء بها مع حرصهم الشديد على حمل فطائرهم التي يعدونها لوجبتين بحيث لا يستقطعون من أجرهم اليومي غير ثمن القهوة التي يغمسون فيها تلك الفطائر لتليينها بحيث يسهل تناولها ومن ثم هضمها. عودة هؤلاء بعد عصر كل يوم إلى قراهم الواقعة خلف القمة ولمسافات أبعد منها بكثير كانت لها رؤية مغايرة، إذ كانوا يحملون في طريق عودتهم كل ما يقدرون على حمله من احتياجاتهم غير المتوفرة في قراهم لدرجة أن البعض كان يحمل على ظهره قصب الذرة التي تشكل غذاء أساسيا للأبقار بحيث يتراءى لمن يتابع صعود تلك الأحمال عن بعد أنها تتحرك لذاتها، كون أحجامها من الطول والعرض ما يجعلها كفيلة بإخفاء من يحملها. الأمر الذي كان يحيرني كثيراً بين التصديق أن إنساناً له القدرة على حمل ذلك والصعود به إلى قمة ذاك الجبل أو أن تلك الأحمال تصعد تلقائياً. كما أن لصعود البعض ممن يتأخرون في المدينة فيضطرون للسفر بعد غروب الشمس. قصة أخرى هي أشبه بقصص أدغال الأمازون المرعبة، إذ شكلت لي ولمن هم في سني آنذاك قلقاً ورعباً شديدين عندما كنا نلتم حول أحد القادمين من الجبل إلى السوق التجاري الوحيد في المدينة ليقص علينا كيف تمكن ليلاً من النجاة من الطاهش الذي اعترض طريقه وكيف لجأ إلى الصخور وأوقد النار لإخافته. ما رسخ في عقولنا جدية هذا الكلام ورسم في ذاكرة كل منا شكل الوحش وحجمه بل وتصور المكان المتواجد فيه، أن آباءنا كانوا كثيري التعاطي في هذا الشأن. في فترة من الفترات، وبعد أن تقلصت الحركة في هذا الجبل نتيجة التحول إلى وسائل النقل الحديثة ظلت الحركة اليومية للهبوط والصعود في ذاكرتي. تراودني فكرة القيام برحلة مكوكية إلى القمة للوقوف عن كثب على حقيقة الجهد الذي كان يبذل من خلال مطابقة ما تختزنه ذاكرتي مع الطبيعة التي لا تبعد كثيراً عن موقعي وكذا توقع الأماكن التي كانت تتواجد عندها الوحوش لملاقاة كل من كان يتخلف عن سربه. في الأيام الأولى من خريف هذا العام 2007 وعند الساعات الأولى من صبيحة ذات يوم قررت الصعود. ما كنت أحسبه سهلاً عند نقطة كانت محددة في ذاكرتي سلفاً، ربما تقدر بثلث المسافة، وجدته أمراً شاقاً اضطرني للتوقف والاستدارة نحو المدينة بغية أخذ شهيق متتابع مستغلاً سكون المدينة وسبات أهلها، إذ لم تكن الشمس حينها قد لا مست أسطح المنازل أو حتى قمم المآذن المتعددة. لم يدم تأملي كثيراً، إذ كنت مجبراً على الاستدارة مرة أخرى نحو الجبل للتحقق من وقع أقدام تحث الخطى نحو هدف يبدو أنه في غاية الأهمية. عشرات ممن هم في مقتبل العمر يرتدون قمصان بلون السماء بعد أن تكون قد فرغت من الاستحمام في فصل الصيف. مواقعهم غير متقاربة تعكس المسافات المتباينة لقراهم المتناثرة شرق هذا الجبل. رغم أني كنت على يقين من وجهتهم من خلال تجانس زيهم ومطابقته لزي أحد أبنائي إلا أني أثرت السؤال كون تخميني لا ينسجم مع المسافة التي يقطعونها ولا مع التحولات على الأرض سواءً من خلال قياس المسافة الزمنية التي قطعتها الثورة، أم المسافة التي قطعها الإنسان بشكل عام منذ الثورة الصناعية في أوروبا وحتى عامنا السابع هذا من القرن الواحد والعشرين. تمنيت أني لم أقابلهم عندما أجابوني بأن وجهتهم مدرسة النهضة الثانوية بمدينة إب. أكثر من خمسين طالباً يصلون الفجر في قراهم التي تبعد حوالي ساعتين عن هذه المدرسة ثم يبدؤون رحلة الشقاء والعذاب اليومية وأفظع من ذلك عودتهم ظهراً عبر الجبل ذاته ولكن صعوداً, كون ظروف أسرهم المادية تقضي باستمرار معاناتهم. شيء فظيع ومحبط في آن واحد أن تعجز الدولة عن بناء مدرسة ثانوية في عزلة "الموية" لتجمع سكاني يظم أكثر من اثنتي عشرة قرية مكتظة بالسكان في حين أن باستطاعة أحد المسؤولين وبدرجة مدير عام فقط أن يتكفل ببناء ذلك مع صيانتها فضلاً عن تقديمه وجبات إفطار لهؤلاء البائسين، إذ وصلت أرصدة هؤلاء الصغار فقط والتي يكدسونها في البنوك أو على شكل أراض وعقارات إلى مئات الملايين. ولا أبالغ إن جزمت بأن بعض هذا البعض يتعدى هذه الأرقام ومنذ سنوات، إذ تحولت المكاتب التي يديرونها من عشرات السنين إلى مزارع خاصة تدر عليهم دخلاً بواسطة العديد من السماسرة واللصوص. لقد تعثرت قدماي في هذا المكان فبقيت أرقبهم بقلب منهك وعينين تكاد تنفجر دماً لا دموع. لقد أغرى هذا المشهد جاذبية الأرض في أن تمسك بقدميّ كلما حاولت الصعود. لم تنقطع عن سمعي وقع حوافرهم ولا ترانيم أصواتهم، إذ بقيت طول الوقت أخمن المكان الذي وصلوا إليه بينما توقعي لآخر من التقيته كون قريته هي الأبعد أن يصل عند الحصة الثانية إذا أسرع الخطى. واصلت صعودي حتى ثلثي المسافة عندها توقفت تلقائياً كون هذا المكان محطة استراحة للإنسان والحيوان على السواء منذ القدم، إذ يوجد فيه إسطبل يقال إن العديد من المسافرين كانوا يلجأون إليه كلما أظلم الليل أو انقطعت بهم السبل نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول على الطريق الوحيد المؤدي بهم إلى قراهم. عند هذا المكان عادت بي الذاكرة إلى قصص الوحوش وأشكالها ومخابئها كون المكان كثير الصخور كثيف العشب الجبلي فضلاً عن حوض الماء الذي أعد أساساً ليشرب منه الحيوان. اقتربت من باب الإسطبل وجدته مشرعاً على الطبيعة أي لا يوجد حاجز يمنع الدخول أو الخروج منه ويقال أنه هكذا منذ تم بناؤه. الأمر الذي زاد من تعلقي بقصص الماضي، إذ كيف لأناس أن يلجؤوا إلى هذا المكان وينامون فيه بينما لا يتوفر حاجز يمنع وحشاً أو معتوهاً من الولوج إليه. هالني منظره من الداخل فتسمرت عند مدخله، إذ وجدت أن لا فرق بين أن يأوي المرء إلى حضن هذا المكان أو إلى حضن طاهش! سواد حالك وعتمة ليل ممطر وركام صدأ يخفي وراء أضلعه أسرار أجيال تعاقبت على هذا المكان. على مقربة من هذا الإسطبل وعلى بعد تصاعدي، ثلاثين متر تقريباً، توجد سقاية كان الماء يردح فيها على مدار الساعة وجدتها فارغة كما هو حوض الماء اللصيق بها المخصص لورود الحيوان.
يقال إن مجرى الماء هذا قد ردم بفعل الطبيعة وتحول إلى مكان آخر وأن الأهالي بصدد مراجعة المجلس المحلي كي يعمل على إعادة المياه إلى مجاريها. خاصة وأن العديد من ساكني القرى قد عاد بهم الحنين إلى طريق آبائهم وأجدادهم كلما طال بهم الانتظار لوسيلة نقل وكلما فرغت جيوبهم من الأوراق النقدية. ناهيك عن خمسين طالباً وربما أكثر يمرون يومياً ويدلون برؤوسهم وأيديهم نحو القاع علهم يجدون ماءً يخفف من عنائهم عند الهبوط وعند الصعود.
واصلت المسير حتى قمة الجبل في مكان يسمى "الشماحي". استهوتني نسائم هذا المكان فمكثت فيه لبعض الوقت. أدقق النظر في المدينة القديمة باحثاً عن بيتي القديم في قلب هضبة تكتظ بركام الأحجار، إذ من العبث أن تحدد مكاناً بذاته من هذا البعد وهذا الارتفاع باستثناء المآذن. كون المدينة مجرد صخرة هائلة حجمها يغطي مساحة الهضبة الجاثمة عليها، بحيث تبدو المنازل كمنحوتات صخرية متداخلة ومتجانسة بحيث يصعب تمييزها. ما وراء هذه الصخرة المنحوتة وفي اتجاه الغرب يقع "وادي الظهار" الذي تحول إلى كتل خرسانية، إذ لا تجد فيه حديقة أو متنزه بعد أن كان مصدر إلهام الشعراء والأدباء والكتاب ومصدر غذاء أهل المدينة وغيرهم. لا شيء يمكن التقاطه وتحديده من هذا المكان غير مبنيين هما من المساحة وحجم البناء ما يميزهما عن بقية الأحجار وأطنان الحديد. الاستاد الرياضي وهذا لا تعليق عليه، وسكن المحافظ الذي يطلق عليه البعض "قصر هارون الرشيد"، مع تحفظي على هذه التسمية التي لا تنسجم والمهام التي أنيطت بقصر الرشيد قبل أكثر من ألف عام، إذ لم يكن قصر الخلافة آنذاك مكان للراحة أو النوم كما يعتقد البعض بل ضابط إيقاع لدولة تمتد مساحتها واحتياجاتها وهمومها من جبال خراسان شرقاً حتى جبل طارق غرباً. من موقعي هذا الذي يطل على أكثر من لوحة جمالية: من الشمال وادي السحول ومن الجنوب وادي ميتم ومن الغرب مدينة إب التي فارقتها منذ ساعات فقط نحو أفق أرحب وهواء أنقى وأناس لا يقرؤون هذا الكون إلا من خلال صفحات حقولهم. سماؤهم هي سماء الصيف الذي يغدق عليهم بالخير ونجومهم هي نجوم أيلول التي تسامرهم في مروجهم ومدرجاتهم وعلى سطوح منازلهم وحتى في ترعهم وبركات مساجدهم كلما قدمت للاستحمام قبيل أذان الفجر. إنهم أهل "ريمان"، قاطنو الأرض التي لا تبعد عن بصري غير استدارة نحو الشرق. إنها آية من آيات الإبداع الإلهي. قراها المتناثرة في الآكام والروابي والمدرجات حفنات من اللؤلؤ تحيط بها سنابل القمح التي دني حصادها، توقفت مشدوهاً عند ما شعرت بنسائم الخريف وهي تداعب وجنات السنابل فتزيد الأخرى من دلالها وكثرة تمايلها كلما اندفع ذلك النسيم نحوها. كانت الشمس هي الأخرى ترقب شيطنة النسيم من على قمة حصن حب. فما إن بدا لها حقيقة ما يجري في تلك الحقول حتى أسرعت الخطى في محاولة إيقاظ أهل القرى من خلال ضوئها ودفئها بغية وشايتهم بلعبة الصباح اليومية وغير العفوية التي يمارسها نسيم الخريف الدخيل على الحقل. لم تحتمل الشمس تباطؤ السكان فانقضت على تلك الحقول لتحكم سيطرتها على مساحة كل تلك الأرض بقراها وحقولها، بينما انسل النسيم نحو المرتفعات. عندها توقف رقص السنابل فبدت الحشمة والتعفف عليها الأمر الذي زادها جمالاً وألقاً وأضفى على الوادي ألواناً متداخلة لا يستطيع المرء تحديدها كونها مزيجا من ضوء الشمس وبريق الذهب على جبين السنابل. مغادرة هذا المكان نزولاً في اتجاه الوادي لا تأخذ وقتاً طويلاً، إذ يمكن للمرء مباشرة التنقل في جنبات الحقول والتمتع بمناظرها عن قرب بل وملامسة السنابل التي كانت حكراً على النسيم. ومداعبة مختلف المحاصيل وسماع خرير المياه التي تتساقط من أعين الصخور والإنصات لحفيف أوراق الأشجار وترتيل الطيور وسريان الماء في الغدير. مساحة لا بأس بها من حقول القمح كان قد تم حصادها وتم نقلها إلى ميدان واسع يسمى "المجران". أرض مفروشة بالعشب أعدتها الطبيعة لمواسم الحصاد بينما مساحات أخرى تجد السنابل فيها ما زالت واقفة تؤدي طقوسها كعادتها غير آبهة بالمصير المحتوم. "المجارين" في هذه المنطقة متعددة لكنها مختلفة من حيث المساحة، إذ أكبرها "مجران حصن خشافة" المليء بأكوام السنابل في انتظار الدور نظراً لوجود حصّادة واحدة فقط تعمل في هذا المكان. لا أدري إن كانت الدولة من خلال وزارة الزراعة لديها أي معلومة عن هذه المنطقة ومناطق أخرى لا تبعد عنها كثيراً كالحرث، و"المنار" و"الحيث" و"سي"ر و"المقاطن" و"الموية" و"بيت الدعيس"... جميعها مهتمة بزراعة هذا المحصول، من حيث مساحة الأرض المزروعة والكميات المنتجة سنوياً ونوعية المنتج وتكلفة الطن مقارنة بالمستورد. ناهيك عن مسؤوليتها في تشجيع المزارعين سواء بتقديم الإرشادات وتوفير مضخات المياه وتقديم أكثر من حصادة لتعمل مجاناً خلال هذا الموسم. كما هي الأرض في هذه العزلة المسماة "ريمان" دائمة الجود والعطاء، نجد الإنسان ندا لها فبقدر ما تعطيه من خيرات نجده يرويها بعرقه ويسهر عليها ليله ويقضي معظم وقته في خدمتها. عظمة هذا الإنسان تكمن في عدم تلويثه لأرضه وأرض آبائه وأجداده بأي نوع من أنواع السموم. بينما وعيه يتجلى في مقته ومعاداته لشجرة القات، أكان مضغاً أم زراعة؛ إذ لا توجد أرض في هذه المنطقة حتى لو قيست بالأمتار مزروعة بهذه الآفة الخطيرة والقاتلة. لا أخال العاشق للطبيعة وسحرها إلا أن يكون قد أناخ رحله في هذا المكان بغية استيطان هذه الأرض بمجر اكتشافه لروعتها وسكونها بعد مشقة سفر وعناء بحث. في هذه الأرض يأبى العشب إلا أن يظل مخضراً حتى لو كان في قلب الصخر متمرداً على قوانين الطبيعة المنظمة لاختصاصات الفصول مستأنساً باخضرار أشجار الظل الكثيفة المنتشرة في كل مكان من الوادي. فالخريف هنا لا يسلب الأشجار اخضرارها ولا الحقل شذاه ولا الغدير مياهه ولا الماء خريره.
كم تمنيت أن يقف بي الزمان هنا طويلاً! فللصمت في هذا المكان معنى وللوقوف عند السواقي أكثر من ذكرى. لقد اختزل كل ما هو جميل في عالمنا في هذا المكان الذي عشقته وودت البقاء فيه. فكلما حاولت استحضار القرى التي مررت بها تحضرني في مقدمتها قريتا "المحيدثة" و"الدير القمر"، مسقطا رأسي الشاعر والفيلسوف إيليا أبو ماضي، وعاشقة القمر السيدة فيروز، إذ لا يمكن لجمال هذه الطبيعة أن يكون على هذا النحو ما لم يكن قد ولد من رحمها توأما العشق والحب والجمال، أو تعاقبا على زيارتها لمناجاتها عند بزوغ كل فجر وعند ساعات الأصيل. لا أحسب الجمال في جبل لبنان وعلى امتداد الجنوب إلا قد انشق يوماً عن الطبيعة في "ريمان" ولم لا وأهل جنوب لبنان على امتداد جبل عامل يفخرون كما هو نبيه بري بأنهم من أصول يمنية دون الإفصاح عن موقعهم الجغرافي بدقة الذي لا أشك لحظة بأنه "ريمان".