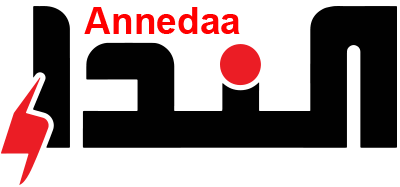استهلال:
16-19 نوفمبر 2009، كنا على موعد مع تظاهرة احتفالية بيوم التسامح العالمي "التسامح إذ يتحدد بالآخر المختلف"، استمرت ثلاثة أيام ما بين يوم الافتتاح، والمعرض الفوتوغرافي، ويوم الأبحاث والدراسات والنقاش، ثم الاختتام بحفلة فنية" نغني، نرقص لنحيا".

واليوم إذ أحدق في الصور وأستجر الذكريات، للمشاركين في التظاهرة:
اقتلع إخوتنا اليهود عن بكرة أبيهم من موطنهم الأصلي في صعدة وعمران وثلا، ثم صنعاء، وتشتتوا في منافي الأرض، وبالمثل كان مصير إخوتنا البهائيين الذين عانوا من الملاحقات والسجون والتهديد بالإعدام، واقتلعوا تشريدًا بالمثل، وبعضهم مازال يقبع في السجون حتى اليوم، وفي ما خص النخبة اليمنية التي شاركت في الفعالية، فجلهم قضوا نحبهم، أو تشردوا في داخل البلاد والمنافي، وبعضهم تعرض للتكفير والتخوين والسجن، عليهم الرحمة والسلام.

الخلاصة:
إن اليمن، التي كانت موجودة "الجمهورية اليمنية"، تقوضت هي الأخرى، نعم لم تعد قائمة، لقد كنا حينها نتطلع إلى يمن تسود فيها قيم التسامح والتعايش والسلام، يمن المدنية والمواطنة، بعيدًا عن التمييز في الجنس واللون، والدين والمعتقد، والهويات، يمن التعليم الحر، التثاقف مع الشعوب المختلفة... الخ، وإذ بنا اليوم، 16 نوفمبر 2024، بلا يمن، فقد تمزقت البلاد بميسم الحروب الطائفية والدينية وتصفيات الحسابات الإقليمية داخل مساحة يمن الحروب والمجاعات واللاتعليم واللاكهرباء، يمن السجون والنساء المصفدات بالعيب والحرام، يمن المليشيات والهويات المتقاتلة على العدم.
ومازال يحدونا الأمل اليوم، 16 نوفمبر 2024، في استعادة الحق في الوجود بوطن آمن، وبمواطنة كريمة، يمن التسامح، لا نملك سوى الحق في الحلم.

**
في ما يلي، نص كلمة افتتاح تظاهرة التسامح إذ يتحدد بالآخر المختلف.
لماذا يجب أن تُسلم حمامة أو يتيهود أحمد؟!
أروى عثمان
بكل بساطة: السؤال الذي نريد أن نبحثه، وبالأحرى: لماذا يحدث هكذا؟! لماذا تلتهمنا دائرة العنف والكراهية، وتفتك بأصدقائنا وأطفالنا؟ لماذا تتنامى دائرةُ العنفِ باسم المقدس، تستشري في شارعنا، وتستعر في مدرستنا، في غرف نومنا، في أرديتنا، وألحفة البرد، وملايات الصيف؟ لماذا لم نعد نحدق في شروق الشمس ومغيبها، وإطلالة القمر، ومد البحر وجزره، وتنشق عبق الريحان، وترنم ذلك العصفور الذي نوصد نوافذنا في حضرته؟
**
وبالمناسبة، أيضًا: قبل عقدين من الزمن كنت محمومة بزيارات المناطق اليمنية، وفي أثناء عملي كمدرسة، رأيت لغة واحدة: "نحن الحقيقة"، نحن من يمتلكها فقط، نحن خير أمة، وعدانا أشرار، نحن الملائكة، وهم الشيطان. الكثير من تقديس الأنا وتضخمها المريض الواهم والواهن في مقابل الأنوات الأخرى المدنسة..
لقد رأيت ولمست التعابيرَ المشحونةَ بالكراهية لكل ما يخالف ويختلف عنا في المدرسة، وأنا أدرس مواد الفلسفة المضادة والمتعارضة لقوانين الفكر الأساسية. وفي الشارع ولغته التي لا تختلف عن مرافق الحياة الأخرى، نتحدث عن التسامح في الشارع ونحن نكرع إلى جوفه كل أدوات القتل والكراهية. نتحدث عن التسامح في الإعلام، ونرى سيلانات الدم والعداء والبغض، وكذلك الحال في الجامعة والمعاهد والمراكز، وكثير من مرافق الحياة، لغة التسامح منعدمة، والمحزن أن ما يكرعه المسجد، يدفع كل أطياف المجتمع نحو الهاوية.

وأيضًا من نحسبه متسامحًا نجده يحصر معنى التسامح في ثنائيتين كلتاهما قاتلتان: إما/ أو، فلغة التسامح لا تحتمل التشويش والضبابية والانتقائية، أن نكون إنسانيين أو لا..
ولذا، صرنا نلهج بالتسامح ونعمل بنقيضه، وهذا ما لمساناه في معارض الكتاب، ولسنوات طويلة، فما يقذف في زواياه وواجهاته بأسعار مخفضة، ليست كتبًا، بل قنابل وأحزمة ناسفة، فكل طفل يشتري ما يسمى كتابًا، هو يشتري قنبلة لا تنفجر فقط عليه، بل وعلى الآخرين وأولهم أفراد أسرته..
رأينا بغضب وقهر كيف تتوارى 5 دور نشر للتفكير الحر والعقلانية والفلسفة والأدب والفن، إلى الخلف، وتترأس كتب الكراهية والتعصب والفكر المتشدد الواجهات. فأيّ تسامحٍ وتعايشٍ وسلامٍ نتحدثُ عنه ونحن نرى ونشاهد مفاصل حياتنا تتدمر، ويسلب منا حياتنا وأمننا وأماننا! وكيف سيكبر أطفالنا، والعدائية والتشدد والكراهية تلاحقهم بهستيريا مسعورة في حركتهم ونبضهم؟!
**
عندما كانت تحكي لنا جدتنا، كنا في كل مرة، نضجر من حديثها وحكاياتها المتكررة عن صديقتها وصديقة نسوة القرية، تلك المرأة اليهودية التي كانت المطببة والمولدة لنساء القرية، وكيف كن يتبادلن همومهن اليومية على كوب قهوة القشر في حقول القرية وعند عتبات البيوت.
تحكي لنا كيف كان البساط أخضر، ولغة الطيور والشمس مفتوحة على همسهما وضحكاتهما وأنينهما.
فلماذا يجب أن تسلم "حمامة" أو يتهود "أحمد" أو العكس؟! والإجابة لماذا لا تكون المحبة هي الملغية لـ"إما/ أو!
**
وسأحكي (ما حدث معي) عندما ذهبت بمشروعي لإقامة هذه الفعالية، قبل 5 أشهر، إلى جهات رسمية وأسماء لامعة لها علاقة بالشأن الثقافي، لدعم فكرة التسامح، وسمعت كلامًا معسولًا من كافة الذين التقيتهم، وهو كلام يزجك في قمقم لن تخرج منه إلا إلى بحر من الإحباط.
وقصدت إرسال مشروعنا إلى جهتين أجنبيتين، ولعل الوقت لم يكن بكافٍ، فالأمل كان معقودًا على الطرف اليمني، فضاع دعم المشروع في اللاءات والانتظارات، وسراب الأمل.
وفي اعتمال الخيبات، تحدثت للباحثين والمهتمين بشفافية.. هل أنتم مستعدون لأن نشتغل بالكفاف.. وكان الرد: سنكتب، ونعمل، ولا نريد فلسًا واحدًا. والدليل على ذلك هذه الوجوه السموحة التي أتت لكي تفتح النوافذ الموصدة ليدخل هواء الكتابة المنعش المتجدد: لنحيا.
**
في فعالية التسامح، لا ننشد مدينةً مثاليةً ويوتوبيا أفلاطون والفارابي وجون لوك، نحلمُ وندافع ألا يبقى صوت الحياة صوتًا واحدًا، ولا لونًا واحدًا، ولا شكلًا واحدًا جامدًا، فالكون يتسع لجميع الألوان.

في هذه الفعالية، وفي هذا اليوم 16 نوفمبر (العيد العالمي للتسامح)، نطلب أن يتأنسن كل ما ومن حولنا: الطبيعة، أنسنة التعليم، والأستذة، أن يرد الاعتبار لساحة العلم والمعرفة مفصولةً عن أيديولوجيات القيامة وحشر الآخرة في دروس الفلسفة والفيزياء والرياضيات.. أنسنة المسجد بالدين لله والوطن للجميع أيًا كانوا..
أنسنة الشارع والحافلة والمطعم والرصيف، بزرع الأخضر، وقبله بزرعه في أرواحنا.
إشاعة "ثقافة التنوع والأنسنة"، رد الاعتبار للفن والفنانين الذين يموتون مرضًا وقهرًا في أروقة المستشفيات كالكلاب الضالة، ولعل آخرهم "هاشم علي"، وقبلهم قوافل من المنسيين الذين نشروا الحب والمحبة في أرواحنا وكل من حولنا: منى علي، محمد سعد عبدالله، محمد عبده زيدي، ولا ننسى في هذا اليوم أن نحيّي الفنان أيوب طارش، الذي يصارع المرض، بدفتر تبرعات من محبيه، ومؤسسات الدولة تغرق في العدم، ولجمال داؤود، والكثير الكثير نحييهم في هذا اليوم، ونطالب اليوم وغدًا برد الاعتبار للرقص والمسرح والغناء، للسينما، للمبلس الملون في كل المدن: صنعاء، عدن، يريم، عدن، صعدة، لكل اليمن ريفًا وحضرًا.
أخيرًا:
في هذا اليوم.. أحيي الوجه الآخر من وجوه التسامح: المرأة، رمز الخصوبة، الأخضر.. الوجهَ المعانق للشمس ودورة القمر.. ونقول: أما آن الأوان لرد الاعتبار لوجهها وجسدها.. رد الاعتبار لألوان الطبيعة في ملبسها، فلا تحتمل النساء مزيدًا من العورات التي تلاحقها في حياتها ومماتها.

16/11/2009