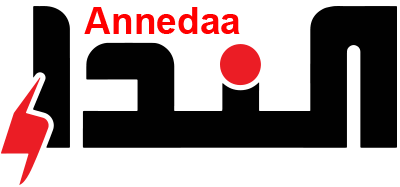أكتب هذه "الدردشة" شبه (الناعِمَة) وأنا مُتواجِد بمسقط رأسي، والتي أذهبُ إليها من مدينة تعز بين آنٍ وآخر، لزيارة الأرحام، ولِمُفَاقَدة مكتبتي الخاصة، التي كان الفضل بعد الله، لأحد سَائقي (القرية) الذي ظل يَنقُلها بِشِنَط، على دُفُعات من عاصمتنا الحبيبة (المحتلة) حَاليًا! صنعاء إلى منزلي بالريف، وهي التي سَلِمَت من "تَتَار العصر!".
ولعدم وُجُود مُتَّسع لِلكُتب بمنزلي المتواضِع بمدينة تعز، أصطحِب بعض الكتب التي أحتاج لها، ثم، في زيارة أخرى، أرجِع تلك الكُتب وأصطحب أخرى..! وهكذا دواليك.
ثم، أزور القرية (مسقط الرأس) أحيانًا، لهدف أخذ فترة نقاهة، والهروب من صَخَب وزِحَام المدينة ولو مُؤقتًا، متذكرًا هنا قول إيليا أبي ماضي من قصيدة له:
"خُذ الخُلُقَ الرفيعَ مِن الصحارى
فإن النفس يُفسدُها الزحامُ"
مع الفارق، وهو أن عُزلتي أو قريتي ليست صحراء، بل هي واحة خضراء، حَبَاها الله بطبيعة خَلَّابة، وبمياه، وأودية، ومدرجات، وطبيعة مُدهِشَة، حِسًّا وَمَعنى، خصوصًا خلال هذه الأيام.
ولولا بعض الالتزامات غير الرسمية، والمُتعلقة بالمهنة الصحفية والإعلامية بالذات، والحضور لبعض الأنشطة المُختلفة بمدينة "تعز" لولا ذلك، لفضلتُ البقاءَ بالقرية، مَعَ أنه لم يَعُد يُوجد فارق كبير بين القرية والمدينة عَدَى في الزحام والفعاليات المختلفة.
إستراحة مع ذكرى بكرامات الأرواح
كذلك، أتواجد بالقرية أيضًا، و.. أحيانًا للتمتع بالعزلة قليلًا، استثمارًا للعقل، الذي لايزال باقيًا و.. كاملًا كما أحسب، بفضل الله وَحده ورعايته، رُغم محاولة "أنصار أنفسهم"، أيام سِجننا الولدين حمزة وذي يزن وأنا، التأثير على العقل كبعض أقراني السجناء، والنيل منه ولو قليلًا! وذلك من خلال استخدام بعض وسائل التعذيب والترهيب والحرب النفسية... و... و..!
مع أن وُجود (أب) وبجواره اثنان من أبنائه بنفس الوقت وبنفس السجن، ومن حُسن الخط بنفس "الزنزانة"، لا أَخَالُ ذلك قليلًا في التأثير على العقل والبدن معًا! لكن فضل الله وَلُطفه، كانا هما الحاضرين حينها ودومًا! إلا أن "الحوثة" نجحوا في بعض الجوانب الأُخرى/ إذ مازلتُ أستخدم العلاج لأمراض "الربو" أو "التَّحسُّس"، وما يُعانيه حمزة وذي يزن بِعِلل أُخرى، وهي بمجملها معاناة (ضئيلة) قد لا تُعَد شيئًا عند المقارنة ببعض زُمَلاء السجن، فالزميل جمال المعمري، دخل السجن ماشيًا على قدميه وصحيح الجَسَد والبَدَن، لكنه خرج مشلولًا! ومسعود البكيلي، وهو شاب من مديرية بكيل المير في محافظة حجة، لم يتجاوز الـ٢٨عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة بالزنزانة من شدة التعذيب، وهناك من دخل بكامل عقله، فخرج مختل العقل، ومن ظل فترة لا يعرف أهله مصيره، ومن لقي حتفه... ومن... الخ.. وهذا فقط على سبيل المثال لا الحصر.. فالحمد لله على كل حال، أولًا وأخيرًا.
(ألتمس العذر إن خرجتُ بالكتابة هنا عما أرغبُ بقوله من كلام شبه ناعم! لِأتذكر كلامًا خَشِنًا وشبه مُؤلم! مكررًا عذري لذلك، لولا أن الشيء بالشيء يُذكر!).
حياة القدرة... بين الأحد واليوم
أجَلْ، كلما أتواجد بالقرية، أظل أستمتع بالعُزلة، استثمارًا للعقل، وَجَنيًا لأفكار جديدة، واغتنامًا للأنفاس، يُسَاعِد على ذلك جمال الطقس والطبيعة، بما يُمثلان من راحة نفسية ومن صَفَاء ونَقَاء.. وتلك هي شبه الباقية من حياة القرية بالأمس! وإن لم تَعُد كما كانت اليوم وبنفس الزَخَم!

أيضًا، تدفعنا تلك الذكريات للتأمل في المقارنة بين ما كانت عليه قرية (الأمس) وما باتت عليه (اليوم!).
فها أنا أتواجد بنفس المكان الذي وُلِدتُ بين جدران أحد أمكنته، وقضيتُ أيام الصِّباء فيه، حتى ولو بُني منزل شبه حديث مكان نفس المنزل المُندَثر، لم تذهب الذكريات التي لاتزال وستظل باقية، وما تبقى من جُدران وأزقة، والتي ظللتُ أعيش بها ولو حُلمًا، وإلى درجة رغبتي في تقبيل تلك الجدران والأزقة والأمكنة! ليس فقط عِشقًا لها! وإنما لأيام الأمس وأمكنة الأمس بكل ما ومن منها؟!
"أمرُّ على الديار دِيار (سَلمَى)
أُقبل ذا الجدَارَ وذا الجدارَا
وَمَا حُبُّ الديار شَغَلن قلبي
ولكن حُبُّ من سكن الديارَا"
 مع الفارق الكبير بين "قيس" الذي كان يقصد (حبيبه) "ليلى" أو "سلمى"، وبين كاتب هذه الأحرف، والذي يقصد أهم من الحبيبة التي لم تكن موجودة بنفس لغة ومقصد "قيس"، وإنما أعني أسمى وأجل مَن كان ولايزال وسيظل في الوجدان والشعور والحل والترحال عندي، أعني: (أُمي) التي كانت لي ولأشقائي أُما وأبًا معًا.. رحمهما الله.
مع الفارق الكبير بين "قيس" الذي كان يقصد (حبيبه) "ليلى" أو "سلمى"، وبين كاتب هذه الأحرف، والذي يقصد أهم من الحبيبة التي لم تكن موجودة بنفس لغة ومقصد "قيس"، وإنما أعني أسمى وأجل مَن كان ولايزال وسيظل في الوجدان والشعور والحل والترحال عندي، أعني: (أُمي) التي كانت لي ولأشقائي أُما وأبًا معًا.. رحمهما الله.
كذلك، أتذكر مدرستي أو بالأحرى "المعلامة" ومديرها -عمي شقيق والدي- عبدالله، طيب الله ثراه، والذي كان تربويًا حقًا، وصارمًا بنفس الوقت، ولا أخَال أحدًا من أقراني ولا من الجيل الذي جاء بعدنا ينسى ذلك الرجل الاستثنائي بحق، والذي جمع بين حسن التربية والصرامة والفكاهة معًا، والذي لم أُحظَ بوداعه الأخير، كونه انتقل إلى جوار ربه وأنا بزنزانة "الحوثة" -رحمه الله رحمة الأبرار.
فما أصعب بل استحالة عودة تلك الأيام و"المعلامة"، والحِبر والطبشور والكتب، والعُمر الذي ذهب! ولكن طالما والأمر كذلك، فلنظل نتذكرها وِجْدانًا وشعورًا وَحُبًا على الأقل.
وعلى نفس تلك الأمكنة وعلى مَقربة منها، بُنيت منازل شِبه حديثة، فظلت بهم عامِرة قليلًا، لكنها صارت هي الأُخرى خَالِية: حيث وفاة البعض، رحمهم الله، بينما البعض الآخر لايزال مغتربًا خارج الوطن، والبعض الثالث هجرها حُبًا للسكن في المدينة، رُغم عدم ما يدفعهم لذلك إلا القِلَّة! فأظل أقف أمام أبواب معظمها وهي مُغلقة، لأجد اليأس يكاد ينطق من يأسها، حتى وجدتُ نفسي حينها أردد مع نفسي:
"بكت دَارهم من بعدهم فتهللت
دُموعي فأي الجازعين ألُومُ؟
أمستعبرًا يبكي على اللهو والبلى
أم آخرُ يبكي شجوه فَيهِيمُ؟"
طهفان - البناء يوضع على المراعي في القدم في الموقع (التبع الحامض)
ومن ذكريات الأمس، حينما كانت قريتي والقرى المجاورة تفرح بِشدَّة، حينما يأتي موسم الأمطار كهذه الأيام، وتكون الأرض مزروعة، ويظل مَا يُسمى "الجهيش" بمثل هذه الأيام يَطغى عَمَّا عَدَاه، بينما اليوم نجد البِناء شبه الحديث قد قضى على معظم مساحة الأرض على حساب زراعة الحبوب، إلا القدر اليسير، وبعض المُزارعين، وإن كانوا قِلَّة في قريتنا، فضَّلوا زراعة القات لِسُرعة جَني العائد المادي منه، رغم استهلاكه للمياه ومصائبه وَعِلَلِه، ورغم عدم جَوْدَتِه قياسًا لِقُرى شِبه بعيدة، في إطار المُديرية ذاتها.
وحينما عَبَّرتُ عن رغبتي واشتياقي لـ"الجهيش" فلربما عَلِمَ أو الحاسة السادسة ألهمت العزيز الأُستاذ حسين بجاش ظاهر الجابري برغبتي، وهو الذي جاء لإدارة مدرسة "النور" الابتدائية -الإعدادية -الثانوية، وطورها عَرضًا وجوهرًا، وليكون خير خلف لخير سلف، والذي درس العلوم السياسية بجامعة صنعاء، وتخرج بامتياز، لكنه بدلًا من الابتعاث أو التوظيف بوزارة الخارجية! يومها فضل العودة إلى مسقط رأسه، خِدمة لها ولأبنائها من خلال إدارة المدرسة، ومُشَارِكًا للعامة أفراحها وأتراحها، ولايزال وسيظل، مع أن السياسة ظلت ولاتزال تجري في شرايين دَمِه، وإن لم تطغَ على مهامه التربوية والخَدَمية والإنسانية.
سعاد هو قطعة الأرض
أقول، حينما عَلِم أو أحسن برغبي للجهيش، كونه لايزال يحرص على إحياء بعض مزارعه، ولو تكريمًا وإحياء لآبائه وأجداده، ظل خلال الثلاثة الأيام التي قضيتها بالقرية، يرسل لي ذلك، لِيُوقِظَ "جهيشه" ذاك، ذكريات جميلة وخاصة جدًا! يصعب إن لم يستحل نسيانها، بقدر ما يصعب سردها للعامة! فَسَامَحَ الله أبا "حَمَد"، وشكر الله له بآن واحد.
كذلك ظللتُ أتذكر مدى (السعادة) الحقة التي ظل الآباء والأجداد يعيشونها وعاش أمثالي جزءًا منها بالقرية، رغم صعوبة الحياة بمجملها يومها، والافتقار للضروريات أو لبعضها، فضلًا عن الكماليات، ومع ذلك، ورغم ذلك العيش النكد واللُّبس الخشن، وبعض مناظر البؤس والشقاء، إلا أنهم -رحمهم الله- لم يكونوا حينها يشعرون بنكد ولا بسخط، وما ذلك إلاَّ لوجود القَنَاعة بالذات، والارتباط المُطلق بالله وبالإيمان بقضائه وقدره، ليكون ذلك وراء سعادة الأمس، وتلك لعمري، هي صفات رجال الأمس، وامتيازات حياة الأمس.
بينما حياتنا اليوم رغم وجود الضروريات والكماليات، بل التمتع بتكنولوجيا اليوم، إلا أننا بتنا نفتقد سعادة وأمن واستقرار الأمس، ومع بناء جُدران الأحواش بين منازل اليوم، بات الجار لا يعرف جاره، أو يكاد التواصل بين الجارين قليلًا، حتى بعض الأقرباء دخلوا في شرائع وتحالفات وانقسامات! و... و... الخ.. أكرر هنا (بعض!) وهكذا.. لم يَعُد اليوم في القرية الجار قبل الدار، ولا الأقربون أولى بالمعروف! فيا للعجب!
جمال المرأة الريفية - لا يزال هو معيار الجمال الطبيعي
حتى جمال الأمس، كان جمالًا طبيعيًا دُون تكلف ولا "مكياج" ولا "بَهَارات".. فظل أجمل وأبهى من جمال المدينة عرضًا وجوهرًا، وذلك هو ما أكده مَعشُوقي "المتنبي" قبل أكثر من ألف عام، حينما قال:
«حُسنُ الحَضَارة مَجلُوبٌ بتطرية
وفي البَدَاوة حُسنٌ غير مَجلُوبِ»
وظل الآباء والأجداد يتعايَشُون مع سُفُور المرأة بقيم وأخلاق إسلامية وعربية، وكأني بهم كانوا يتذكرون قول "عنترة" الذي كان يتمتع بأخلاق عربية قبل الإسلام، إذ يقول:
"وَأغُضُّ طَرفي إن بَدَت لي جَارتي
حتى يُواري جَارتي مأْواها"
بينما اليوم وبذات القرية، رغم "الحِجَاب" في الغالب، إلا أن الأخلاق غير الأخلاق والقيم غير القيم، والرجال غير الرجال! وكنتُ سأزيد على ما بات عليه وضع القرية اليوم، لكنني اكتشفتُ فجأة أن في فمي مَاء!
حتى ليالي الريف في الأمس، كانت لها أسْحَار وَظُلُمَات لا تتخللها أنوار، لكنها بصفائها ونقائها، بما في ذلك عند رؤية القمر، أجمل الكواكب صورة، وأبينها منظرًا، ومسامرة النجوم في السماء وغيرهما، كانت أفضل وأجمل وأريح للنفس، مما باتت عليه ليالي اليوم، في القرية بل وفي المدينة أيضًا، حيث بات ازدحام السماء بأنوار وطاقات وأقمار سابحة في الفضاء، وبغير ذلك مما باتت تنتجه تكنولوجيا اليوم التي بقدر ما أعطتنا من رفاهية بقدر ما أخذت منا! حنين جارف للماضي الجميل، وما يحمل من ذكريات جميلة وبعضها شبه مؤلمة، بخاصة عند ذكريات أمثالي لأشخاص ووجوه عزيزة لها مكانة كبيرة في النفوس والوجدان والشعور، ممن انتقلوا إلى جوار ربهم، ومنهم أُمي وَأبي وشقيقتي وأعمام وأخوال وأجداد وأقارب وجيران وأصدقاء... و... و.. ممن يصعب نسيانهم إن لم يستحل، وحينما أذهب إلى مقبرة (القرية) لقراءة الفاتحة والدعاء لهم، لا أستغرب أن كل من تحت (الثرى) فيها، هم أجداد وآباء وأمهات وأقارب وجيران وأصدقاء، وكلهم معروفون للخاصة والعامة دُون استثناء، رحمهم الله جميعا.. وتلك ميزة من ميزات القرية عن المدينة أيضًا!
وهكذا، كلما أذهب إلى مسقط الرأس يومًا أو بعض يوم، أظل أتذكر ذلك الماضي الجميل وتلك الأيام الجميلة بحلوها وهو الغالب، وبمُرها وهو النادِر! ثم، لِأُسجل عبر "القلم" جزءًا يسيرًا جدًا من بعض تلك الذكريات التي تحتاج لمقالات عِدة، بل لكتابٍ خاصٍ بها، والتي هي ليست خاصة بكاتب هذه "الدردشة"، بقدر ما تخص غيري، بالذات من أبناء قريتي ممن هم نفس عُمري ولايزالون أحياء، أطال الله بأعمارهم، فالكل يختزنون ذكرياتهم عن ماضي القرية الجميل، لكن متاعب وصخب الحياة أشغلتهم عنها، لأكون المُعبر عنهم أيضًا، ولكي أوقظ في نفوس بعضهم بعض تلك الذكريات ولو مُؤقتًا! وهي ذكريات بمجملها قد لا تقتصر عن قرية أو مديرية يمنية بقدر ما هي ذكريات عامة، مع الفارق في العَرض وليس بالجوهر.
ختامًا، أقول لمسقط (الرأس) قد لا أتردد عليك كثيرًا، لكني أظل أشعر بوجودي بين جدرانك ووديانك وأزقتك كل لحظة في حلي وترحالي، من خلال كل ذكرياتي، التي تربطني فيك، وفي كل أمسيات الحنين إلى لياليك.. فإلى زيارة قادمة أيتها الحسناء، ولا أقول وداعًا، كما لا تظني أنني سوف أنساك، فمن الأشياء والذكريات الجميلة ما لا تُنسى.
ثُم، أما بعد..
أكتب هذه الأحرف شِبه (الناعمة)، والتي أحسب خُلوها من "السياسة" ومن مُعَالَجَة بعض عِلَل وَمِحن اليمن عبر "القلم" التي قد لا تنتهي، وأخشى القول، لن تنتهي!
فرأيتُ أخذ إجازة عن كتابة بعض تلك الجوانب، وإذا تسربت فكرة شِبه "سياسية" أو ما شابهها بين هذه "الدَّرْدَشَة"، فلربما حدث ذلك دون رغبة! وكل ذلك لِهَدَفين اثنين: الترويح عَن النفس مُؤقتًا، والترويح عن القارئ -إن وُجِد- مُؤقتًا أيضًا!
يحيى عبدالرقيب الجُبَيْحِي
الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤م
عزلة بني بُكاري -مديرية جبل حبشي -محافظة تعز