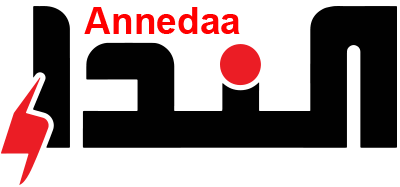"شهادة ذاتية"(*)
حين تكون مع "عبدالباري" يخيل إليك كأن تعريف، ومضمون، ومصطلحَ المثقفِ المدني الحداثي إنما وُجد أو اختُرع ليطلق عليه...، في حياته وسلوكه، اختزالًا مكثفًا لصورة ومعنى المثقف، للإنسان حامل القيم، والمثل العليا، من قلائل المثقفين الذين يجمعون بين ثقافة تراثية، ودينية، وبين ثقافة حداثية، مدنية، ديمقراطية واشتراكية، في أزهى وأقشب أثوابها الحداثية رقيًا، وتمثلًا لقيم ومفاهيم العصر...، شخصية تتلألأ بتمثال ضوء وحبور وفرح، إنسان مفتوح على كل جهات الصداقة والحياة، قدومه إلى أي مجلس أو منتدى يضفي على المكان حيوية، وحبورًا وأُنسًا، حضوره في المكان -أي مكان حتى السجن- يضيء المكان ويُرقص نجوم الكلام في زوايا المكان، مؤكدًا جديد الإنسان، والمكان معًا، حتى في أكثر الأمكنة بؤسًا وقتامة على الروح والنفس، وهو المعتقل "القلعة" لا يخلو من البشاشة والتفكير الضاحك، لتشعر معه بتحولات المكان، وأن المكان معه وبعده لا يعود كما كان، وهو إحساس يطغى على الكثير ممن يعرفونه ويجالسونه، وليس على أصدقائه فحسب، وكأن حضوره يقول لنا: إن المكان ليس مجرد مسافة أو جغرافيا، وإنما هو الإنسان. وعبدالباري إنسان حقيقي أولًا وقبل أي شيء وكل شيء، وحين يفقد الكائن البشري صفة الإنسان، عندها يمكن أن نطلق عليه أي شيء إلا أن يكون إنسانًا، والمثقف، الشاعر والروائي، والفنان إن لم يكن في البدء إنسانًا، وكلمة إنسانية، فلا معنى بعدها لما يكتبه من شعر، أو رواية، أو نقد، أو أي جنس من أجناس الكتابة والإبداع. تصور أن تسحب روح الإنسان وماهيته الإنسانية من داخله، فماذا يتبقى من هذا الكائن؟ فما يتبقى ليس أكثر من جسد مادي أقرب إلى هيكل خَرِب، مدمر الروح، خاوي الوجدان.
إن "عبدالباري" حليم إلى درجة الصفر، والثلج، وصبور بلا حدود، وليس غضوبًا، وإن شئت فهو قليل الغضب، أو نادرًا ما يكون كذلك، فيه بساطة وعفوية الطفل الذي يعطي نفسه بسهولة ويسر، ويكشف ما في داخله دفعة واحدة في كثير من الأحيان، بمثل ما فيه من تعقيد صورة المثقف، وحساسيته الإنسانية، ولا تخلو شخصيته الحياتية من تعقيد صورة الباحث والمفكر، الذي يفكر ويتأمل في تبعات كل شيء.
السخرية والضحك اللذان تحملان أحاديث ونكات، وقفشات "باري" لا تختلف في الجوهر عن الفكرة، والرسالة، والمعنى الذي يكتبه، وإن كانت الكتابة أبقى وأخلد من الكلام. إرسال النكتة والضحكة الساخرة لا تنفصلان عن متابعة تفاصيل السياق العام للحياة، وفيهما تجديد وتنويع لأساليب وأدوات نقدها، فيها تحديد موقف من السالب في الحياة، ومتابعة لمثالب ونواقص الواقع، ودعوة لتجاوز العفن السائد.
وفي سخريته الناقدة بالكلمة المكتوبة أو النكتة الشفاهية، تجد نفسك منجذبًا لممارسة فعل الحرية، فعل السخرية الناقدة، وتقودك من أخمص عقلك الرصين، ورغمًا عنك، للضحك في زمن البكاء، حتى للضحك على نفسك، وعلى من تحب.
إن تاريخ الكتابة النقدية (الفكرية، الثقافية، الصحافية، الأدبية، الفنية، والإبداعية) من الصعب تصوره خارج شرط حضور كتابات ثلة من الأسماء الحداثية النبيلة في حياتنا الثقافية والأدبية والفنية والإبداعية، مثل محمد علي لقمان (المحامي)، عبدالله علي الحكيمي، الزبيري، النعمان، لطفي جعفر أمان، باذيب، عبدالله فاضل فارع، محمد أنعم غالب، الشاعر عبده عثمان، البردوني، المقالح، عمر الجاوي، جرادة، إدريس حنبلة، عبدالرحمن فخري، أبو بكر السقاف، أحمد قاسم دماج، عبدالباري طاهر، عبدالكريم الرازحي، عبدالودود سيف، إسماعيل الوريث، زكي بركات، محمد مرشد ناجي، المحضار، أحمد بن أحمد قاسم، سلطان الصريمي، محمد سعد عبدالله، علي السمة، محمد عبده زيدي، وجميع رموز الفن والموسيقى والغناء الجميل، ولا يمكن -اليوم- للقارئ المتابع، أو الناقد في مستويات الإبداع النقدي، أن يطل على البدايات الأولى للإصلاح، والحداثة، والتنوير، ليصل إلى ما نحن عليه، دون ملاحقة وتتبع هذا المسار الإبداعي التحديثي لهذه الكوكبة وغيرهم الكثير. وحين أشير إلى هؤلاء الذين علموني الكثير أعترف بأنني لم أكن تلميذًا نجيبًا، ولا كذلك مطيعًا، كما لا أدعي تمثل سلوك العديد منهم على الأقل ممن عرفتهم وعايشتهم عن قرب.
عبدالباري طاهر، اسم حي فاعل ومؤثر، ترك ومايزال، بصماته على الحياة الفكرية والثقافية، وعلى مسار الصحافة اليمنية المعاصرة خصوصًا، هو بحق مثقف عضوي، عقلاني، نقدي، نجده اليوم حاضرًا في جميع تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة، هو بحق فخامة المثقف، وجلالة الإنسان، والمناضل، تمثال فرح، وقوة نور آتية من صوت الكلمة الممانعة، والحرف المقاوم. وليس عفوًا نعته أو وصفه بالفخامة والجلالة، فهاتان الصفتان، والمفهومان، والمعنيان لا يصح إطلاقهما سوى عليه وعلى أمثاله من المثقفين المدافعين عن صوت الحق والعدل، والحرية، وهي محاولة لتصحيح وضع، وحالة غير سوية، وبداية لنزع هاتين الصفتين ممن لا يستحقانهما من الأسماء، التي لا صلة ولا قربى بين الموصوف، والصفة، حيث الموصوف نقيض الصفة، ولكنها مشيئة السلطة الفاسدة، وأحوالها ومفارقاتها في تسمية الأشياء بغير صفاتها وذواتها...، فقد حان الوقت لتكريم المثقف، وتفخيمه، وإجلال دوره، وهو الجدير حقًا بشمول هاتين الصفتين عليه. ففي اسمه وعظمة دوره كل الفخامة والجلال.
الحقيقة أنني لم أبذل جهدًا -ولو بسيطًا- لمعرفة لماذا كلما تذكرت عبدالباري طاهر، تزحف وتتقاطر إلى ذهني أسماء كثيرة ونبيلة، مثل يوسف الشحاري، محمد علي الشهاري، المقالح، عمر الجاوي، البردوني، عبدالرحمن فخري، خالد فضل منصور، عبدالله حسن العالم، أبو بكر السقاف، غسان كنفاني، محمود أمين العالم، محمود درويش، حسين مروة، مهدي عامل، أحمد بهاء الدين، صلاح عبدالصبور، سعد الله ونوس، أمل دنقل، محمد الماغوط، ممدوح عدوان... إلخ.
هل ما يجمعهم هو التاريخ المقاوم؟ أم هو المشترك الثقافي الإبداعي؟ أم هي القيم الإنسانية الكبرى التي حملوها وتمثلوها، وحافظوا عليها في العقل والوجدان؟ أم هي السمة السياسية التقدمية الغالبة عليهم جميعًا؟ أم هو الموقف الإنساني والإيجابي من الحياة الذي جسدوه في مسيرة حياتهم الزاخرة بالعطاء، والعمل الدؤوب لترسيخ القيم والمثل العليا، والمشاريع الفكرية والثقافية، والسياسية الكبرى، التي نشهد اليوم تراجعها وانتكاستها، وتقهقرها، كما هي عند صف معين ممن كانوا حملتها، ونكسوا على أعقابهم، إلى جذورهم البدائية الأولى (الشعوذة، الطائفية، والقبلية، والقروية، والعصبية، وصولًا إلى التأسلم السياسي)؟ لا أدري لماذا تحيلني بعض الأسماء الثقافية اليوم، ومنهم الصديق عبدالباري، إلى المعنى المصادر والمغيب عن حياتنا، وتدفع بالعقل نحو تلمسه فيهم بحثًا عما بقي من المعنى، في صورة بعض الأسماء التي مثلت وعكست صفحات مشرقة في تاريخ الكتابة والقول الحق، تاريخ حديث الروح الذي لا ينتهي حول ضرورة تحرير الكلام مما يغايره.
في العديد من الحالات أجد نفسي أختلف قليلًا أو كثيرًا مع ما يذهب إليه صديقي عبدالباري، من قراءة أو تحليل، أو تفسير لهذه الفكرة أو تلك، كما أجد نفسي لا أتفق مع ما يراه من تقويم لهذا المسار السياسي، أو ذاك، ولكني لا أستطيع إلاَّ أن أحترم اجتهاداته وتفسيراته وتحليلاته، فمن ذلك الاختلاف والاتفاق يأتي غناء الروح، وتجدد الفكر، فمن ذلك التعدد والتنوع والخصوصيات، والحق بالاختلاف، والحق في الخطأ، السبيل الأكيد للوصول إلى المعرفة الأرقى، والأكثر قدرة على الاقتراب من الحقيقة، وصيرورة التقدم في مساره اللانهائي.
وفي تقديري، مهما طال العمر بثقافة الغلبة، والقوة، والشوكة، فمآلها إلى زوال، كسابقاتها -الأقدم تاريخيًا- ولن يعرف أو يُدَوِّنَ التاريخ اليمني في سجله أسماء الكثيرين من الحكام الذين تعاقبوا على حكمه، إلا بقدر اقترابهم أو انتمائهم إلى التاريخ الثقافي، وإلى المعاني والدلالات الإنسانية والإبداعية التي أسهم في صناعتها وإنتاجها الأسماء الفكرية والثقافية والإبداعية الذين سبقت الإشارة إليهم -وغيرهم من الأقدم تاريخيًا- ومنهم فخامة المثقف وجلالة الإنسان، عبدالباري طاهر، وهو المعنى نفسه الذي قاله "ونستون تشرشل" وهو في قمة انتصاره بعيد الحرب العالمية الثانية: "إنني فخور بأنني أنتمي إلى البلد والتاريخ الذي صنعه شكسبير".
عبدالباري، هو اليوم صورة يمنية نموذجية للمثقف الموسوعي، وقد يكون واحدًا من أواخر الموسوعيين، ومن أسماء قليلة تظلل حياتنا وتشعرنا بدفء التاريخ في جلاله الإنساني، في هذا الزمن الجدب، زمن المثقف المعلوماتي، المثقف المستودع، الذي يحول المعرفة والثقافة إلى أرقام، وإلى كم، وركام من الأسماء أو الأشياء والمعلومات، التي لا معنى لها في سياق وحدة المعرفة الإنسانية المنتجة للمعنى وللفكرة، وتحويل العقل الإنساني إلى أداة، أو كمبيوتر جامع للمعلومات، وجداول إحصائية رقمية لا تشير إلى معنى أو فكرة إنسانية خالدة.
ولا يسعني القول لأخي ورفيق عمري سوى أنني أعتز بصداقتك وبتاريخ معرفتي بك، أيها الحادي والرائي، يا صاحب الفخامة والجلالة.