علي تيسير وكيل وزارة حقوق الانسان لـ"النداء":
إذا لم يغلق بطريقة صحيحة.. سيفتح يوماً ما
* الفريق الدولي هو من أغلق هذا الملف، ولم تتسلم الوزارة رسالة شكوى من أسرة «السيلي» عن اختفائه
قال وكيل حقوق الإنسان إن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الكرامة الانسانية وإنكاراً لمقاصد الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي وردت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
- جلال الشرعبي
واشار علي تيسير في مقابلة مع «النداء» إلى أن الإختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له من حماية القانون وينزل به وبأسرته عذاباً شديداً، وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل حق الشخص في الإعتراف به كشخص في نظر القانون وحقه في الحياة والحرية والأمن، وفي عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
وكيل وزارة حقوق الإنسان الذي كان يتحدث في مكتبه قال أيضاً إن الحكومة اليمنية تعاطت بجدية وشفافية في هذا الموضوع مع فريق الإختفاء القسري من الأمم المتحدة الذي قدم إلى اليمن بخصوص طلب معلومات حول عدد من حالات الإختفاء القسري التي نتجت معظمها من جراء الإقتتال الداخلي في جنوب اليمن قبل تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990م، والذي بات يعرف بأحداث 13 يناير 1986م.
وأضاف: «لقد استقبلت بلادنا الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري منذ أغسطس 1998م، لبحث الوسائل الممكنة لحل هذه المسألة الإنسانية وبيان الجهود الحكومية وشرح الصعوبات والمعوقات التي تقف حائلاً أمام الحكومة في سبيل الحل وتمكينها من مقابلة المسؤولين الحكوميين وأسر الضحايا، وحتى الآن مازال التعاون الشفاف قائماً.
الواضح من حديث المسؤول الثاني في وزارة حقوق الإنسان أن الجهود الحكومية كانت تنصب لإقناع الخارج الممثل في الفريق المعني بالإختفاء القسري، في جنيف. غير أنه يبرر هذا بأن لقاءات عدة قامت بها الوزارة مع أسر وذوي المختفين وأنها ما زالت تتابع بقلق هذا الأمر. وأشاد بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان منذ البداية وبذلت الجهود المضنية، كما قامت بنشر إعلان صحفي لكافة أسر الضحايا لتقديم معلومات حول إختفاء ذويهم ونفذت العديد من الاجراءات الفاعلة لإستجلاء مصير المختفين، وقد قامت بتقديم تقرير في العام 2002م يتضمن المعلومات المتحصلة نتيجة لتوصيات الفريق العامل عن حالات الإختفاء القسري في اليمن. كما قام وفد رسمي بالعديد من الزيارات بدعوة من الفريق وتم مناقشة التقارير المقدمة من الجانب اليمني في لقاء عقد في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك في اغسطس 2002م.
وأوضح الوكيل: «كان نتيجة تلك الجهود أن أوقف الفريق النظر في (56) حالة من الحالات المبلغ عنها لاقتناعه بالردود المقدمة حولها، واعتبارها منتهية بعد مرور ستة أشهر كاملة دون تلقي تعقيبات أو مراسلات حولها من قبل الجهات التي أبلغت عن تلك الحالات أو الأسر المهتمة بمعرفة مصير أقاربها المدعى اختفاؤهم، وأبقى الفريق تحت النظر (35) حالة طالب الفريق الحكومة اليمنية ببذل المزيد من الجهود في التحقيقات حول هذه الحالات حتى يتم استجلاء الموقف عنها. كما وافى الفريق اليمن بالحالات الأخرى المسجلة لديه وعددها (150) حالة اختفاء يدعى بحصولها في فترات مختلفة منها في الستينات والسبعينات والثمانينات ومنها يدعى حصولها في حرب صيف 94م أو أثناءها».
وتابع: «لقد قمنا بصفة دورية بإرسال كافة المعلومات التي حصلنا عليها إلى الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري حيث أعلن الفريق العامل تعليق النظر في (6) حالات وتطبيق قاعدة الستة الأشهر عليها لاعتبارها منتهية في شهر سبتمبر 2004م».
وحول اعتبار الوزارة تاريخ الإعتقال تاريخ وفاة للاشخاص المختفين وقيامها بتقديم معلومات للفريق الدولي حول العديد من المختفين باعتبارهم متوفين قال: «عندما لا نعرف مصير شخص له سنوات طويلة مختف حينها نعتبره متوفى ونقدم للفريق الدولي معلومات عن استلام ذويه لراتبه بانتظام».
يعتبر وكيل وزارة حقوق الانسان تسليم الراتب لذوي المختفي الذي تعتبره الوزارة متوفى وتطالب جهة عمله بشهادة الوفاة إنقاذاً لسمعة البلد [وردت هذه العبارة في احدى مخاطبات الوزارة] تعويضاً كافياً لأسرته، وأن غير الموظفين قد تم اعتماد مكافأة شهرية لذويهم «لا يعرف مقدارها». وفي يونيو 2005م، أعلن فريق الإختفاء القسري أن الحالات التي ما زالت قيد النظر من قبل الفريق عددها (90) حالة فقط، بعد أن تم إقناعه من الجانب اليمني بأن الحالات الأخرى (60) حالة، تعتبر منتهية و غير محتاجة إلى إعادة البحث والتحري حولها.
خلاصة حديث وكيل وزارة حقوق الانسان أن هناك التزاماً رسمياً يمنياً دؤوباً لإقناع الفريق الدولي بإغلاق قضايا مختفين قسرياً ما زالت حالاتهم تمثل قلقاً كبيراً أمام الحكومة اليمنية، وأن هذا الجهد الذي ينصب بتفان نحو الخارج يكسوه الصمت وربما الغياب في التواصل مع أسر وذوي المختفيين قسرياً في الداخل. وأن أسارير الوجه تبدو عريضة حالما يحقق الفريق اليمني نجاحاً في إقناع الفريق الدولي بإغلاق قضايا مختفيين قسرياً غالب أهاليهم يعيشون ظروفاً صعبة وإنتظاراً قاسياً.
ويقول علي تيسير إن الفريق اليمني الذي يضم ثمانية أعضاء قام بالنزول الميداني لأغلب المحافظات والمدن التي يتواجد فيها أهالي المختفين لرفدهم بالمعلومات التي يمكن رفد التقرير الرسمي بها- وهذا يعني أن الجهود المبذولة تنصب في إثبات حالة الوفاة بالنسبة للمختفين، دونما تقديم شهادات تثبت وفاتهم من قبل الجهات التي قامت باعتقالهم.
ورغم نفي عديد من ذوي المختفين لـ«النداء» الذين كانوا غير موظفين مع الدولة، استلامهم لمرتبات حكومية، إلا أن وكيل حقوق الإنسان أكد أنه تم التواصل مع عديد جهات رسمية وهي تتكفل بمنح إعانات ومرتبات شهرية لذويهم اعتبرها الوكيل تعويضاً.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان: «سنغلق هذا الملف غلقاً أمنياً، قسرياً. وإذا لم يغلق بطريقة صحيحة فإنه سيفتح يوماً ما».
وأضاف: «إن ملف المختفين قسرياً من الملفات الكبيرة وتستحق الأطراف الرسمية التي تعمل في هذا الشأن التقدير».
وحول مسؤولية الدولة ومساءلتها إزاء حالات إختفاء قسري كانت طرفاً فيها قال: «كيف أحاسب أشخاصاً ليس لديهم يد في الموضوع، ولم تكن الدولة الحالية هي من تحكم، والمسؤولون ليسوا هم انفسهم عندما حدثت عمليات الإختفاء؟! ولو كانت الدولة هي التي تحكم لحاسبناها بشكل كبير».
وتابع: «لا تتحمل الدولة مسؤولية مباشرة فيما حصل ولكنها تظل مسؤولة أخلاقياً وانسانياً حتى تقوم بالسيطرة عليه وتعويض المتضررين وهي تجتهد من أجل هذا وإن كان ليس بشكل كامل».
وقال علي تيسير إن وزارته مستعدة لبذل كل جهودها إذا تبين أن أياً من ذوي المختفين لا يتسلمون رواتب ذويهم أو تعرضت للإيقاف لأنها وسيط بين الأشخاص والجهات الرسمية. «أقول عبر «النداء»: أي أسرة تم إيقاف راتب عائلها المختفي قسرياً لن تقف الوزارة مكتوفة الأيدي وستتابع بجدية هذا الأمر».
وبشأن إختفاء صالح منصر السيلي قال: «ليس لدينا معلومات كافية ومؤكدة عن حالته. وما نعرفه أنه كان لديه إمكانيات مالية كبيرة وقد يكون إختفاؤه مناسباً له بل ومن في حالته سيبذل كل الجهود حتى يختفي.. علاوة على أن وزارة حقوق الإنسان حتى الآن لم تتسلم أي شكوى من أهله وذويه عن إختفائه لذا فإن الغموض يحوم حوله».
وأوضح أن العديد من الجماعات استخدمت هذا الملف استخداماً سياسياً للمناكفات. لكنه يحترم الآراء من أي جهة كانت ما دام الموضوع بهكذا أهمية.
وحول نية العديد من أسر المختفين تفعيل قضيتهم دولياً حال استمرت الجهات الرسمية متجاهلة لهم قال: «المسألة لا تحتاج إلى هذا الحمل الثقيل».
وعن قانونية إغلاق الملف من قبل وزارة حقوق الإنسان قال: « الفريق الدولي هو من أغلق الملف طبقاً لشروطه المتبعة»
وأشار وكيل وزارة حقوق الانسان إلى أن جملة من الصعوبات واجهت عملهم منها عدم وجود سجل مدني متكامل لتسجيل جميع حالات الولادة والوفاة خلال الفترة التي وقعت فيها الأحداث، وأن العديد من الظروف والأوضاع التي رافقت تلك الأحداث أدت إلى فقدان الكثير من القرائن التي يمكن الإعتماد عليها كأدلة إثبات للحالات، فضلاً عن عدم وفرة البيانات المقدمة من المفوضية لتوضيح الحالات المحددة في كشوفاتها، والصعوبات التي رافقت عملية البحث عن المعلومات وعدم ذكر ألقاب بعض الحالات الواردة في كشوفات المفوضية ووجود تشابه كبير في الاسماء الثلاثية لبعض الحالات.
«إن ما تأمله اليمن من الفريق الدولي هو أن يتم تطبيق قاعدة الستة أشهر على كافة الحالات المدرجة في كشوفات الفريق العامل المعني بالإختفاء القسري».
هذا ما يؤكده الوكيل علي تيسير والعبارة التي تجدها الوزارة مناسبة لتذيل بها تقاريرها المقدمة إلى المفوضية السامية.
[email protected]
***
البحث عن تحسين سمعة بدلاً من المفقودين
اهتمام الأمم المتحدة المتزايد والمتعاظم -بحقوق الإنسان هو العنوان البارز للعلاقة بين هذه المنظمة الدولية، وأسر المختفين قسراً، وناشطي حقوق الانسان -جماعات وأفراد- في اليمن. وتمسك أرباب وأولياء وهذه الأسر، ببلاغاتهم السابقة واستماتتهم الصلبة في المطالبة بالكشف عن مصير ذويهم، هي العنوان الأبرز في هذه العلاقة القائمة على مبدأ أن حياة الانسان مصطفاة نبيلة ورفيعة جداً، حرمت الشرائع السماوية والقوانين والمعاهدات انهاءها أو ابادتها أو انتهاكها أو الانتقاص منها بالظلم أو التعسف أو القهر أو الخطف أو الاختفاء القسري غير الطوعي.
ويجد المتابع لملف الاختفاء القسري في اليمن أن العلاقة بين أسر المختفين قسراً والمفوضية السامية لحقوق الانسان سابقة بسنوات على العلاقة بين المنظمة والحكومة اليمنية، وتقوم على قوة الحجة وتشبث الأسر بحقوق ذويها المختفين.
البداية الزمنية لهذه العلاقة غير دقيقة لمن أراد توثيقها والتعاطي معها، فهناك من يرى انها بدأت عقب احداث يناير 86م ونزوح جماعات كبيرة ممن كانوا يُعرفون بـ«الزمرة» إلى الشطر الشمالي، وجعل صنعاء محطة للتواصل مع المفوضية بجنيف ونيويورك. واستجابت المفوضية -كما تبين تقاريرها- كثيراً لتقارير الاختفاء القسري التي كانت ترسل احياناً من باب توسيع نطاق المعونات والمساعدات الخارجية: المادية والمالية، لأسر المختفين قسراً وضحايا هذه الاحداث عموماً. وأحياناً أخرى من باب المماحكات وتصفية الحسابات مع الحزب الاشتراكي اليمني اثناء حكمه للجنوب.
ويتجسد هذا الرأي الأخير في ذلك التحامل غير المبرر الذي اظهره الرد الرسمي للجمهورية اليمنية الصادر في يوليو 2002م على المفوضية. فالرد الذي أعدته اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان اثناء تولي علي الآنسي مدير مكتب الرئاسة، لرئاسة اللجنة، يحمل الحزب الاشتراكي مسؤولية هذا الملف، وينفي في نفس الوقت نفياً قاطعاً صحة تلك البلاغات المتضمنة حدوث حالات اختفاء قسري اثناء حرب صيف 94م وما بعدها.
العلاقة بين الاسر والمفوضية بدأت -بحسب مراقبين- قبل يناير 86م، فهناك بلاغات محدودة جداً و اقتصرت في الغالب على حالات الاختفاء خلال سبعينيات القرن الماضي. ولا بد هنا من الاشارة إلى الدور الهام والحيوي الذي لعبته وتلبيه المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وناشطون في هذا المجال، فهؤلاء يمثلون همزة الوصل الرئيسة بين اسر المختفين والمفوضية ويكادون أن يكونوا مصدر معلومات واتصال مباشر مع هذه المنظمة الدولية وقناة رئيسية لإيصال بلاغات الاختفاء أولاً بأول إلى المفوضية.
وبالتتبع للمحطات وللمحطات الزمنية الاساسية لهذا الملف الشائك، فإن عام 1998م يُعد نقطة تحول هامة في حلحلة ملف الاختفاء القسري في اليمن، فقد زار وفد من مفوضية الامم المتحدة لحقوق الإنسان كلاً من صنعاء وعدن خلال الفترة 17-21 اغسطس من ذلك العام وأعدَّ تقريراً مفصلاً عن حالات الاختفاء قدمه لاحقاً للحكومة اليمنية للرد عليه.
الرد الرسمي الأول الصادر عن الحكومة اليمنية في يوليو 2002 تضمن جوانب هامة، نوجز اهمها في النقاط الآتية:
- رغبة الحكومة، الملحة، في التعاون مع المفوضية لأجل حل قضايا جميع حالات الاختفاء القسري وبما يكفل إغلاق هذا الملف نهائياً.
- ان الملف ليس بذلك الحجم أو الخطورة التي تحدث في بعض الدول، ويتضمن حالات محدودة حدثت في ظروف سياسية معينة، وخص الرد بالذكر احداث يناير 86م.
- قيام الحكومة بتسوية اوضاع من تبين اختفاؤه في احداث يناير.
- الاعلان عن توجه الحكومة لمعالجة كافة قضايا الاختفاء القسري.
واكدت الحكومة اليمنية في ردها عدم تحفظها في تعويض أي اسرة ثبت فقدانها أحد أقاربها في احداث يناير 86م (لم يتم تعويض أي اسرة حتى اللحظة)، واعتبار كل من ذهب ضحية هذه الأحداث شهيداً وتتقاضى اسرته إعانة شهرية من جهة العمل التي ينتمي إليها «الفقيد»، وفي حالة عدم عمله في جهة حكومية تمنح الاسرة إعانة من طريق وزارة الشؤون الاجتماعية (الإعانة تبلغ 2000 ريال, 10 دولارات تقريباً، تبجح الحكومة رخيص).
وبالعودة إلى أدبيات مفوضية الأمم المتحدة فقد حددت جملة من الضوابط الاجرائية والاستنتاجات والتوصيات والفقرات المطلوب من الجانب الحكومي توضيحها، أبرزها: ملابسات حالات الاختفاء القسري المبلغ بها، وتشكيل فريق عمل يتولى التواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا القانونية فيما يتعلق بحالات الاختفاء، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الأشخاص المختفين وأفراد اسرهم والتدابير المتخذة لمنع حدوث حالات اختفاء في المستقبل.
وهناك سلسلة اجرائية مهمة متصلة بالأطراف المعنية الأخرى (أسر المختفين والناشطين والمنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال) وتقوم هذه السلسلة على صحة بيانات بلاغ الاختفاء وتحديد عنوان وهاتف والبريد الالكتروني كل من هذه الاطراف، والتواصل مع المفوضية والالتزام بالمهلة المعروفة (ستة اشهر) وهو الاجراء الأهم.
وتبين وقائع عديدة ان الاجراء الاخير يشوبه ثغرات وإشكاليات وإرباكات عديدة تحول دون تواصل المفوضية مع هذه الأطراف لإبلاغها بالرد الرسمي لكل حالة من حالالت الإختفاء قبل ايقاف النظر في الحالة من عدمه، وأبرز هذه الاشكاليات تلك المتعلقة بالعناوين وارقام هواتف الاطراف المبلغة بالحالة.
حتى الآن أوقفت المفوضية النظر في أكثر من 90٪ من الحالات (من أصل 142 حالة)، لكن الملف اليمني ما يزال عامراً، فقد أضافت المفوضية مؤخراً قائمة تضم 71 حالة جديدة معظمها لحالات سجلت عقب حرب 1994.
قد تفعل الحكومة آليات استخراج شهادات وفاة جديدة، لكن سمعتها في الخارج لن تتحسن.
***
ضحايا الإختفاء القسري.. جراح لم تندمل بعد!! - فهمي السقاف
 تعاقبت الانظمة ولم يعترف أو يعتذر احد لذوي الضحايا. لم يفكروا برد اعتبار هؤلاء وتعويضهم. المنظمات المعنية بحقوق الانسان في بلدنا لم تطالب السلطات يوماً برد اعتبار المختفين، وتعويض ذويهم، ومعرفة مصيرهم قبل كل شيء. فعلت المفوضية السامية التابعة للامم المتحدة ذلك لمرة وصمتت. (يجب الاشارة إلى جهد بذل من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية التي كان يرأسها د/أحمد الكازمي بعدن التي بذلت جهوداً لجمع معلومات عن ضحايا الاختفاء القسري في اليمن، ولكن المنظمة الآن تعيش حالة موت سريري!!).
تعاقبت الانظمة ولم يعترف أو يعتذر احد لذوي الضحايا. لم يفكروا برد اعتبار هؤلاء وتعويضهم. المنظمات المعنية بحقوق الانسان في بلدنا لم تطالب السلطات يوماً برد اعتبار المختفين، وتعويض ذويهم، ومعرفة مصيرهم قبل كل شيء. فعلت المفوضية السامية التابعة للامم المتحدة ذلك لمرة وصمتت. (يجب الاشارة إلى جهد بذل من قبل المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات الديمقراطية التي كان يرأسها د/أحمد الكازمي بعدن التي بذلت جهوداً لجمع معلومات عن ضحايا الاختفاء القسري في اليمن، ولكن المنظمة الآن تعيش حالة موت سريري!!).من حق أسرته أن تعرف مصيره
علوي عبدالقادر العراشة. كثيرون ممن يعرفون الرجل يذكرونه بالثناء عليه: شهامة, وكرماً، ودماثة خلق.
مساء يوم ال23/2/1972م، ليس تاريخ ميلاده؛ إنه يوم وتاريخ اختفاءه، تقريباً اليوم الأخير الذي شوهد فيه.
قبل قرابة عامين شاهد عيان على اختفائه روى لي ما شاهده حينها. ظلت روايته في تلافيف الذاكرة. شراكها حاضرة في ذاكرتي. ومضيت لألتقي شقيقه الأكبر: سقاف عبدالقادر العراشة، لأسمع منه ما يعرفه عن ملابسات إختفاء شقيقه. بدأ حديثه معي قائلاً: «كنت في جعار في السجن (اعتُقل لانتمائه للتنظيم الشعبي لجبهة التحرير وهو كان من العناصر القيادية الناشطة فيها) جلب معه لي وجبة غداء وسجائر وأتى لزيارتي، (كان يحدثني وعيناه مثبتتان للأفق مستعيداً تلك الأحداث وكأنها حدثت للتو كفلم سينما تمر أحداثه أمام عينيه). سألته عمن أتى معه، سمى لي خمسة أشخاص أعرفهم بعضهم يسكن جوار مزرعتنا في قرية مجاورة للمزرعة، وستة من قرية الديو، كنت طلبت منه قبل ذلك اليوم عندما زارني قبل زيارته الأخيرة أن يأخذ الوالدة ويغادر إلى عدن، سألته: لماذا أتيت لزيارتي؟ ألم أطلب منك أن تأخذ الوالدة وتذهب إلى عدن؟! تجادلنا في هذا الأمر. هو لا يريد أن يترك المنزل والمزرعة ولا يرى سبباً موجباً لذلك. وأنا من سجني أرى اضطراب الأوضاع السياسية و الفوضى التي كانت سائدة آنذاك.
وعدني: غداً سنذهب أنا والوالدة إلى عدن. طلبت منه توخي الحذر. مضى ومن كانوا معه، تناولوا الغداء وخزنوا. عصراً سألهم إن كانوا مروحين، أجابوه بأنهم سيتأخرون. واحد منهم رافقه في طريق عودته إلى البيت، لم تمر سوى دقائق. الساعة تقترب من الخامسة مساء... (سألته مقاطعاً: كيف عرفت هذه التفاصيل وأنت في السجن؟) عرفت ذلك بعد سنوات طويلة عرفته من شهود عيان شاهدوه يومذاك وكذلك واحد ممن كانوا معه يومها روى لي ما حدث بأثر رجعي كان ذلك في عام 199٠م عقب عودتي من منفاي الاختياري: دولة الامارات العربية. (وواصل رواية صحبه الذين قالوا له بأنهم سيتأخرون).. لحقوا به في سيارة تابعة للصحة وأدركوه قبل أن يصل منزله، لحقوا به في الوادي، أبلغوه بأنه مطلوب وعليه مرافقتهم.
تساءل: ماذا فعلت؟! نحن معاً دائماً معاً ونعرف بعضنا من سنوات طويلة بحكم الجيرة و...إلخ! كانوا ضيوفه على الغداء وشاركوه ذات المقيل قبيل دقائق كانوا مخزنين معاً، سألهم عما إذا كانت لديهم توجيهات من جهة رسمية باحتجازه، اعتقاله. أجابوه بأن لا حاجة بهم لذلك وأن عليه أن ينفذ ما طُلب منه وينصاع لهم ويركب السيارة، رفض وتشاجر معهم، مزقوا قميصه تمكن من الهرب منهم، هو أعزل مدني مسالم! أشجار الوادي الكثيفة مكنته من التخفي والهرب، عاد أدراجه صوب منطقة المخزن، طرق باب عامل يعمل لديه في المزرعة، طلب منه إبلاغ اسرته بما حدث معه في الوادي والاشخاص الذين حاولوا خطفه وذهب بعدها مباشرة إلى مقر اللجنة الشعبية بالمخزن (الميليشيا) الكائن في مقر تعاونية المخزن ليبلغ بما حدث معه، هو واثق من أنه بريء، تصرف بفائض براءة، لم يدر أنه كان المستجير من الرمضاء بالنار، زُج به في السجن، تساءل: لماذا تسجنوني؟ ردوا عليه: نحميك منهم. مساء نفس الليلة اقتيد من مقر اللجنة الشعبية بالمخزن صوب المجهول!!».
لم يعرف عنه شيء. خاطبت والدته وأخوته شقيقه الأكبر سقاف الذي أُفرج عنه بعيد اختطاف أخيه لمدة 12 يوماً فقط وُزج به بعدها في السجن لسبع سنوات عجاف. ردود الجهات المسؤولة يومها: لا ندري! أبحثوا عنه ربما يكون عند بعض أقاربه في لحج. وبعد ذلك كان ردهم: حرب الشمال؟!
من حق أسرته أن تعرف مصيره. هو ليس الوحيد؛ كثير كان مصيرهم مماثل وإن أختلفت التفاصيل:
الهارب إلى الشمال
حسين عمر عبدالله السقاف متزوج وأب لتسعة، 4 ذكور و5 اناث. مدني. في تمام الثالثة و النصف عصراً يوم 26/6/1973م كان الرجل مقيل في منزله بقرية الخاملة م/ أبين بين أفراد اسرته وأولاده. ثلاثة مدنيون يوقفون سيارتهم في الوادي القريب من القرية يطرقون باب منزله، يفتح لهم ، يطلبون منه مرافقتهم لساعات لسواله عن اشياء تعلمها الجهة التي ارسلتهم له!!
قسمات وجوههم تشي بالخطر حال رفض ذلك. اطفاله الصغار حوله. خاف ان يحدث مكروه لعائلته إن أبى الذهاب معهم، رافقهم. شهود عيان، أفادوا حينها بأنهم رأوه وهم يدخلون به بوابة جهاز أمن الدولة حينها في أبين.
إقتيد أيضاً نحو المجهول. نجله الأكبر عمر حسين عند سماعي له روى كيف صادروا سيارة والده. لم يكتفوا بذلك بل طالت المصادرة آليات زراعية لجده وتبعها مصادرة أراضيهم الزراعية. كذلك كان الأمر مع علوي عبدالقادر العراشة، إحتلوا منزله الطيني المكون من دورين في قرية الديو، وصادروا أراضيهم الزراعية وما عليها حتى الماشية طالتها المصادرة. ذات الردود من السلطة تلقاها عمر عند السؤال عن أبيه: لا علم لنا! ربما يكون عند بعض أقاربه ذهب لزيارتهم اسألوا عنه عندهم. وبعد فترة: هرب الشمال! وحتى اللحظة لم تعرف اسرته عن مصيره شيئاً.
العزيبي في إجازة صيف
منصر محسن عبدالله العزيبي، مصيره لم يختلف عن سابقيه إلا في بعض التفاصيل. متزوج وله 4 أولاد وبنتان. ليلاً طرقوا باب منزله (صبر م/لحج)، أربعة مدنيون (لباسهم مدني)، وطلبوا منه مرافقتهم. هو أحد العناصر القيادية في التنظيم الشعبي، أصيب في إحدى المعارك مع الاحتلال البريطاني، نقل للعلاج في جراء إصابته ومنها إلى جمهورية مصر العربية، اعتقل مرتين: مرة في سجن الفتح الشهير وأخرى في سجن مدينة الشعب. وأفرج عنه في مساء يوم 18/4/1971م. أقتاده زواره القسريون إلى المجهول. كان يعمل في الهيئة العامة للمياه، بئر ناصر - عدن. صودرت مستحقاته، راتبه لم يصرف لأولاده، وتصل الصفاقة بالنظام أن يصدر توجيه لكبير المحاسبين بتصفية اجازاته لتصفير راتبه للفترة من 20 ابريل إلى13/6/72م.
كان الرجل بإرادته المحصنة يقضي اجازة صيف طالت بعض الشيء لزم معها تصفية اجازاته، ليدفع راتبها.
وبعد ان تنقضي ولم يأت، يوقف الراتب، اسرته لم تعلم عنه شيئاً، صودرت مستحقاته وأوقف راتبه. وذات الردود من السلطة تلقاها أولاده: هرب الشمال!
36 عاماً من الإنتظار
مصير عبده سعد محمد لم يختلف كثيراً عن مصير من سبقوه. صباح يوم 17/4/1971م ذهب باكراً عمله كعادته دائماً (يعمل في المؤسسة العامة للحفر م/ لحج)، منذ ذلك اليوم وأسرته قيد الانتظار. ستة وثلاثون عاماً ولم يعد بعد. طرقت أسرته أبواب السلطات المختصة، بحثاً عنه. لا جواب خارج الاجابات المعتادة: ابحثوا عنه لدى أقاربه! بعدها: هرب الشمال! عبده سعيد محمد متزوج وأب ل5 ذكور و3 اناث، ينتمي سياسياً للتنظيم الشعبي. راتبه مصدر دخل الأسرة الوحيد اختفى مثله، أي أوقف. وعلى اسرته البحث عن مصدر رزق بديل!!
المخطوف من داخل غرفة العمليات
< النقيب / علي الدهبلي، كنت أنا شاهد عيان على اختفائه. عاينه الطبيب الجراح بمستشفى الصداقة اليمنية المجرية («صلاح الدين» العسكري) وأمر بترقيده في قسم الجراحة الخاص بالضباط ليكمل فحوصاته، وبعدها أجرى له عملية جراحية.
سأكتفي بإيراد الإسم الأول لارتباطه المباشر بعملية اختفاء النقيب الدهبلي.
ملازم إسمه «سيف» قبيل أحداث يناير 1986م بأسبوع تقريباً رقد في المستشفى هو والدهبلي، لكن الأول في قسم الجراحة والثاني في قسم الباطنية، انفجر الصراع الدامي صبيحة ال13 من يناير، الملازم سيف مرعوب مذعور كفأر يقضم اظافره بالتناوب يميناً ويساراً يصعد إلى قسم الباطنية تارة، وتارة ينزل ليبول أسفل الدرج. بدأ الطرف المنتصر بالسيطرة على المعسكرات في منطقة صلاح الدين. اختفى سيف لساعات، وعاد لابساً الزي المبرقع الخاص بقوات الصاعقة بدلاً من زي المرضى.
صباحاً ادخل الدهبلي غرفة العمليات واجريت له العملية. مساءً يعلن سيف -ومعه جنديان- حظر الحركة في المستشفى. يأمر الجنديين بدخول غرفة الدهبلي واقتياده لأنه خطر ومطلوب «زمرة».. مع أنه مريض في المستشفى ولم يحمل سلاحاً ولم يشارك في المعارك التي حدثت. أكتب ذلك والمشهد يمر أمام ناظري. أحاط الجنديان بالدهبلي، ذات اليمين وذات الشمال وسيف مصوباً سلاحه الآلي من الخلف إلى مؤخرة رأس النقيب الدهبلي الذي يمشي بصعوبة جراء العملية التي اجريت له. كان ذلك تقريباً في 17/1/1986م. وهكذا اختفى الدهبلي ولم تعرف اسرته عن مصيره شيئاً حتى اللحظة.
أسر وذوو المختفين قسرياً، يريدون -وهذا حقهم- معرفة مصيرهم، إن كانوا احياء فأينهم؟ وإذا كانوا موتى فأين قبورهم لقراءة الفاتحة وما تيسر من الذكر على أرواح أحبتهم؟
الزعيم الفيتنامي العظيم/ هو شي منه، اعتذر علناً لابناء شعبه ممن تضرروا اثناء الثورة معترفاً بأن اخطاء حدثت، فزادت مكانته لدى ابناء شعبه.
***
من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعتُمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992
المادة (4):
1 - يعتبر كل عمل من أعمال الإختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي يراعى فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
2 - يجوز للتشريعات الوطنية ان تتضمن النص على ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم -بعد اشتراكه في اعمال الاختفاء القسري- بتسهيل ظهور الضحية على قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعاً بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء على حالات اختفاء قسري.
المادة (7):
لا يجوز اتخاذ أي ظروف، مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.
المادة (9):
1 - يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف على حالتهم الصحية، أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضرورياً لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة (7) أعلاه.
2 - يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدى مباشرة هذا الاجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلاً عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال العثور على هؤلاء الاشخاص فيه.
3 - يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخرى مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية او أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفاً فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.
المادة (19):
يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول على التعويض المناسب, بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول على التعويض أيضاً.
***
قيامة عبدالسلام
سامي غالب
في طفولته الباكرة في القرية لم يكن «وضاح» يفتقد أباه! وعندما بلغ ال11 بدأ يحاصر والدته «منيرة» وعمه «درهم» بالسؤال عن الأب الغائب فيزيائياً. ومذَّاك كبر السؤال معه، وخبر بانصرام السنين محنة الحياة في أسرة شخص «مختف قسرياً».

في 14 يوليو 1978 نفذت عناصر أمنية حملات دهم واعتقالات في العاصمة صنعاء. كان «عبدالسلام» الكادر الشاب في الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي والتطوير، أحد ضحايا الحملات؛ إذ ضُبط في شارع السلام- باب اليمن، في التاسعة والنصف صباحاً. وطبق رواية أحد المصادر فقد اعتقل بسبب تورطه في توزيع منشورات للجبهة الوطنية الديمقراطية، أبرز الفصائل المعارضة لنظام الحكم في شمال اليمن.
في دار البشائر شوهد «عبدالسلام» عشية اليوم نفسه. كان قد تلقى حصة تعذيب دامت 12 ساعة. جيء به إلى إحدى الزنازن والدماء تغطيه. «لم يكن تعذيباً قدر ما هو تمثيل» قال شهود عيان لـ«النداء».
لم يظهر ثانية في أي مكان آخر. كانت تلك آخر مرة شوهد فيها، ما يعني -بلغة القانون- أنه ما زال محتجز الحرية لدى الأمن الوطني، حسبما أفاد «النداء» مصدر قانوني.
قبل أسبوع من الليلة المشؤومة، كانت عروسه «منيرة»، 16 سنة، تضع طفلها الأول. أرسل لها مصاريف لتغطية نفقات «السابع»، وأشعرها بأنه يُفضل أن يسمى الوليد «وضاح»، واعداً بلقياها بعد 40 يوماً!
***
كبر «وضاح» وتزوج، وصار الآن أباً لـ«أصيل»، 3 سنوات، وهو يعمل الآن في وزارة الإدارة المحلية، ويقطن رفقة أسرته الصغيرة بيتاً استأجره في العاصمة. وهناك جلست العروس التي تنتظر رجُلها منذ 29 عاماً، لتروي لـ«النداء» سيرة انتظارات بدأت بُعيد زواجها بشهر.
قالت: «تزوجت في مطلع شوال». تقدم عبدالسلام لخطبتها من أشقائها المتواجدين مثله في العاصمة لغرض الدراسة والعمل. في سبتمبر 1977 نزلوا قرية «الدمنة» في الأعبوس، وعرضوا الأمر على والدها فتقرر الزواج.
أمضى العروسان شهر العسل في القرية، ثم غادر العريس إلى العاصمة لمتابعة الدراسة (كان في السنة الثانية بكلية الشريعة والقانون) ومواصلة العمل. في عيد الأضحى عاد عبدالسلام إلى القرية، وكانت عروسه تحمل طفلهما الأول. مكث أسبوعين، وقبل أن يغادرها مجدداً أفصحت إليه عن مخاوفها: «شاموت بسبب الحمل»، لكن الشاب الضاج حيوية مازحها: لا بتموتي ولا شيء، شارجع ولا بك حاجة». منيرة لم تمت، وشريك حياتها لم يرجع، لكن الخبر السار بقدوم مولودهما البكر بلغه إلى صنعاء. بادر الأب، إلى إرسال مصاريف إلى أسرته لتغطية نفقات المناسبة السعيدة.
***
 بعد أسبوع من قدوم «وضاح»، تلقت منيرة النبأ الأليم: أعتُقل عبدالسلام! أومأتْ إلى «وضاح» وقالت لـ«النداء»: «كان عمره 7 أيام عندما اعتقلوا أبوه».
بعد أسبوع من قدوم «وضاح»، تلقت منيرة النبأ الأليم: أعتُقل عبدالسلام! أومأتْ إلى «وضاح» وقالت لـ«النداء»: «كان عمره 7 أيام عندما اعتقلوا أبوه».بين المعتقلين كان أخوه درهم، وابن عمه، وآخرون. بعد عام أفرج عن الإثنين، لكن عبدالسلام «ما خرجش، ولا احد شافه. ضاع وهيه»، زفرت العروس التي باتت الآن جدة ترعى حفيدها أصيل.
محكوم على منيرة أن تواصل انتظاراتها. «عادني ساهن (مؤملة) إنه شيرجع»، قالت.
وتفحصت «أصيل»، قبل أن تشرك الزميلة بشرى العنسي في أجواء اللحظة المنتظرة، لحظة قيامة عبدالسلام مجدداً: «تخيلي شيرجع وقد ابنه متزوج ومعه إبن».
ولكن قد يكون ميتاً منذ زمن طويل؟
لا تسلِّم منيرة بهذه الفرضية: «لا جابوا جثة، ولا شفنا جنازة ولا شهادة وفاة، ولا سلَّموا ثيابه أو بطاقته، ولا شي».
كما مئات الزوجات والامهات والآباء والأشقاء والأبناء من أسر المختفين قسرياً، تريد منيرة برهاناً مادياً: «كيف أقتنع بأنه مات؟»، سألت مستنكرة: «لو شفته بعيني ميتاً، كنت شاقول: الحمد لله على كل حال».
ما يزال الأمل مقيماً في فؤادها، تسهر منتظرة دقاته: «وإي حين ما دق الباب، فتحنا».
لم يدق عبدالسلام بابها منذ 29 عاماً. وقد حمَّلت «النداء» رسالة إلى الرئيس علي عبدالله صالح: «وصلِّوا لعند الرئيس بأننا ندور عن الرجَّال... نحن مش مقتنعين بأنه مات».
الوقت على شفرة المقصلة
خلافاً للموت، يصعب التأقلم مع الإختفاء القسري مهما استمرت الحالة في الزمن، لعمق الجرح والبعد العاطفي الذي تخلقه مشكلة إنسان حي وميت، حاضر وغائب. والاختفاء يضع الوقت على شفرة المقصلة ليصبح الغائب الأكبر في منطقة الحدث نفسه (كما يرد في تعريف الاختفاء القسري في كتاب «الإمعان في حقوق الإنسان» تحرير هيثم مناع).
تبدو منيرة أصغر كثيراً من سنها، ما تزال على عهدها: عروساً تنتظر فارس أحلامها، مزحزحة الوقت إلى دائرة الغياب الفيزيائي، كما زوجها.
عندما التقتها «النداء» عصر السبت الماضي لم تبدُ عليها أعراض حالة «الانتزاع النفسي»، الحالة التي تصيب -عادة- المقربين من الضحية.
وطبق «الإمعان في حقوق الانسان»، فإن المقربين من الضحية يعاودهم الإحساس بالذنب والمسؤولية، مع نشوء إحساس بالوحدة والفراغ. وتزورهم نوبات إحباط وانهيار عصبي، واضطرابات جسدية وعاطفية، علاوة على غياب المتعة وفقدان الإحساس بالرغبة.
***
وإذاً، فإن عبدالسلام علي عبدالكريم هايل العبسي، المعتقل في 14 يوليو 1978، ليس في عداد الأموات، دون أن يكون في عداد الأحياء.
ولد عام 1956 في الأعبوس، ودرس الاعدادية هناك، ثم انتقل إلى صنعاء سعياً وراء الرزق. حصل على وظيفة في وزارة المالية، وواصل دراسته الثانوية في مدرسة «جمال عبدالناصر»، ضمن نظام «المنازل». تخرج من الثانوية بتفوق، والتحق بكلية الشريعة والقانون.
كان عصامياً ومثابراً وديناميكياً، طبق شهادات مجايليه. كان في قلب زمنه حاضراً، وقد جذبته الفكرة الاشتراكية، فانخرط في الحزب الديمقراطي الثوري، في سن مبكرة.
وفي مارس 1978، انتقل عبدالسلام الى الاتحاد العام للتعاونيات. سنتذاك استأجر ومجموعة من أصحابه شقة في الصافية الجنوبية.
كانت سنة العواصف والتقلبات الكبرى.
كان الرئيس ابراهيم الحمدي قد أغتيل في الخريف السابق، فتوترت الأوضاع السياسية في البلاد، ونشط معارضو الحكم في شمال اليمن، مستفيدين من الغضب الشعبي لاغتيال الرئيس المحبوب، وحالة «الدوار» التي أصابت حكم الرئيس الجديد أحمد الغشمي، الذي لم يلبث أن اغتيل قبل انقضاء 8 أشهر على كرسي الحكم، إذ أودت به حقيبة مفخخة يحملها مبعوث جنوبي خاص صباح 24 يونيو 1978.
بعد نحو 20 يوماً من اغتيال الغشمي كان مصير الكرسي الرئاسي ما يزال متأرجحاً بين القاضي عبدالكريم العرشي الرئيس المؤقت، والمقدم علي عبدالله صالح، الضابط الصاعد بقوة من داخل القوات المسلحة. وفي الأثناء كان جهاز الأمن الوطني يطوِّر آليات قمع المعارضين وغير المعارضين، في لحظة لاح فيها الحكم عند أجهزته وحماته معرضاً لخطر وجودي!
الثابت أن الخطر الوجودي كان يحدق بالعشرات من الرجال والشباب الحزبيين، وغير الحزبيين. كان درء الخطر عن النظام الموجود يتطلب محو وجود عشرات الشباب الأبرياء.
صباح 14 يوليو 1978 أعتُقل عبدالسلام، ومساء اليوم ذاته اعتُقل عشرات آخرون، بينهم شقيقه الأصغر درهم (المولود في 1958).
شهادة الوفاة كأداة تحسين سمعة
عبر سنوات طوَّرت الحكومة اليمنية آليات وتقنيات للتحايل على عذابات أسر المختفين قسرياً. في حالة عبدالسلام المغيَّب، تتوسل الجهات الرسمية المعنية إغلاق ملفه، كيفما أتفق.
في مذكرة من أمة العليم السوسوة وزيرة حقوق الانسان إلى صادق أمين أبو رأس وزير الإدارة المحلية، بتاريخ 28 نوفمبر 2005، أمُلت الوزيرة موافاتها بأية وثائق قد تفيد في بيان الإجراءت التي تم بناءً عليها اعتبار حالة عبدالسلام من ضمن الوفيات.
ولكن لماذا تحرص الحكومة اليمنية والوزارة المختصة بحقوق الانسان على تصنيف عبدالسلام في عداد الأموات؟
ببساطة: «ليتسنى لنا تقديمها للفريق العامل المعني بالاختفاء القسري (بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف) ما سيسهم بشكل كبير في إيقاف النظر في هذه الحالات من قبل الفريق المعني (...) وتحسين ملف بلادنا في مجالات حقوق الإنسان»، كذلك ختمت الوزيرة أمة العليم السوسوة خطابها إلى زميلها وزير الإدارة المحلية!
الجريمة مستمرة، كما نرى، والمطلوب شهادة وفاة لرجل ليس في عداد الأموات، لغرض تحسين سمعة اليمن دولياً.
«طلبوا منا في الإدارة المحلية نطلِّع له شهادة وفاة على شان الراتب، لكن إحنا ما رضيناش»، قالت منيرة. ثم احتدت: «يقنعونا أولاً (إن كان) حي أو ميت».
لا ترى الغالبية الساحقة من أقارب المختفين قسرياً في وزارة حقوق الانسان، نصيراً لها، بل تم تعيين الوزارة كعدو مباشر يحول دون استرداد الضحايا لحقوقهم. «الوزارة صارت الغريم»، قرَّر -باطمئنان- درهم علي عبدالكريم، الشقيق الذي اعتُقل مساء اليوم نفسه وأفرج عنه بعد عام.
تحولت وزارة حقوق الإنسان إلى حفار قبور.
وبدلاً من متابعة أسر الضحايا، تجهد الوزارة من أجل ترتيب وثائق رسمية تفيد بتسوية الحالات الواردة في قوائم المفوضية. لكن الإنسان المحتجز أو أقاربه، فإنه مجرد «مذكور» في مراسلات الجهات الحكومية والمتخصصة برعاية حقوق الإنسان.
الإبن الذي صار أباً!
«بعد أسبوع من ولادتي اعتقلوا والدي»، قال وضاح عبدالسلام. «ما زلنا ننتظر عودته»، أضاف رب الأسرة الصغيرة المكونة من والدة صابرة، وزوجة، وابن (أصيل) إنه الحفيد الذي يظهر في هذه الصفحة حفياً بصورة جده.
بقي من «عبدالسلام» عشرات الوثائق الخاصة بملفه، وصورة فوتوغرافية واحدة مقاس 4*6، إنها الصورة الوحيدة التي أفلتت من سطوة الأمن والمخبرين والمتواطئين والمتكتمين على الجريمة.
في طفولته لم يكن وضاح يفتقد أباه. ومع الوقت بدأ يثير التساؤلات عن الأب الغائب فيزيائياً، الأب الذي فقد كل وسيلة للتواصل معه. والآن فإن وحيد أبويه يجهد من أجل وضع حد لجريمة مستمرة عمرها من عمره.
تزوج وضاح قبل أربع سنوات، ورزق بطفل أسماه «أصيل». وطبق منيرة فإن الحفيد العنيد ورث سمات جده: الشاب الذي ما تزال تنتظره. وفي منزل الأسرة المتواضع في شارع هايل، بدا أصيل شكساً وعنيداً واستقلالياً بامتياز. وإلى ذلك فقد اختصت الطفل ذا الثلاث السنوات بوظيفة فتح باب المنزل أمام الزائرين، لكأنه، كما جدته، ينتظر قدوم الجد الطيب في أية لحظة. وقد بدا مرة، خلال زيارة «النداء» للمنزل، ساخطاً لأن شخصاً آخر في الأسرة سبقه إلى فتح الباب لإحدى الزائرات.
خبُر وضاح جيداً محنة العيش في أسرة «مختف قسرياً». ويتذكر الآن كيف اجتاح الفزع والدته عندما قرر الانتقال إلى صنعاء. فالعاصمة، في نظر منيرة، ليست عاصماً من الفقد، وقد حاولت عبثاً منعه من السفر إلى «موقع الجريمة». يستعيد الهلع الذي ارتسم في عيني أمه مؤخراً، عندما أصيب بوعكة صحية، وأسعف إلى المستشفى، تاركاً أصيل في حضنها.
بين يدي وضاح عشرات الوثائق، بعضها يعود إلى ما قبل ولادته بسنوات، وبعضها إلى أيام ما بعد النكبة. أحدها تحمل توجيها من أحد المسؤولين في الإدارة المحلية نهاية السبعينيات تقول: «طالما والمذكور في السجن، يُصرف له نصف راتب».
وفي مذكرة أخرى مطلع التسعينات وجه محمد سعيد عبدالله، وزير الادارة المحلية، مذكرة إلى وزير الخدمة المدنية يفيده بأن «عبدالسلام علي عبدالكريم لا يوجد ما يثبت وفاته نظراً لاعتقاله سياسياً عام 1978 وعدم ظهوره حتى الآن»، وبالتالي «يُرجى عدم إحالته على التقاعد حتى إشعار آخر».
إلى جانب وضاح يقف العم درهم بقوة ضد إغلاق ملف أخيه الذي يكبره بعامين. وقد قاتل درهم بضراوة لتعرية دسائس وألاعيب البيروقراطية الرديئة في اليمن.
في مطلع 1992 حرر درهم مذكرة إلى وزير الإدارة المحلية توضح له بأن «أخي عبدالسلام علي عبدالكريم لا ينطبق عليه قانون التقاعد» لأنه لم يبلغ بعد أحد الأجلين: ليس متوفى، ولا بلغ سن التقاعد.
حينها كان درهم قد بلغ 34 عاماً، وكان عبدالسلام، الغائب فيزيائياً، في ال36. لكن منيرة ما تزال الآن، وفي كل أوان، تلك الشابة القروية الصغيرة التي تنتظر كل عشية قرعات عريسها على «باب الأمل»، شريكها الذي يدفع منذ 3 عقود ثمن استقرار نظام حكم، وثمن تحسين سمعته خارجياً.
نوح الطيور
طبق روايات أفراد أسرة عبدالسلام فإن «منيرة» تتابع أسبوعياً البرنامج التلفزيوني «نوح الطيور» وهو برنامج مخصص للجمع بين المفقودين، أو بين المغتربين في الخارج و أسرهم.
تشاهد منيرة «نوح الطيور» أسبوعياً، وتجهش باكية.
- بمشاركة بشرى العنسي
***
(2) المختفون قسرياً
أحياء أم أموات
- سامي غالب
Hide Mail
يوجد ارتباط قوي بين الوحدة اليمنية وملف المختفين قسرياً. ومن أسف تأخذ العلاقة الارتباطية بين المنجز التاريخي والملف الإنساني المترع بعذابات آلاف اليمنيين صيغة الارتباط العكسي! يحضر المنجز فيغيب الملف..يغيب الإنسان.
في 22 مايو 1990 رفع قادة الجمهورية الجديدة شعار «الوحدة تجب ما قبلها»، وتبين، تالياً أن المغزى هو التفلت من أية مسؤوليات حيال ضحايا الصراعات والحروب الأهلية الداخلية في شطري اليمن.
لم تجب الوحدة ما قبلها، وكان محتماً أن تتحول إلى رافد كبير لصراعات وحروب داخلية جديدة.
قبل الوحدة سقط عشرات الآلاف من القتلى جراء الاقتتالات والانقلابات والحروب الداخلية في الشطرين، وبينهما. ودفع آلاف الضحايا من دمهم وأعمارهم ضريبة العنف المعمم، وأزهقت أرواح الأبرياء على مذبح ايديولوجيات عمياء تحتقر الحياة الفانية (!) بزعم فراديس موعُدة تبشر بها.
تحت غطاء الايديولوجيات والقضايا الكبرى والثوابت الوطنية التي لا تتزحزح من مواقعها في الخطاب الاستبدادي، أوغلت الانظمة المتعاقبة في الشطرين في دماء اليمنيين. وكذلك كانت الوحدة اليمنية أداة القامع مثلما هي وعد المقموع. باسمها ومن أجلها سوِّغ التقتيل، كما التضحية. وداخل هذه الثنائية المرعبة حُشِّر مئات اليمنيين في منزلة بين المنزلتين: ليسوا أحياء، ليسوا موتى. هؤلاء هم ما اصطلح على تسميتهم بالمختفين قسرياً.
لم تجب الوحدة ما قبلها من استبداد وقمع وترويع واستعلاء على عذابات أسر المختفين قسرياً. لم يكشف «العهد الوحدوي» عن مصائر «المغيبين فيزيائياً» خلال العهود التشطيرية، لم يعتذر الجناة للضحايا.
تجاهل السادة الوحدويون ضحايا عهودهم التشطيرية. وقدَّروا وحدهم بأن الإنجاز التاريخي يتعالى على تواريخ المختفين وعذابات أقاربهم.
والحال أن «القضايا الكبرى» و«الثوابت الوطنية» احتفظت بقدرتها الأدائية في العهد الوحدوي. وكان أن اندلعت حرب 1994، وأنضم عشرات، وربما مئات، الضحايا، إلى قائمة المختفين قسرياً.
شرعت «النداء» في عددها الماضي بفتح ملف المختفين قسرياً بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني، عيد الوحدة. وكان التقدير أنه من الواجب، مهنياً وأخلاقيا، تظهير الدلالات المتصادمة المتولدة عن الحدث التاريخي.
لدى أقارب المختفين قسرياً، كما يتضح في شهاداتهم التي أدلوا بها لـ«النداء»، ارتبطت الوحدة بالخلاص تارة، وبالحرب تارة أخرى. بداية أخذت صيغة الجمع (جمع الضحية بأسرتها) قبل أن يتضح انها صيغة طرح (طرح الوعود جانباً). وعدت بلقاء أحبة، وآلت إلى وحدة موحشة للضحية (الحي الميت!) ولأقاربه المتوحدين بزمن تغييب الضحية فيزيائياً.
على مدى السنوات الماضية، أخذ ملف المختفين قسرياً طابعاً تقنياً في تعاطي الحكومات اليمنية المتعاقبة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان. انتهت معاناة الضحايا وأسرهم إلى محض وثائق ومذكرات متبادلة لتسوية شؤون صغيرة عالقة.
ومن زاوية أخرى، تعاملت المنظمات الحقوقية والمدنية ببرود مع هذا «الملف الحارق» الذي تنبعث منه روائح شواء أوصال الضحايا، لكأنها تستعفف الاقتراب منه.
ومن زاوية ثالثة، تم حشر قضايا المختفين قسرياً داخل خطاب سياسي معارض يتسم بالعمومية والارتجال. وأكثر من ذلك تم تبهيت هذه المأساة الكبرى عبر تجريدها المستمر، لكأنما هي واحدة من المطالب المزمنة للاصلاحيين في اليمن.
وعلى الجملة، فإن عذابات أقارب المختفين قسرياً تتغذى باستمرار من هشاشة الوعي الحقوقي والديمقراطي لدى المطالبين بالتغيير، وضعف الوازع لدى ناشطي حقوق الإنسان, الدعاة قبل الأدعياء، هؤلاء المتلفعين بالجليد، الذين يدبُّون في أقصى البقاع وأصقعها ليتفادوا الاقتراب من مناطق مسوَّرة بالنار، محصنة بالنسيان.
إلى هؤلاء وأولئك، وإلى الوحدة الوعد، وإلى الأسر المعذَّبة، وإلى الأحياء المغيبين فيزيائياً، تقدم «النداء» في هذا العدد شهادات جديدة، ووعداً بمواصلة النشر في الأعداد المقبلة.
***
أبي.. لا مزيد!
 كنت، أنا أحمد صالح، في الخامسة والنصف من عمري عندما شاهدت والدي لآخر مرة مساء 24 يونيو 1994.
كنت، أنا أحمد صالح، في الخامسة والنصف من عمري عندما شاهدت والدي لآخر مرة مساء 24 يونيو 1994.كنا قد انتقلنا إلى منزل جدتي (لأمي) الكائن في المعلا. وإلى ذلك المنزل كان والدي الرائد صالح مقبل صالح المقبلي، الضابط في معسكر الجلاء في البريقة (صلاح الدين) يتردد لزيارتنا كلما سنحت له الظروف خلال الحرب.
- أحمد صالح
مساء 24 يونيو جاء والدي للاطمئنان على أسرته الصغيرة: والدتي أمل أحمد عبدالله يعقوب خان، واختي نيفين التي تكبرني بعامين، وأخي علي المولود في 15 مايو 1992. ما زلت أذكر هيئته جيداً، وما تزال انفعالات اليوم الأخير منقوشة في ذاكرتي. أتذكر والدتي وهي ترجو منه البقاء معنا. قالت له: «إجلس معنا، أني خايفة عليك»، لكنه طمنها بأنه لن يتعرض لأذى، وأبلغها بأنه لا يستطيع أن يتخلى عن واجبه الوطني. تلطف معنا، ثم غادرنا، وكان الحس بالخطر الوشيك يتحكم بوالدتي.
ذهب ولم يعد. لم نره ثانية، لم نتلق أية أخبار عنه، لم توافنا جهة، بأية بيانات عن مصيره. لم تتفضل أية منظمة حقوقية بزيارتنا يوماً، ولم يبادر أحد ما إلى التخفيف عنا، كنّا وحيدين وما نزال كذلك.
وها إن اليأس يكاد يجهز على آخر بارقة أمل في قلوبنا بعد انقضاء 13 عاماً على غيابه.
انتزعت حرب 1994 أبي من بيننا، ومعه انتزعت السلام من أسرتنا الصغيرة.
أذكر والدي جيداً: دفئه الذي لم أذقه منذ اختفائه قسرياً، وصرامته التي كانت تظهر ساعة يشعر بالقلق علينا، كما في ظهيرة أحد أيام ما قبل كارثة الحرب. خارج منزلنا المتواضع في البريقة، كنت أقود دراجتي ذات الثلاث عجلات، فمرقت سيارة مسرعة كادت تدهسني، فهرع أبي إلى المكان لينهرني من معاودة اللعب بدراجتي في وسط الشارع.
حرمتني الحرب من صرامة الأب!
 خلال إحدى زيارات والدي مطلع أيام الحرب، كان دوي يملأ المكان، مثيراً الذعر في نفوسنا، سألت أبي: أبا أيش دي القوارح؟، رد باسماً: لا تخفش هذي طماش! لم تكن طماش، فصباح اليوم الأول للحرب دوَّى انفجار جوار بيتنا في البريقة. لم أصمد أمام فضولي الجارف، أنا الأبن الذي يحمل سر أبيه وجيناته، أبي الضابط الشاب المتخصص في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. سارعت إلى الخروج من البيت وكنت أول من شاهد قذيفة صاروخية (غير محملة بمتفجرات) في الشارع. وقيل لي إن الصاروخ الذي لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو بشرية، أطلق من معسكر الجلاء لأغراض تجريبية. لكنها الحرب تودي بحياة الأبرياء. فظهيرة اليوم نفسه قدمت جدتي إلى بيتنا لتأخذنا إلى بيتها الآمن في المعلا. وافقت والدتي، وغادرنا جميعاً رفقة الجدة الطيبة.
خلال إحدى زيارات والدي مطلع أيام الحرب، كان دوي يملأ المكان، مثيراً الذعر في نفوسنا، سألت أبي: أبا أيش دي القوارح؟، رد باسماً: لا تخفش هذي طماش! لم تكن طماش، فصباح اليوم الأول للحرب دوَّى انفجار جوار بيتنا في البريقة. لم أصمد أمام فضولي الجارف، أنا الأبن الذي يحمل سر أبيه وجيناته، أبي الضابط الشاب المتخصص في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. سارعت إلى الخروج من البيت وكنت أول من شاهد قذيفة صاروخية (غير محملة بمتفجرات) في الشارع. وقيل لي إن الصاروخ الذي لم يترتب عليه أية أضرار مادية أو بشرية، أطلق من معسكر الجلاء لأغراض تجريبية. لكنها الحرب تودي بحياة الأبرياء. فظهيرة اليوم نفسه قدمت جدتي إلى بيتنا لتأخذنا إلى بيتها الآمن في المعلا. وافقت والدتي، وغادرنا جميعاً رفقة الجدة الطيبة.ولد أبي في قرية «زُبيد» بمحافظة الضالع عام 1963. بعد إنهائه المرحلة الثانوية، التحق بالكلية العسكرية عام 1982، وتخرج بعد عامين ضابطاً متخصصاً في القيادة التكنيكية لفصيلة مدفعية. وقتها كان الضابط الشاب قد تزوج قبل عام من أمل أحمد عبدالله يعقوب خان. وطبق العقد، فقد تم الزواج في 25 رمضان 1403 الموافق 6 يوليو 1983.
علمتني محنة أسرتي أن أحفظ التواريخ جيداً. سكن والداي منزلاً متواضعاً في البريقة -مديرية الشعب، عدن. اختار أبي أن يقيم قريباً من معسكر الجلاء حيث يعمل. في 19 يونيو 1986 انجبت أمي «نيفين»، شقيقتي التي أكملت الثانوية العامة لكنها اضطرت الآن إلى العمل لمساعدتنا.
كنت الثاني في الترتيب، فقد ولدت في 22 نوفمبر 1988. ثم انضم أخي علي إلى عالمنا في 15 مايو 1992. كان أسوأنا حظاً، لم ينعم قط بالكبر في كنف أب فبعد أقل من عامين اندلعت الحرب، غيبت أبي، ودفعت بنا إلى العراء.
انتهت الحرب، وبدأت رحلة البحث عن أبي. انتظرت أمي لأسابيع عودته، دون جدوى. كنا ما نزال نقيم في منزل جدتي. إذ أن البيت الذي كنا نسكنه في البريقة، لم يُعد لنا، بعد اختفاء أبي. وقد أبلغتني أمي بأن البيت تابع للجيش، ولم يعد من حقنا الإقامة فيه ما دام أبي لم يعد يشغل عمله في المعسكر!
في 16 نوفمبر 1994، أي بعد نحو 3 أشهر من انتهاء الحرب، غادرت أمي مدينتها عدن إلى صنعاء، لمتابعة صرف مصدر معيشتنا الوحيد: راتب الأب المختفي قسرياً. كانت وزارة الدفاع تقوم حينها بدمج القوات الجنوبية بالجيش، لكن اسم أبي لم يظهر في قائمة الضباط المدموجين في قوة اللواء 11 صواريخ -الحرس الجمهوري. وكان معنى هذا أن نفقد مصدر رزقنا الوحيد.
استغرقت أسرتي وقتاً لإدراج إسم والدي في قوائم المرتبات في الدائرة المالية بوزارة الدفاع. وقد توجب على أمي أن تنصاع للأنظمة الظالمة، وتستخرج شهادة وفاة، ليس باستلام راتب أبي في عدن.
الراتب الذي نتحصل عليه يبلغ 18 الف ريال، يذهب 15 الف ريال منه لسداد إيجار سكننا المتواضع في شعب العيدروس بعدن!
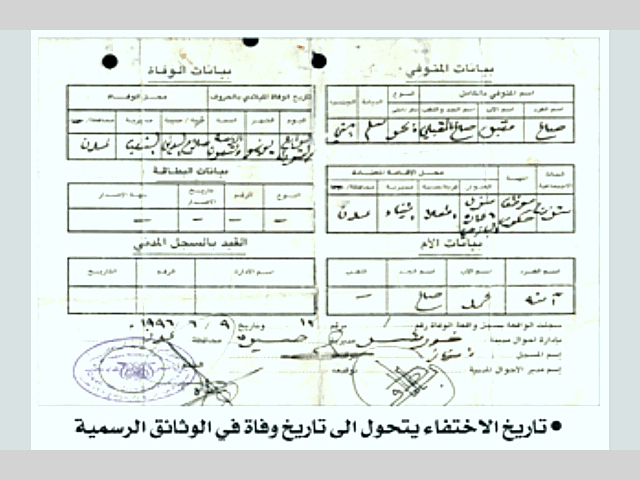 أدرس في ثانوية لطفي جعفر أمان، وأستعد الآن لامتحانات الثانوية. ويدرس علي الصف التاسع في مدرسة شمسان. ولم تتمكن نيفين من مواصلة دراستها الجامعية، وهي تعمل لمساعدة أمي على تغطية ما أمكن من احتياجاتنا الضرورية. ونحن جميعاً نعرف معنى الحرب التي أودت بالأبرياء، وشردت أسرهم، وضيعت ممتلكاتهم. ومع الوقت كبرت معاناتنا، وفقدنا سنة بعد سنة كل سند. أذكر جدي لأمي أحمد عبدالله خان، الذي كرَّس وقته وجهده للبحث عن صهره الرائد صالح مقبل صالح المقبلي. بعد عامين من الاختفاء القسري لأبي، تنقل جدي بين المحافظات بحثاً عنه. ثم غادر إلى الخليج لاحقاً. أملاً في الحصول على أية بيانات من زملاء والدي المنفيين هناك وفي نهاية 2000، وكنت حينها أدرس الصف السادس، سافرنا جميعاً، أمي وشقيقاي وأنا، رفقة جدي إلى أبو ظبي، بحثاً عن خيط يوصلنا إلى مصير أبي. والآن فإننا وحيدون نكدح لنحيا، بعدما توفي جدي، رحمه الله، قبل عام ونصف. وكانت جدتي قد سبقته إلى الدار الآخرة قبل عامين.
أدرس في ثانوية لطفي جعفر أمان، وأستعد الآن لامتحانات الثانوية. ويدرس علي الصف التاسع في مدرسة شمسان. ولم تتمكن نيفين من مواصلة دراستها الجامعية، وهي تعمل لمساعدة أمي على تغطية ما أمكن من احتياجاتنا الضرورية. ونحن جميعاً نعرف معنى الحرب التي أودت بالأبرياء، وشردت أسرهم، وضيعت ممتلكاتهم. ومع الوقت كبرت معاناتنا، وفقدنا سنة بعد سنة كل سند. أذكر جدي لأمي أحمد عبدالله خان، الذي كرَّس وقته وجهده للبحث عن صهره الرائد صالح مقبل صالح المقبلي. بعد عامين من الاختفاء القسري لأبي، تنقل جدي بين المحافظات بحثاً عنه. ثم غادر إلى الخليج لاحقاً. أملاً في الحصول على أية بيانات من زملاء والدي المنفيين هناك وفي نهاية 2000، وكنت حينها أدرس الصف السادس، سافرنا جميعاً، أمي وشقيقاي وأنا، رفقة جدي إلى أبو ظبي، بحثاً عن خيط يوصلنا إلى مصير أبي. والآن فإننا وحيدون نكدح لنحيا، بعدما توفي جدي، رحمه الله، قبل عام ونصف. وكانت جدتي قد سبقته إلى الدار الآخرة قبل عامين.لم أعرف جداي لأبي قط. مات جدي عندما كان والدي في ال12 من العمر، أما جدتي فقد ماتت بعيد ميلاد نيفين. لا أعرف بدقة تواريخ وفاة أجدادي، ولكنني تخصصت، كما والدتي ونيفين وعلي، في التنقيب وراء سيرة أبي الرائد صالح المقبلي الذي حُررت بإسمه شهادة وفاة صادرة من الأحوال المدنية بمديرية صيرة -عدن في 9 يونيو 1997 تفيد بأنه توفى 24 يونيو 1994 في مدينة صلاح الدين بمديرية الشعب -محافظة عدن.
في الوثائق الرسمية تحول تاريخ مغادرة والدي لمنزل جدتي في المعلا إلى تاريخ وفاة، لكننا، أمي ونيفين وعلي وأنا، ما زلنا بعد مضي 13 عاماً على الحرب، نتطلع لمعرفة ماذا حصل بالضبط بعد مساء 24 يونيو 1994، ذلك اليوم الذي صار تاريخ وفاته في وثائق وزارة الدفاع ومصلحة الأحوال المدنية.
وإذا كان حقاً مات فإن على الجهات المختصة في الدولة أن تتكرم علينا بالكشف عن قبره ليتسنى لنا زيارته وقراءة الفاتحة على روحه.
***
زوجته تطالب بلجنة تحقيق تكشف عن مصيره
محمد ناجي سعيد يخضع لجلسة استجواب منذ 21 عاماً!
 الاسم: محمد ناجي سعيد.
الاسم: محمد ناجي سعيد.الحالة الاجتماعية: متزوج وله ابنة.
الميلاد: 12/ 12/ 1952 م. مدينة دار سعد محافظة عدن.
العمل: رئيساً للمجلس المركزي لطلاب اليمن.
أخذوه عصريوم الخميس بتاريخ 23 يناير 1986م (بعد أحداث 13 يناير الدامية بعشر أيام) وبشكل قسري من منزل ابنة خاله في مدينة المنصورة بعدن، من قبل جيش جرار من "الطيبين" من ضمنهم أحد رفاقه (إسمه معروف) والذي تعهد بتسليمه ومن معه إلى جهة ستحرص عليه وسيتم إعادته بعد استجوابه عن موقفه من تلك الأحداث. ودار هذا الحديث أمامي وأمام بعض أفراد أسرته. ولكن منذ ذلك اليوم لم يعد زوجي ولم نسمع عنه.. كانت ابنته آزال آنذاك في الخامسة من عمرها.
لم نستلم أية إعانات بعد اختفائه كغيره من المفقودين في ذات الفترة، رغم أن لديه أماً عجوزاً كان يرعاها ويعولها إلى جانب زوجته وابنته.
ما زلت أتذكر ما كان يرتدي في ذلك اليوم وتلك الليلة المشؤومة، فقد كان أنيقاً يهتم بهندامه، وكان مهذباً في تعامله مع الآخرين يشهد على ذلك كل من يعرفه، ويتميز بدماثة الأخلاق وبثقافته العالية وبقراءاته الواسعة.
تخرجت ابنته من جامعة عدن عام 2002م بشهادة بكالوريوس، تخصص انجليزي – فرنسي من كلية التربية. وحتى اللحظة لم تحظ بأية وظيفة حكومية.. ولا زلنا ننتظر. علماً بأننا لم نستلم أية إعانات أو مستحقات منذ غيابه القسري. رغم أن هناك أسر شهداء عاشوا نفس المعاناة إلا أنهم يستلمون رواتب شهرية بانتظام وإعانات مختلفة كالعلاج والسفر وغيرها، وكأننا خارقون لا نمرض ولا نحتاج ولا.... هل لأن زوجي ليست له قبيلة ولا ينتمي لعشيرة؟؟؟
أطالب:
- بمعرفة مصير زوجي من خلال تشكيل لجنة دولية للتحقيق والتحري ومن ثم إصدار الحكم على من أجرم في حقه باعتباره كان عضواً في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني الحاكم في جنوب الوطن آنذاك.
- بإعادة الاعتبار لنا من خلال محاكمة الجناة.
- بإعادة كل مستحقاتنا المادية ومن ضمنها رواتبه منذ العام 1986 م.
وأخيراً بالتعويض المستحق عن عذاباتنا المستمرة منذ أكثر من عقدين.
- ألطاف محمد عبدالله
***
المختفون قسرياً(3)
 المربية الفاضلة ليلى أحمد غلام ما تزال بعد 13 عاماً تتساءل: أين ابن أخي؟
المربية الفاضلة ليلى أحمد غلام ما تزال بعد 13 عاماً تتساءل: أين ابن أخي؟علي.. الذي خرج للبقالة... ولم يعد
- نادرة عبدالقدوس
nadra
علي يوسف أحمد غلام، من مواليد 4/7/1968 مدينة كريتر – عدن. كان في السادسة والعشرين من عمره حين خرج من بيته لشراء شيءٍ ما... ولم يعد!!
كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصراً أو ما دون ذلك يوم 26 يونيو عام 1994م: العام المشؤوم الذي أحرق فيه الزرع والضرع وقُتل فيه الأبرياء من عامة الشعب دون أي ذنب اقترفوه، وحتى اللحظة لم يتمكنوا من فك طلاسم سر اللعبة السياسية. ناشدته أمه ألا يخرج لأن الأوضاع يلفها الغموض، ولا زال دوي مدافع الهاون يُسمع صداها من أماكن غير بعيدة، لكنه هدأ من روعها بمنتهى اللطف واستأذنها بالخروج إلى البقالة لشراء بعض الأغراض.
تقول أمه التي كانت محاولاتها تبوء بالفشل لتداري دموعها وهي تروي لي حكاية الابن الذكر الذي دعت ربها ليل نهار بأن يهبها وزوجها إياه وسط أربع بنات، فجاء بعد 8 سنوات من الانتظار: " يومها كانت يده مجروحة (بسبب) سقوطه من سيارة أخذته مع مجموعة لحراسة مكتب المحافظ أثناء الحرب، وملفوفة بقماش أبيض. قلت له يدك مجروحة خليك هنا يابني، لا تخرج شوف الدنيا مش أمان، أترجيته رجاء لكنه، الله يرحمه، إذا كان حي أو ميت، رفض يسمعني وقال لي يا أماه البقالة بالحافة مش بعيدة، دقيقة وراجع لكم، خرج وما عادش لنا"، (أجهشت بالبكاء).
يا ترى كم شاب مثل علي خرج ولم يعد؟! وكأنما هناك أشباح متربصة للحوم البشرية ما إن تشم رائحتها حتى تقوم باختطافه بلمح البصر دون أن تترك بصمات أو آثار يمكن اقتفاؤها!!
ألقى "أبو علي" جسده النحيل المتعَب على أرض الغرفة الصغيرة ليأخذ مكاناً بجانب بناته اللائي حضرن لقائي بالأسرة في منزلها. قرأت في عينيه الناظرتين إليً سؤالاً، كأن، ينتظر مني جواباً شافياً له.. فهو الأب الذي ربى ابنه، ككل أب شرقي، ليصبح الرجل الثاني في الأسرة يحمل اسمه ويحمي أخواته الأربع استحضر ابنه: " كان شاباً حيوياً، شجاعاً، ذكياً، محباً للحياة وللعلم، كان ينتظر الالتحاق بالجامعة بعد الثانوية العامة قسم علمي، لكنه لم يفلح، ولم يفلح كذلك في الحصول على وظيفة! ". وأضاف بنبرة حزينة: " لم أكن موجوداً في البلاد أثناء الحرب، إذ كنت في عمل خارج الوطن.. كنت في الماضي أشغل منصباً قيادياً في اليمدا، كنت مديراً لمكاتبها في دول عدة، وقد أُحلت على المعاش عام 2000م.. "، توقف الأب عن الحديث. هكذا يتلاشى أصحاب الضمائر الحية، سيتقلص عدد هؤلاء الناس. مسكين أبو علي لم تشفع له وظيفته القيادية ولا ثقافته ولا تعليمه العالي من توظيف ابنه. ولم تشفع الوظيفة السابقة في وزارة الاتصالات للأم الثكلى التي بسبب مرضها تركتها عام 1989م وكانت تشغل حينها منصب مديرة الاتصالات الدولية... في حين يتوارث اليوم الأبناء الآباء في وظائفهم ومواقعهم المختلفة في مفاصل الدولة والحكومة دون مؤهل يحملونه أو كفاءة. آه يا قدرنا في هذا الوطن المغلوب على أمره!! ويا تعاسة المواطنين البسطاء الغرباء فيه!! وهاهم يقدمون فلذات أكبادهم قرابين له.
***
الأستاذة ليلى أحمد غلام، وهي مربية فاضلة أحيلت إلى التقاعد بعد 35 عاماً في سلك التدريس وإدارة عديد من المدارس في محافظة عدن (كانت معلمتي في المرحلة الإعدادية، وقد فوجئت حين زرت عائلة "علي" بأنها عمته) تمسك بطرف الخيط، الذي ربما يمسك طرفه الآخر من يملك الإجابة على سؤال أسرة علي عن مصير ابنها. روت لي الأستاذة ليلى تفاصيل بحثها عن ابن أخيها الذي بدأته بعد هدوء لعلعة الرصاص وجنون مدافع الهاون التي كانت تُقذف هنا وهناك في عدن وضواحيها من قبل أناس خُدعوا بفتوى تكفر أخوتهم في الدين والملة والأرض والتاريخ واللغة والدم والعرق و.. و..: ". بعد الحرب بدأنا بالسؤال عن علي الذي خرج ولم يعد. شهود عيان أكدوا لنا أنه أُخذ بالقوة مع مجموعة فوق سيارة كبيرة إلى جهة غير معروفة، ثم علمنا أنه أُخذ مع المجموعة إلى معسكر هواري بومدين في منطقة صبر (إحدى ضواحي عدن).. وذهبنا إلى هناك، ولكنهم في المعسكر أخبرونا أنهم لا يعرفوا شيئاً عنه وأنه خرج مع كل المحتجزين ولم يعد في المعسكر أي منهم. ولكن شهود عيان كانوا من ضمن المعتقلين هناك أفادوا بأنه في فجر أحد الأيام قامت مجموعة من الملتحين بأخذ علي مع خمسة آخرين كانوا في المعتقل بعد أن عصبوا عيونهم وربطوا أياديهم إلى الخلف، ولم يظهر بعدها هو والمجموعة!!! ". عمة علي قائلة: " علمنا أن واحداً اسمه عبد الولي الشميري كان المسؤول عن معسكر صبر هاديك الأيام.. رحنا له بعد أن سألنا عن بيته، لكنه قال لنا إن كل المجاميع اللي كانت عنده في المعسكر أُطلقوا.. وعدنا إلى عدن بعدها عرفنا أن الإصلاحيين هم اللي أخذوه. رحنا لأمين عام الإصلاح اليدومي، ولكنه أنكر معرفته بعلي وبمصير علي، وأكد أن كل المعتقلين اللي كانوا عند حزب الإصلاح أُفرج عنهم... طيب فين ابن أخي؟؟ إذا الكل يقول بأنهم أطلقوا سراح المعتقلين!! وفين البقية اللي كانوا مع ابن أخي؟؟ هم كمان مختفيين!! ". هكذا سألت عمة علي المختفي قسراً. أين هو؟ وطالبت بأن يتم الكشف عن المتواطئين في جريمة اختطاف ابن أخيها والكشف فوراً عن مصيره.
سؤال يردده اليوم كثير من الثكالى والمكلومين واليتامى والأرامل... ولا يسمع غير صداه في زواياك ياوطني، الذي باسمك يُستباح فيه القتل نهاراً جهاراً على ترابك الطاهر... وباسمك تُلقى الأحكام جزافاً على الضعفاء، ويحق أيضاً أن تُرمى لحومهم للكلاب الضالة.. وباسمك يموت هابيل كل يوم.. وباسمك يعيش قارون على أشلائك حتى اليوم. لكلٍ طقوسه في التعبير عن حبه لك حتى تاهت مقاييس الحب، وتبعثرت مشاعرنا في زحمة الاقتتال من أجل تقبيلك، فماتت رعشتنا في مفترق الطريق.
***
المختفون قسرياً(4)
منذ ربع قرن: طباخ ماهر في ضيافة الأمن الوطني
سامي غالب
Hide Mail
غداة قيام الوحدة انتعشت آمال أسرة علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم، المعتقل السياسي منذ 1983. وقد وجه فتحي النجل الثاني لعلي، خطاباً إلى رئيس مجلس النواب حينها ياسين سعيد نعمان، يطلب فيه مساعدته في وضع حد لانتظارات أسرته، قال فيه: «إني وأخوتي على ثقة بأننا سنلتقي والدنا في ظل الجمهورية اليمنية».
قبل أسبوعين زار فتحي، 36 عاماً، مكتب «النداء»، مبدياً حرصه على نشر قصة أبيه في الذكرى ال17 لقيام دولة الوحدة.
كانت توقعاته «الوحدوية» قد خابت، وأراد إبلاغ الرسالة أدناه إلى من يهمه الأمر.
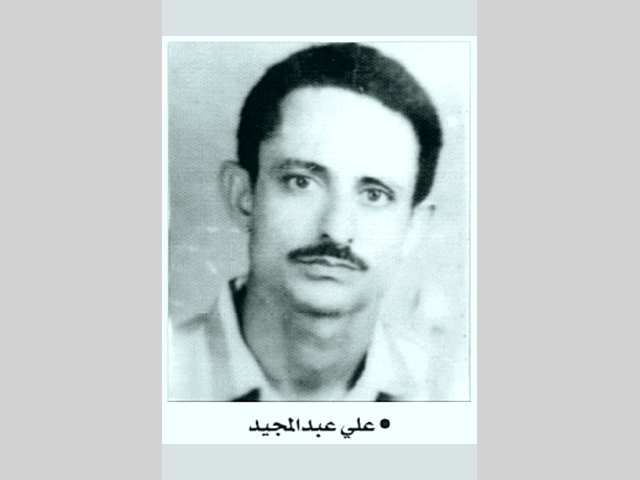
عدم الاعتراف المتبادل
في الثانية بعد منتصف ليل 11 فبراير 1983، دهمت مجموعة أمنية منزل علي عبدالله حاشد الكائن في منطقة حدة (غير بعيد من مبنى جهاز الأمن الوطني). واعتقلت صاحب المنزل وصهريه علي وأحمد عبدالمجيد.
في مبنى الأمن الوطني (السياسي حالياً)، تم عرض الأخوين علي وأحمد على معتقلين آخرين لغرض إدانتها بالإنتماء إلى الحزب الديمقراطي الثوري. بعد ساعات نقل أحمد إلى سجن دار البشاير (البونية)، وأفرج عن علي عبدالله حاشد.
أبقى رجال الأمن الوطني على علي عبدالمجيد في ضيافتهم.
طبق شهود عيان وضيوف كرام آخرين في سجن الامن الوطني خلال الفترة ذاتها، فإن علي عبدالمجيد كان عرضة لتعذيب رهيب. رفض الإدلاء بأية معلومات عن نشاطه الحزبي، رغم أن آخرين أدلوا بمعلومات عنه.
 كانت حصص التعذيب متقاربة وفظيعة لكنه هو المفتول الذي حضِّر نفسه جيداً للتجربة، على ما يقول أخوه أحمد ونجله الأكبر طارق، لم ينهر أمام معذبيه، رفض الاعتراف بزملائه (وبعضهم ما يزال يحمل له الجميل حتى اللحظة).
كانت حصص التعذيب متقاربة وفظيعة لكنه هو المفتول الذي حضِّر نفسه جيداً للتجربة، على ما يقول أخوه أحمد ونجله الأكبر طارق، لم ينهر أمام معذبيه، رفض الاعتراف بزملائه (وبعضهم ما يزال يحمل له الجميل حتى اللحظة).ومنذ تلك الليالي المستذئبة يرفض المسؤولون في جهاز الأمن الوطني الاعتراف بوجود علي في حوزتهم، أو تقديم أية معلومات عن مصيره. وما زالوا يبادولنه عدم الاعتراف!
<<<
سندباد يمني
من شهادات عديدين تأخذ شخصية علي عبدالمجيد ملمحاً أسطورياً.
ولد علي في قرية الأشاوز الأعبوس عام 1942. وكما مواليد ذاك الزمان فقد غادر قريته إلى عدن مبكراً. وتالياً لحق به شقيقاه اللذان يصغرانه أحمد و محمد. في عدن برز الفتى في مجال الطباخة، حيث تنقل بين عدة أماكن، قبل أن يشيِّد عالمه ارتكازاً على تمكنه في فنون الطبخ أثناء عمله في فندق الصخرة بالتواهي - عدن.
وفي منتصف الستينيات كانت عدن تضج بالحركة التجارية والسياحية، ولكن أيضاً بالحركات الثورية. وعلى الأرجح فإن علي كان قد انتمى إلى حركة القوميين العرب التي كانت التنظيم الحاكم داخل الجبهة القومية.
في تلك الفترة تحديداً ولد طارق النجل الأكبر لعلي من زوجته الأولى، التي انفصل عنها بعد فترة وجيزة.
تزوج علي نهاية الستينيات من منى عبده حسن. ومطلع السبعينيات، وكان ما يزال مقيماً في عدن، رزق بمولوده الثاني فتحي، ثم فتحية ووائلة وشفيع.
علي، الذي كان قد أسس لاسمه شهرة في مجال الطبخ، غادر عدن عام 1974، باتجاه صنعاء. وفي فندق مدينة سام، الذي كان ذائع الصيت وقتها، عمل إلي جانب رئيس الطباخين ذي الهوية الفرنسية. تالياً كان علي يشغل عن استحقاق موقع رئيس الطباخين بعد مغادرة الخبير الفرنسي!
<<<
 رغم شهرته كطبَّاخ لا يجارى في أهم فنادق العاصمة، فقد اختار أن يبني مشروعه الخاص. فدخل في شراكة مع شخص آخر، مؤسساً مطعم السندباد.
رغم شهرته كطبَّاخ لا يجارى في أهم فنادق العاصمة، فقد اختار أن يبني مشروعه الخاص. فدخل في شراكة مع شخص آخر، مؤسساً مطعم السندباد.كان السندباد علي عبدالمجيد المنحدر من أسرة فلاحية في ريف تعز، وهو يواصل رحلته الشاقة، ولكن الشائقة في صنعاء، يستثمر خبرته العدنية باقتدار. في عدن تعلم فنون الطباخة التي تتطلبها مدينة كوزموبولوتية ضاجة بالحياة والأفكار... والبشر أيضاً. وإلى الطباخة تعلم كيف يتعلم!
قبل أن تحل ساعة الشؤم في ليل شباطي مجدب، كان لدى علي الذي اجتاز للتو، خط الأربعين سنة، مشاريع لم تكتمل، فالمشروع الذي أراده إنجاز حياة، كان يتعثر بسبب خلافات مع الشريك، ثم مع المؤجرين.
وفي الأثناء كان يحاول تحسين معارفه في اللغة الانجليزية التي حملها من عدن. وأبعد من ذلك فإن الرجل العصامي الذي حرم في طفولته من فرصة الالتحاق بالمدرسة كان يخطط لإكمال دراسته الثانوية، بعد أن أكمل المرحلة الإعدادية.
بعدسة مجمعة، كان السندباد الناشط في الحزب الديمقراطي الثوري (الوريث التنظيمي لفرع القوميين العرب في الشمال) في اللحظة الحرجة مطلع الثمانينات، فالمطعم مغلق بسبب الخلافات مع الشريك والمؤجرين، والقبضة الأمنية تشتد ضد المعارضين، وبخاصة اليساريين منهم. وعلى ما يبدو فإن جهاز الأمن الوطني استطاع أن يحقق اختراقات داخل صفوف معارضيه العتيدين. وكان الحزب الديمقراطي الثوري ينكشف للمرة الأولى أمنياً، رغم سجله المشهود بالقدرة التنظيمية فائقة الدقة. وطبق تفسير أحد رفاق علي، فقد وقع الاختراق جراء تشكيل حزب الوحدة الشعبية من عدة فصائل يسارية في الشمال، أبرزها الديمقراطي الثوري.
حالة حصار
كانت رحلة «السندباد» توشك على الانتهاء قسرياً.
كان أحمد الشقيق الأصغر لعلي، قد أمضى في السجن 8 أشهر بشبهة الانتماء للحزب ذاته. وقد أطلق سراحه في ديسمبر 1982. لكنه ظل موضع رقابة أمنية. وفي مطلع فبراير 1983 طلب ضباط أمنيون من أحمد ملازمة منزل صهره (زوج أخته) علي عبدالله حاشد القريب من مبنى الأمن الوطني، كان الأمن يراقب الجيران ليل نهار. وقد أبلغ أحمد وصهره علي بأنهما تحت الإقامة الجبرية، وليس من حقهما مغادرة المنزل لأي سبب.
كان علي عبدالله حاشد، ميسور الحال بمقاييس ذلك الزمان. وكان منزله، موضع وجهة أهل منطقته، الأقربين منهم والأبعدين. وقد كان على محمد مرشد ناجي وزوجته أن يدفعا ثمن جهلهما بالقونين العرفية لجهاز الأمن الوطني، إذ قاما بزيارة المنزل مساء أحد أيام الحصار لأسباب اجتماعية. وعند مغادرتهما توجب عليهما مرافقة المحاصرين لغرض استجوابهما في مقر مجاور. بعد استنطاقهما غادر محمد مرشد ناجي (صاحب استديو تصوير في شارع العدل) وزوجته مكتب التحقيق بسلام!
كان الحصار الأمني مضروباً على المنزل، وتم فصل خدمة الهاتف عنه، وانتظر رجال الأمن الزائرين المفترضين.
في التاسعة من مساء 11 فبراير طرق الباب علي عبدالمجيد، كان على الأغلب، قد علم بانكشاف اسمه لرجال الأمن. بدا وكأنه هارب من ملاحقيه. في الثانية بعد منتصف الليل اقتادت مجموعة أمنية الرجال الثلاثة إلى مبنى الأمن الوطني.
«أخذونا بعد أن عصبوا أعيننا، كل واحد في سيارة»، قال لـ«النداء» أحمد عبدالمجيد (المولود عام 1954). أضاف: «عرضونا على مجموعة من المعتقلين للتعرف علينا، في نفس الليلة نقلوني إلى دار البشاير (السجن الشهير في البونية)، وأطلقوا سراح علي حاشد، وأبقوا علي عندهم».
بعد شهر من واقعة الاعتقال، تم الافراج عن أحمد عبدالمجيد. وبعد 24 سنة ما يزال أحمد يتذكر تفاصيل «ساعة الشؤم» التي حلت بأسرة كاملة.
وكان علي الذي لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً بمثابة المعلم لأخيه الأصغر.
وطبق أحمد، فإن الأخ الأكبر غير المتعلم، «كان متطلعاً ويقرأ جيداً لتثقيف نفسه، ويدرس الانجليزية، ويواصل دراسته الثانوية». «كان معلمي، وهو الذي استقطبني للحزب (الديمقراطي الثوري)، وأحياناً كان يخشى عليَّ من الخطر». بنبرة مشبوبة بالحب يتذكر ساعة مازحه علي، بعد أن أفرج الأمن عنه في حملة اعتقالات سابقة. داعب علي أخاه الأصغر الخارج لتوه من المعتقل: «مسكوا العكابر... والعراري ماقدرولهمش».
الهروب إلى عدن!
بعد 8 أشهر من حملة فبراير 1983، بدأ الأمن بالإفراج عن بعض المعتقلين، لكن علي لم يغادر قط مبنى الأمن السياسي، وقد علم أحمد من معتقلين أفرج عنهم من سجن الأمن السياسي بأن علي تعرض لتعذيب منهجي وقاس جراء رفضه الإدلاء بأية معلومات عن رفاقه.
أفاد أحد المفرج عنهم بأن رئيس الطباخين تأذى من التعذيب في مناطق عدة في جسده، وبخاصة إحدى عينيه.
بعد مضي سنوات على واقعة الاعتقال، التقى أحمد بالصدفة، مسؤولاً رفيعاً في الأمن الوطني كان ذا صلة بالملف. وقد ابتدره بالسؤال عن مصير علي، فأجاب رجل الأمن المحترف ببرود: لقد هرب إلى عدن!
لم يغادر السندباد السجن قط. في عالم المجاز فقط يمكن اعتبار المسؤول الأمني المحترف صادقاً، فمن المرجح أن «السندباد» سافر إلى عدن مراراً بعد اعتقاله: سافر إلى أيامه الخضر هناك، إلى الفتى الباهر الذي كانه، إلى الفردوس التي أرادها على الأرض، وإلى الفردوس التي كانت عنوان خلاصه في السماء.
حامل الراية.. والأثقال
«أنا متُ قبل 24 سنة»، يقول فتحي في معرض تفسير أسباب عدم خوفه من إمكانية تعرضه للخطر جراء مثابرته على استرداد أبيه.

ما من شك في أنه حي. رجل في ال 36 يقف في كبرياء راكناً إلى عمود انتظمت فقراته من الحب والكدح والألم والولاء.
في 11 فبراير 1983 كان في الثانية عشرة من عمره. مذَّاك بدأ الإبن البكر لمنى بمغادرة البيت في القرية لسببين: العلم والعمل.
بعد 5 سنوات كان قد أكمل الإعدادية، وانتقل إلى العاصمة باحثاً عن أب... ووظيفة.
وجد وظيفة في وزارة المواصلات، وما يزال يجهد في البحث عن أبيه.
بعد أسابيع من انتقاله إلى صنعاء، حرَّر فتحي مذكرة إلى رئيس الجمهورية باعتباره -حسب نص المذكرة- المسؤول الأول والأخير عن (أمن) المواطن، طالب فيها الرئيس بالسماح له بزيارة أبيه المختطف من قبل الأمن الوطني، أو إطلاق سراحه. وإذ شدَّد على أن ما وقع لأبيه هو محض اختطاف أمني، ذكَّر الرئيس القائد بالله الجبار المتكبر المنتقم.
تحمل فتحي باكراً مهمة ملء حيز من الدور الشاغر. صار رجلاً قبل الآوان، لكنه لم يترجل قط. وقد تأكدت «النداء» من مصادر عديدة بأنه أضطلع بالمهمة المستحيلة منذ 1988.
كان أخوه الكبير (طارق) قد غادر إلى الصين، وكان رفاق أبيه الكبار مطاردين في كل مكان، وكان قدره أن يحمل الرأية و حده.
 تجاوب الرئيس علي عبدالله صالح مع مذكرة الفتى الطالع من صلب أبيه. وفي 1989 صدرت مذكرة مذيلة بتوقيع الرئيس تطلب من رئيس جهاز الأمن الوطني «الاطلاع على شكوى أولاد علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم العبسي،والإيضاح عن ذلك».
تجاوب الرئيس علي عبدالله صالح مع مذكرة الفتى الطالع من صلب أبيه. وفي 1989 صدرت مذكرة مذيلة بتوقيع الرئيس تطلب من رئيس جهاز الأمن الوطني «الاطلاع على شكوى أولاد علي عبدالمجيد عبدالقادر أنعم العبسي،والإيضاح عن ذلك».طبق إفادة فتحي فإن مدير مكتب الرئيس امتنع عن وضع الختم على توقيع الرئيس.
لكن المدير وجه مذكرة في 26 نوفمبر 1989 إلى العقيد غالب القمش، يطلب فيها «الإطلاع على مذكرة فتحي بخصوص اختفاء والده، والتوجيه بما ترونه».
كانت المذكرات المتبادلة بين الرئاسة والجهاز تتم عبر قنوات سرية، لكن الباحث المتشوق لأبيه لم يعدم وسيلة للحصول على نسخ منها. وكان ظاهراً في المذكرات الرسمية نية المتورطين في إطالة أمد البحث، إذ تعمدوا دوماً استخدام مفردة اختفاء، عوض «اعتقال» التي يعتمدها دوماً «رب الأسرة» الصغير.
وقد علم فتحي في وقت لاحق من عام 1990، أن مكتب الرئاسة حرر مذكرة تعقيبية أخرى موجهة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني. كانت مجرد مذكرات!
لم يعرف اليأس طريقاً إلى قلب الفتى وفي 31 يناير 1990، تمكن من استصدار مذكرة من النائب العام علي محمد اليناعي، موجهة إلى رئيس جهاز الأمن الوطني، جاء فيها:
بخصوص شكوى أولاد المدعو علي عبدالمجيد (...) والتي مفادها بأنه قد اختفى في عام 1983، ولم يعرف عن مصيره شيء (...) وعليه نأمل الإطلاع والإفادة إذا لديكم أي معلومات».
قال لـ«النداء»: ذهبت مذكرة النائب العام بقناة رسمية، وقد تابعت مكتب النائب العام وقيادة الجهاز، ولم يكن هناك أي رد»، ثم أردف ممتعضاً: «كانت مجرد مذكرة لشراء سكوتك».
قبل أسابيع من قيام الوحدة، بلغ الشاب فتحي أن جار الله عمر وقياديين آخرين من الحزب الديمقراطي، موجودون ضمن وفد في فندق رمادة حدة. سارع إلى الفندق حاملاً ملف أبيه: «أستمع جار الله لقضيتي، وعرضت عليه وثائق ومذكرات، ووعدني بطرح الموضوع في اللقاءات التي ستتم في قيادات عليا». استعاد مشهد اللقاء بالقيادي الاشتراكي اللامع.
صباح اليوم الذي ألقى فيه علي سالم البيض خطابه الشهير في ميدان السبعين قبل الوحدة، قرَّر فتحي المجازفة، وحمل نسخة من مذكرة الرئيس، وطرق باب عبدالله محرم المسؤول البارز في جهاز الأمن الوطني. دلف إلى حوش «منزل محرم»، وتقدم من الرجل الذي كان يستعد لطلوع سيارته، فتح ذراعه ليسلمه المذكرة الرئاسية.
لم يخف محرم إنزعاجه. وبحسب فتحي، فإنه «هتر (انتزع) المذكرة من يدي، ثم نهرني بشدة قائلاً: ما هوش عندنا».
قبل أن تنطلق سيارة المسؤول الأمني، قرر فتحي أن يضع اللمسة الأخيرة على المشهد، فأطلق صيحة مغموسة بمرارات سنين: «لكنه معتقل عندكم»، غادرت السيارة مسرعة» باتجاه ميدان السبعين حيث سيلقي قادة الوحدة الموعودة خطابات على الجماهير الغفيرة... الغفورة!
<<<
«تفاءلنا بقيام الوحدة»، زفر فتحي الذي استنزفت سنوات الوحدة ال17 رصيده من التفاؤل.
أعلنوا عهد التسامح والوئام وإغلاق ملفات الماضي -تحدث دون حماسة- صدَّقنا وقلنا موضوع أبونا إنساني. وزاد: بعد الوحدة أُفرج عن معتقل من نفس الفترة إسمه علي نعمان، لكن أبي لم يخرج. ذهبت إلى علي نعمان وسألته عن أبي، فأفاد بأنه في فترة التحقيقات كان يتواصل مع أبي عبر إطلاق أصوات محددة، كما كان يسمح المحققين أو السجانين ينادون عليه بالإسم، لكن التواصل انقطع بعد قرابة 3 أشهر.
بعد سنة عرض حامل الراية، على ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب، قضية والده في مذكرة وقعها عن الأسرة الصابرة، أشار فيها إلى معاناة أسرته جراء تسويف واستعلاء الجهات الأمنية، وكتب: عندما كنا نتابع الأمن الوطني كانوا يفيدوننا بأنه غير موجود، ومرات يقولون إنه قد خرج منذ فترة و نزل يعمل في عدن (...) سئمنا من الاكاذيب، ونحن (الآن) على ثقة بأننا في ظل الجمهورية اليمنية سنلتقي بوالدنا». حرر المذكرة نيابة عن 8 من أفراد أسرته هم أخوة طارق (الكان يدرس في الصين) وشقيقه شفيع، وشقيقتاه فتحية ووائلة... وجداه (من أبيه) عبدالمجيد عبدالقادر، وحمامة دماج.
مات الجد عبدالمجيد بعد أشهر من تحرير المذكرة التي أحالها رئيس مجلس النواب إلى لجنة حقوق الإنسان للمتابعة. وبعد 4 سنوات ماتت الجدة حمامة.
وسائل شتى لجأ إليها فتحي «المتشائل»، وقد طرق قنوات متنوعة، ولاذ بوسطاء، وغالباً ما تم تجاهله، وأحياناً جاءه الرد يحمل نبرة وعيد من مغبة الاستمرار في «البحث عن طباخ ماهر»، لم يتذوق سجانوه أصنافه!
لكن الطفل الذي تذوق «كيكاً فاخراً باللوز والفستق»، ما يزال يتابع البحث عن مصير «الشيف» علي عبدالمجيد.
البحث عن مذاق كيك فريد
يعمل المهندس طارق في تعز، مشرفاً على مشاريع طرق. في جيبه يحمل آلة حاسبة، في غطائها الجلدي يحتفظ بصورة مثله الأعلى علي عبدالمجيد، الذي تعلم منه مهارة الطبخ، علاوة على أشياء أخرى.
في منزله المتواضع بمدينة تعز، يقيم طارق المولود عام 1964، مع زوجته وأطفاله. وإذ يشاهد برامج الطبخ على الفضائيات يغمره الحنين لصباحات صنعائية جميلة، كان فطوره فيها كيك مطعم باللوز والزبيب لم يذق مثله قط منذ اعتقال الطباخ الاستثنائي الذي كان يعده له.

لا أحد يجاري أبي في فنون الطبخ، يقول طارق بلغة قاطعة. «كان يتقن إعداد كل صنوف الطعام، بما في ذلك الحلويات». أضاف قبل أن يضرب مثلاً: «بعض الفنادق التي عمل فيها اشتهرت بسبب مطاعمها، كفندق الاسكندر في شارع القصر الجمهوري». الإبن الذي يحمل جينات أبيه وموهبته في الطبخ، يقدم مثلاً آخر: في طفولتنا، فتحي وأنا، أقمنا مع أبي في العاصمة، وقبل مغادرتنا إلى المدرسة كان يعد لنا قطعاً كبيرة من الكيك المطعم باللوز والزبيب» ويختم: «كلما خطر أبي على بالي أحن إلى الكيك الذي كان يعده لنا، والذي لم أذق مثله قط».
إلى الحنين والفقد والألم، تتواجد دوماً مشاعر الاعتزاز بالأب: «أتابع برامج الطبخ في الفضائيات، وأعتز بأبي، كان طباخاً من الدرجة الأولى، وحاز عديد من شهادات الخبرة والتكريم من فنادق وسفارات ومؤسسات محلية و خارجية».
في فندق مدينة سام عمل علي عبدالمجيد رفقة رئيس الطباخين (الشيف الفرنسي). ويقول طارق: كان الشيف الفرنسي الذي يعمل براتب 6000 دولار، يستعين بالكتب لإعداد أطباق معينة، خلاف الوالد الذي لم يكن يحتاج لأي كتاب بحكم مهارته وخبرته».
إلى فنون الطبخ، تعلم طارق، الذي كبر في كنف أبيه، دروساً غزيرة أثناء ملازمته أبيه: «علمني حب القراءة». وزاد: «كانت ثقافته غزيرة، وكنت إذ أقرأ كتباً فكرية بحوزته، يبادر إلى توضيح ما يصعب عليَّ فهمه من أفكار».
ولد طارق عام 1964، وانتقل طفلاً إلى عدن للعيش في كنف والده الذي كان قد انفصل عن زوجته الأولى (والدة طارق). في منتصف السبعينيات قرَّر والده الانتقال إلى عاصمة الشمال. وكان على طارق أن يكمل الصف الرابع الابتدائي في مدرسة الميناء بالتواهي بعدما رتب الأب مكان إقامة لإبنه البكر في منزل أسرة صديق من بني حماد يقطن التواهي. بعد الموسم الدراسي لحق طارق بأبيه إلى «شمال الوطن»، ولكن إلى قرية الأشاوز، وهناك أكمل دراسته الابتدائية والصفين الأول والثاني الإعدادي. في 1978، انتقل الفتى إلى العاصمة، والتحق بإحدى مدارس العاصمة لإكمال المرحلة الإعدادية. لم يكن وحده، فقد طلع رفقة أخيه فتحي الذي تم تسجيله في المدرسة الأهلية بصنعاء كطالب في الصف الثاني ابتدائي.
استأجر علي الذي كان في أوج تألقه، بيتاً في الطبري. وصباح كل يوم كان يعد وجبة الصباح لولديه، وهي عبارة عن كيك لا مثيل لمذاقه، كما يؤكد طارق وفتحي، ثم يغادر بعدهما إلى مكان عمله.
تذوق طارق الكيك، ومع الكيك تذوق السياسة. وهو التحق بالمدرسة الفنية بعد إنهاء الإعدادية بتفوق.
كانت مشاريع الأب قد بدأت تنكشف للأخطار، وبخاصة مشروع العمر (المطعم)، دخل علي في خلاف مع مؤجري المطعم الكائن في شارع علي عبدالمغني أمام سينما بلقيس. وعلى الأرجح فإنه لم يرتح لطريقة شريكه في التعامل مع إيرادات المطعم.
وتوجب على طارق أن يساعد أباه الغارق في مشاكل العمل. وقد اضطر الابن أن يؤدي أحياناً دور أبيه في المطعم. «كنت أدير المطعم لوحدي»، يتذكر أيام المحنة، عندما تم حبس أبيه احتياطياً بسبب مشاكل المؤجرين. في صيف 1981، كنت أنام في المطعم «بينما والدي محبوساً في قسم شرطة».
شدَّد المؤجرون الضغط على طارق الفتى الأعزل من كل سلاح. وفي العاشرة من صباح أحد أيام المحنة، كان مجموعة من الرجال يدهمون المطعم. «أذكر تفاصيل تلك الساعة كأنما وقعت اليوم»، جَزَمَ طارق خلال اتصال هاتفي ممتد أجرته «النداء» معه الأحد قبل الماضي. «كانوا يشتوا يأخذوني، وكنت قد أعددت نفسي لمواجهة كهذه».
أضاف: «باستثناء عمال المطعم، فقد كنت وحيداً، وقد تواريت عبر باب المطبخ، وعلمت لاحقاً أنهم أغلقوا المطعم».
في تلك الأثناء خاض علي حربين في آن، حرب استرداد المطعم، وحرب تفادي الأجهزة الأمنية.
وكان طارق اللصيق بأبيه، يواصل التعلم منه: «علمني أبي أن أعطي الأولوية لدراستي». يستعيد وصايا مثله الأعلى: «كان يقول لي دائماً: الفاشلون في الدراسة هم الذين تستغرق السياسة حياتهم».
تعلم أيضاً فنوناً أخرى، ففي تلك السنوات كان كتاباً في الماركسية كفيلاً بقذف صاحبه في ثقب أمني أسود. «كان أبي يغلف كتبه المحرمة في قصدير، ثم يخبئها في جوانب فرن المطعم».
سهل على رئيس الطباخين إخفاء كتبه، لكنه لم يتمكن من كسب حربه الأخرى.
كان بساط الريح يقترب بصاحبه من الثقب الأسود.
ويتذكر طارق أحداث 11 فبراير 1983 جيداً: «طلب مني (ح. ع) وهو أحد رفاق أبي، أن التقيه أمام أحد المحلات الشهيرة في شارع الزبيري». «ذهبت في الموعد المحدد، ولم أجد رفيق أبي»، كان (ح. ع) قد وقع في قبضة رجال الأمن الوطني.
مساء اليوم نفسه ذهبت إلى بيت عمي علي عبدالله حاشد (زوج عمة طارق) كان الخطر يحيط بالبيت. «لم أدخل، بل خرج رجلاً متأبطاً مسدساً»، وقد أومأ إلي عمي بطلب المغادرة، وقد تجاهلوني لصغر سني».
بعد منتصف الليل اعتقل علي عبدالمجيد، وأخوه الأصغر أحمد عبدالمجيد، وزوج أخته علي عبدالله حاشد، وكانت تلك نقطة فاصلة في حياة طارق، بعدها كدح ليكمل تعليمه، وخبر محناً لا تحصى، واستطاع مرات عدة أن يجتاز مطبات أمنية، وتمكن قبل سفره إلى الصين عام 86، للدراسة الجامعية، أن يحقق ضربة مزدوجة ضد الأمن الوطني، إذ تحصل على شهادتي حسن سيرة وسلوك للغرض نفسه (السماح بالسفر من قبل الجهاز الأمني ذي المهابة والسطوة). ومعلوم أن السفر إلى الخارج للدراسة كان يقتضي الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك من الأمن.
تخرج طارق في 1992، وهو ينتقل بدواعي العمل بين عدة محافظات، حالياً يقيم مع زوجته وأطفاله في تعز. ولم ينس في تصريحاته لـ«النداء» أن يعبِّر عن امتنانه لخالته منى (زوجة أبيه): «لقد أحسنت تربية إخوتي»، قال معتزاً بها.
الإبن الذي يبحث عن سر أبيه، يحمل في جيبه آلة حاسبة، وإذ يفتح غلافها مرات عدة في اليوم، يعانق وجه أبيه، ومتى صادف طباخاً في فضائية، سافر عبر الزمان وراء مذاق كيك عزيز المنال لكنه لا يلبث أن يهوي في بئر حرمان لاقرار له، فإذا هو يتمتم: أشتي أعرف أيش مصيره؟
شراكة عمر مع الغياب!
بشرى العنسي
«راح عمرنا مع الغائبين»، قالت منى عبده حسن الزوجة التي أمضت حتى الآن نصف عمرها في انتظار شريك العمر.
منذ رمضان الفائت تقيم في العاصمة في منزل ولديها فتحي وشفيع، وذلك لغرض مداواة آلام في العمود الفقري.
«تعبت... تعبت.. من بعد ما ضاع»، قالت لـ«النداء» ساعة زارتها قبل أسبوعين. وخلال اللقاء كان يحيط بها شفيع وزوجته، وحفيدها سامي، وابنها البكر فتحي.
لم يكن تعبها طريقها إلى الراحة. كانت في الخامسة عشر عندما تزوجت من علي، ورزقت بطلفها الأول فتحي مطلع السبعينيات، ثم انجبت فتحية وشفيع ووائلة التي كانت في الثانية عندما ألقي القبض على أبيها.
اضطرت أن تعمل لتربي الجهال وتدرسهم.
«سجنوهم وما همش داريين أن بعدهم أسر». قالت هذه العبارة الحارقة بلغة محايدة، لكأنها تدين عصراً بأكمله. وهذه الإدانة المضمرة هي الوسيلة التعويضية لمقاومة الشر القابع في السجن وفي القصر.
كان فتحي في العاشرة، وقد اضطر للعمل في القرية باليومية، لمساعدة أمه، وكان على منى أن تعمل أيضاً. «كنت أشقي وأحجن وأصرب»، استعادت الأيام السود: «درستهم وربيتهم والحمد لله، لكن لو تدري كم تعبت!»، وأردفت: عشنا منتظرين ذلحين شيخرج، ذلحين شيخرج، ربيت ودرست، وانتظرت».
كبر الأولاد وتخرجوا وتزوجوا وبقي السؤال يلازم منى: «كل الذين اشتغلوا بالسياسة وسجنوا خرجوهم، إلا هو ما حناش داريين وينه».
***
رحلة قسرية إلى سقطرى!
فهمي السقاف
عبدالسلام عمر حسن، مهندس طيران، برتبة ملازم خريج الاتحاد السوفييتي (سابقاً)، شاب طموح علقت أسرته عليه آمال كبيرة مضافة إلى أحلامه وآماله الخاصة عليه السعي لتحقيقها.
لكن، ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، إذ لم تتح له فرصة، لتحقيق شيء مما يصبو إليه وما تصبو إليه أسرته؛ كان هناك من فتح أبواب الجحيم لتتطاير حمماً وشظايا وأزيز رصاص في ال13 من يناير 1986.
كان في عمله عندما بدأ الاقتتال. لم يكن يحمل سلاحاً، وذلك شيء عادي حينذاك في معظم وحدات القوات المسلحة في عدن، تجد ضباط وأفراد تلك الوحدات دون سلاح إلا المناط بهم أداء بعض الواجبات والمهام كالحراسة، فقط بعض كبار الضباط لديهم مسدسات.
غادر رفقة 4 من زملائه في العمل. حالما سنحت لهم فرصة غادروا معسكرهم عائدين لمنازلهم وأسرهم مدركين أن لا ناقة لهم ولا جمل فيما يحدث من قتال إذ لم يوزع عليهم أي من الفرقاء سلاح ليشاركوهم جنونهم الذي تلبسهم قبيل عدة أشهر ولم يسع أحد ممن كان يفترض فيهم أنهم مسؤولون لكبح جماح هذا الجنون الذي ترك ليتفاقم.
كان جل همهم أن يصلوا إلى منازلهم بسلام. مضوا في طريقهم حتى بلغوا جولة كالتكس، كانت كل جولات عدن وتقاطع طرقها نقاط تفتيش استخدمت منذ الطلقة الأولى.
أوقفوا، طُلب إليهم إبراز بطائق هوياتهم إذ كان الاعتقال حينها حسب الهوية. إذ لا يهم إن شاركت في القتال الدائر حينها من عدمه، المهم من أين أنت جغرافياً يُحدد مصيرك.
وهذا ما حدث لعبدالسلام وغيره كثر، كانوا خمسة -بحسب شاهد عيان اتصل بأسرة عبدالسلام- اقتادهم شخص يدعى «عبدالحميد» من جولة كالتكس إلى سجن المنصورة ليلبثوا فيه يوم أو بعض يوم، ويرحلوا إلى معتقل «مدرسة النجمة الحمراء» هناك اكتشف أحد السجانين أن من بين نزلاء المعتقل من يمت بصلة قرابة للمعتقل القادم «عبدالسلام».
وهكذا كان على عبدالسلام مواصلة رحلته القسرية ليصل إلى سجن الضالع (قصر الأمير شعفل).
مطلع فبراير 1986م وصل إلى منزل عبدالسلام شخص قادم من الضالع (أحد عناصر الأمن) ليبلغ والده بأنه رأى إبنه في سجن الضالع. طلب الأب من «فاعل الخير» أن يصطحبه معه ليزور إبنه ويطمئن عليه. رفض عرض والد عبدالسلام بحجة خوفه عليه من ان يُزج به في السجن إلى جوار إبنه، مقترحاً بأن تذهب الأم عوضاً عنه لسجن الضالع علّها تتمكن من زيارة ابنها، لأنها امرأة واحتمال زجها في السجن مستبعد جداً. رفض الأب المقترح خوفاً مما قد ينالها من عنت وإذلال.
لاحقاً أبلغ شخص متعاطف مع الأسرة، أم عبد السلام، بأن إبنها ومعتقلين آخرين واصلوا رحلتهم الاجبارية من الضالع إلى سجن المشاريع بعدن. ذهبت هي لزيارة قريب لها معتقل في سجن الفتح دقائق سُمح لها. وقبل نهاية الزيارة يتلقى قريبها ضربة بعقب بندقية حارسه على ظهره ليدخله زنزنته مرة اخرى، هناك عرفت أنه يمضي «عبدالسلام» في رحيله الاجباري إلى سجن الفتح الشهير قادماً إليه من سجن المشاريع. ويفيد شاهد عيان أسرة عبدالسلام بانه تم ترحيل مهندسي الطيران الارضيين والجويين وأيضاً الطيارين المعتقلين على متن زورق إلى جزيرة سقطرى. رحلة قسرية صوب المجهول حتى اللحظة: متى ينتهي هذا العبث بمصير انسان هذه البلاد. من حق هذه الأم معرفة مصير فلذة كبدها. إن كان على قيد الحياة أين هو؟! وإنْ كان صُفي جسدياً فمن يدل أمه على قبره؟
أسرة عبدالسلام تتسلم، بعد متابعات مضنية، من الدولة راتباً هو أقل من راتب جندي وهو الذي اختفى قسرياً برتبة ملازم أول.
***
اطفاله ينتظرون 13 عاماً:
ما زال باب منزل داوود مشرعاً
فضل مبارك
13 عاماً وما زال باب منزلهم مشرعاً على مصراعيه بانتظار طرقات الغائب الذي خرج في يونيو من العام 1994 ولم يعد حتى اللحظة أو يسمع كلمة عن أخباره.
طفلاه مروان وعبدالرحمن لم يطعما بعد الفرحة بكلمة «بابا» التي يتباهى بها أقرانهما في قرية الدرجاج بمحافظة أبين. وغابت عنهما فرحة انتظار الأب نهاية كل نهار، وهو يحمل لهما كيس الهدايا من سوق المدينة.
خلف مروان وعبدالرحمن تقف أم حزينه بقلب عصره الشوق لزوج غائب ما زال اريجه يفوح في ارجاء البيت، ولهفة مع كل طرقة باب لعل وعسى وبروح مهجوسة بالخوف على مستقبل اطفال لم يعد لهما في هذه الدنيا من شيء حتى فتات العيش بعد ان تم قطع راتبه واستثنائه من أية اعانة، هو الذي قضى جل عمره في خدمة الوطن الذي غيبته دهاليزه في ظرف اكثر غموضاً.
كان داوود محمد يحيى ينأى بنفسه عن مماحكات السياسة ويرفض الانجذاب خلف التنظيرات الضيقة التي لا ترى في الوطن سوى المصلحة الذاتية، حزبه هو الوطن اليمني ككل.. وعمله هو كل حياته. نذر نفسه لنحو ثلاثة عقود من الزمن في تربية الأجيال وتخرج على يديه آلاف من الطلاب في تلك المناطق النائية من جبال يافع التي جاء حظه الوظيفي ان يكون فيها ولم يتذمر، كان قانعاً. يشعر أن أداء رسالته في هذه المنطقة الى عافها ابناؤها ورفض العمل فيها كثيرون، تعد وساماً رفيعاً على صدره.
وعندما شكلت وزارتا الخدمة المدنية والمالية عام 92 لجاناً لصرف رواتب الموظفين كان داوود في حالة مرضية (نفسية بحسب افادات وتقارير طبية رسمية أصيب بها) لم تسمح له بمقابلة اللجنة آنذاك وبعد ها باسبوع أخذ في المتابعة ولكن صنعاء حبالها طويلة لم تشفع له. وداخ السبع دوخات دون ان يحظى لا بيلح الشام ولا عنب اليمن، سوى المذكرة تلو الاخرى. وتوجيه ينطح توجيه ما زاد حالته سوء وصحته تدهوراً وهو يرى نفسه عاجزاً عن تلبية أبسط طلبات معيشة اسرته.
وعندما قامت الحرب المجنونة بين الاخوة الأعداء في صيف 1994 خرج من منزله في قرية الدرجاج بمحافظة أبين.. ولم يعد حتى اللحظة.
ظروف أسرته المغلوبة على أمرها والتي تعاني شطف العيش لم تمكنها من البحث عنه سوى السؤال في نطاق محدود، دون جدوى. كما أن حالتها لم تسعفها لمتابعة الحصول على راتبه كحق مشروع.. نظراً لما تتطلبه المتابعة من جهد وترحال.
***
 الوزيرة المحاطة ب(9) مختفين من أُسرتها.. أي طريق تسلك؟
الوزيرة المحاطة ب(9) مختفين من أُسرتها.. أي طريق تسلك؟تفاصيل في الأعداد القادمة

أصداء..
بعد نشر الحلقة الأولى من هذا الملف، بث موقع «نيوزيمن»، بالاتفاق مع الصحيفة، مقتطفات منه. وكان الملف موضوع نقاش المنتدى الذي يوفره الموقع لمتصفحيه لإدارة نقاش حول القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام. فيما يلي عينة من الأصداء التي تولدت عن الملف.
< أذكر الأخوة في وزارة حقوق الإنسان إلى إنه وفقاً للإجراءات الدولية المتبعة للإبلاغ عن حالات الاختفاء إلى الأمم المتحدة، فأنة يحق لأية جهة أو أسرة أو حتى فرد أن يتقدم مرة وثانية وثالثة.. الخ للنظر في حالة اختفاء معينه.. هذا يعني إن الحالات التي استبشرت الوزارة بإغلاقها واعتبرت ذلك انتصارا تحقق بجهدا جهيد.. تلك الحالات يحق لها أن تفتح من جديد بتقديم رسالة لا تتعدى الثلاثة أسطر. لذلك فإن الحل لا يكمن في إغلاق الملفات، بل علينا أن نعمل على إيجاد الحلول و لكل حالة على حدة.. وفقاً لما تنص عليه قوانيننا الوطنية و أخلاقياتنا الإنسانية والمعايير الدولية ذات الصلة بهذه الحالات، ومبادئ العدالة والإنصاف.. وباتفاق الثلاثة الأطراف " الحكومة، أسر المفقودين، والأمم المتحدة ". بهذه الطريقة فقط نضمن بان تغلق الحالات وتطوى الملفات وأن لا تفتح من جديد. وهنا سيرتفع رصيد بلادنا أمام الدول في حرص حكومتنا على مصالح مواطنيها وفي رايتها لحقوقهم ورفع المظالم عنهم وإحقاق الحق لصاحبه. حينها ستنعم بلادنا بسمعة حسنة.. يمكن أن تستفيد منها للترشح إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان.
محامي أسر المفقودين*
< أشكر الأخوة في صحيفة النداء على تبنيهم لهذا الملف الحقوقي الشائك والبالغ الأهمية كما أن الشكر موصول لموقع نيوز يمن الذي سيثري الموضوع بهذا المنتدى وهي بداية طيبة وبادرة عظيمة لإثارة هذا الملف الذي عزف عنه كثير من المهتمين والحقوقيين رغم أهميته كونه ملفاً استثنائياً والصبغة الإنسانية فيه الأكثر إثارة، وأهمية والمطلوب تضامن الكافة من أجل توضيح ملابسات هذا الملف وضحاياه والذي سيظل مفتوحا طالما يخرج أصحابه من السرداب المجهول.
هاشم عضلات*
< مع احترامي لوكيل الوزارة إلا إنه لم يكن موفقاً في معالجته لهذا الملف الشائك، بل إنه يزيد الطين بله، فهو بجهوده التي رواها بزهو، يبين لنا بأن الوزارة تعمل على حرمان أسر المختفين قسرا من حقوقهم المشروعة دوليا في التعويض العادل وفقا للمعايير الدولية، وحقهم في معرفة مصير أبنائهم، واسترجاع مقتنياتهم وزيارة قبورهم، ونيل حقوقهم الوظيفية، الأدبية والمعنوية وغير ذلك، علما بأن راتب نهاية الخدمة حق يناله الحي والميت على حد سوى.. ولا يعتبر تعويضاً عن حالة اختفاء قسري. وأطمع من الأخ الوكيل بأن يتبنى مشروع قانون يقضي بأن المختفين هم شهداء، عسى ربي يكتبه له في ميزان حسناته. كلي ثقة من إن الأخت الوزيرة تقف إلى جانب حقوق أسر المخفيين، وستعمل على تصحيح مسار متابعة هذا الملف بما يضمن نيل كل ذي حق حقه. وكفاية تدليس، فهؤلاء هم أبناء وطننا الغالي، ولا يجوز دفنهم مرتين.
أسرة مفقود*
< أقول وبقناعة، بأن هذا الملف يشكل نقطة سوداء في تعاملاتنا الوطنية والإنسانية. كيف لا والعشرات من أبناء وطننا لا يزال مصيرهم مجهول رغم انقضاء عشرات السنين على اختفائهم. لمصلحة من تمييع مطالب أسر المختفين قسرا؟. لمصلحة من السعي لإغلاق مطالبهم؟ أليس ذلك يخدم الجناة؟ مع قناعتي بأن حكومة بلادنا ليست طرفا في اختفائهم.. لولا إن أسلوب التعامل معها رسمياً يوحي بتلبيسها هذه المشكلة.
مراقب
< معانة الأسر والمتعاطفين وغيرهم، لا تحتاج إلى تبيين، ومع ذلك فإن وزارة الحقوق بدلاً من أن تعمل على لملمة تلك المعاناة، نلمس بأن جهودها تنصب على تمييع قضايا الاختفاء, وكأن حكومة بلادنا طرف في تلك الإختفاءات، وكأنها تؤازر من قام بمثل تلك الإنتهاكات.
متعاطف
< الشكر للإخوة في صحيفة النداء علي جهودهم في متابعة القضايا الإنسانية بكل حيادية فحقوق الإنسان وكرامته يجب ألا تكون وسيلة للمناورات السياسية كما يرى البعض، ففي الحوار الذي أجرته النداء مع وكيل وزارة حقوق الإنسان كان الوكيل في موقف الدفاع علي عكس المحاور الذي كان في موقف الصحفي الباحث عن الحقيقة ليس إلا. قضايا المخفيين قسرياً يجب التعامل معها كقضية يمنية تعني اسر المخفيين وتعنينا كيمنيين قبل أن تعني المنظمات الدولية، وعلى كل من يرى غير ذلك أن يضع نفسه مكان المخفي قسرياً أو أسرة المخفي ليدرك ما تعانيه تلك الأسر.
يجب علي وزارة حقوق الإنسان والجهات المعنية التعامل مع هذه القضية علي أساس إنساني بحت و القيام بتحقيق محايد يقنع أسر الضحايا ويعوضهم تعويضاً عادلاً كونهم ضحايا قضايا سياسية، وما المانع من أشراك أسر المخفيين قسريا ومنظمات حقوقية في التحقيق؟
محمد شمس الدين
< في يوليو الماضي أعلن الوفد الحكومي المعني بإغلاق ملف الاختفاء القسري المنظور لدى الأمم المتحدة عن ما حققه من انتصار وقدرة على إغلاق 46 حالة اختفاء، وذلك بعد أن استفاد الوفد من عدم وصول وجهة نظر الأسر المعنية بتلك الحالات على ردود وتبريرات وزارة حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الوفد الموقر له الحق في المطالبة بإغلاق تلك الحالات، وهذا ما أعلنه الوفد من طرف واحد، ولا نعرف صحة ذلك من عدمه. باعتقادي إن فترة الستة أشهر هي فترة ليست مطمئنة للوزارة التي تعد الساعات والأيام كي تنقضي تلك الفترة لتتحجج بها، وترسل وفودها للمطالبة بإغلاق الحالات المتطابقة وانقضاء المدة. السؤال هو إذا كنا حقانيين هل تعتقد " وزارة حقوق الإنسان " إن عدم وصول ردود أسر الضحايا هو إعلان صريح منهم على التنازل عن حقهم في معرفة مصير أبنائهم؟ وهل عدم الرد يعني موافقتهم على إسقاط حقهم في المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية؟ هل تساءلت الوزارة عن أسباب عدم رد الأسر على ما تم بحق أبنائهم؟ هل وضعت الوزارة الموقرة بعين اعتبارها احتمالية عدم استلام الأسر لردود الوزارة المحالة إليهم عبر الأمم المتحدة. بسبب ضعف الخدمات البريدية في بلادنا أو لصعوبة العنوان، أو لتغييره، أو احتمالية الحجر على مثل تلك المراسلات التي تكون الأمم المتحدة طرفا فيها؟
أخواني الأعزاء.. إذا أردنا أن نكون منصفين.. علينا الاعتراف بان هذه مغالطة نغالط بها أنفسنا قبل أن نغالط بها الآخرين.علينا أن لا نتحجج بانقضاء فترة الستة الأشهر، علينا أن لا نتمسك بهذا العذر القبيح … علينا أن لا نعتبر عدم الرد هو بمثابة تنازل من الأسر عن حقوق أبنائها.. علينا يا أخوان أن نقف إلى جانب المظلوم.. اتقوا الله يا القائمين على حقوق الناس.
شقيق مفقود*
< علينا أن نعي جيدا إن مسألة خطف وإخفاء أي شخص ليس بالأمر الهين.. علينا أن ندرك بان جرائم الاختفاء لا تنتهي بالتقادم، فما بالك بـ"إغلاق الملف ". إنها جرائم تظل قائمة حتى يحق الحق مهما طال الزمن. علينا أن لا نتلاعب في أرواح الناس وفي مصائرهم وحقوقهم..هؤلاء هم أبناء الوطن الذي لا نصير لهم عدا الله سبحانه وتعالى ومن بعده أجهزة العدالة والإنصاف في حكومة بلادنا الموقرة. لذا يستوجب عليكم، أنتم المسئولين في وزارة حقوق الإنسان أن لا تتهاونوا في ذلك، ولا تهادنوا، ولا تجاملوا أحداً في قضايا مصيرية تتعلق بأرواح البشر.. كسباً في عطف مسئول أو إرضاء لوجهة نظر جهة متنفذة.. عليكم أن تستوعبوا الأمور وأن تضعوها في نصابها.. إحقاقاً للحق الذي ستسألون عليه أمام رب العرش العظيم. ألفت عنايتكم يالمعنيين ب حقوق الإنسان في الوزارة الموقرة، بان فخامة الرئيس القائد علي عبد الله صالح حفظه الله لا يرضى بضياع الحقوق، فهو الأب العطوف على أبناء شعبه الأموات منهم قبل الأحياء.. فلا تعتقدوا أن الالتفاف على حقوق أسر المفقودين يتوافق وتوجهات الرئيس الأب.. ولا تعتقدوا أن مساعيكم لإغلاق ملفاتهم هو عمل يرضي الأخ الرئيس. الرئيس وتوجيهاته دائماً تنطلق من إحقاق الحق وليس العكس.. والحق في موضوعنا هذا هو الوقوف إلى جانب أسر المفقودين ومؤزرتهم في محنتهم، ومنحهم التعويضات المتوافقة المعايير الدولية الكفيلة بالتخفيف ولو قليل عن معاناتهم المزمنة. عليكم أن تتبنوا وجهة نظر أسر المفقودين، وأن تكونوا عوناً لهم أمام الجهات المحلية والدولية وليس العكس.. أسر المفقودين يروا فيكم الجهة المنصفة لهم، فلا تخذلوهم.
أسرة مفقود*
***
(5)المختفون قسرياً
العدد 108-20 يونيو 2007
22 مايو.. بما هو يوم كارثي في حياة آل البان
عدن - فهمي السقاف
في العاشرة من صباح 22 مايو 1971، ترجل 15 عنصراً أمنياً من ثلاث سيارات لاندروفر، في موضع بقرية بير جابر بمحافظة لحج، وطلبوا من حسين صالح تيسير البان، وثمانية آخرين من أفراد أسرته مرافقتهم بهدوء لأنهم مطلوبون من الأمن للرد على استفسارات. كان حسين منهمكاً في إصلاح سيارته اللاندروفر، يساعده المهندس الشاب قادري أحمد علي البان. وتواجد أيضاً نجله الأكبر هاشم (15 سنة حينها)، وصهره (شقيق زوجته) أحمد عبدالعزيز البان، وإبن شقيقه سيف علي صالح البان. وكان هناك سلطان، 10 سنوات، وهو النجل الأوسط لحسين. وقد وقف وحيداً ذاهلاً، وهو يتابع أباه وأخاه الأكبر هاشم والآخرين من أسرته، يقتلعون من المكان.
بعد 36 سنة تحدث سلطان وشهود عيان آخرون إلى «النداء» عن نكبة آل البان.

عمل حسين صالح تيسير البان، المولود في بير جابر 1938، منذ طفولته، في الفلاحة ورعي الأغنام. كانت الجمال وسيلة النقل المثلى في تلك الفترة. كانت تنقل المحاصيل والحطب إلى أسواق عدن والحوطة. وقد أمكن لحسين أن يشتري من مداخراته سيارة لاندروفر، كانت الأولى التي تحلَّ في بير جابر. وإلى المحاصيل والركاب الذين كانت تحملهم السيارة إلى عدن، بادر حسين إلى تيسير فرص أطفال قريته في قهر الأمية. وقد عمل على نقلهم صباح كل يوم إلى مدارس لحج.
كان الشاب العصامي يحصد ثمار كده وعرقه. وقد استطاع شراء سيارة لاندروفر أخرى، خطط لأن يعمل عليها، نجله الأكبر هاشم.
 كانت بير جابر ومصعبين والحمراء، وهي القرى التي يقطنها آل البان في لحج، منطقة نفوذ جبهة التحرير، الفصيل المنافس للجبهة القومية التي انفردت بالحكم بعد الاستقلال في جنوب اليمن.
كانت بير جابر ومصعبين والحمراء، وهي القرى التي يقطنها آل البان في لحج، منطقة نفوذ جبهة التحرير، الفصيل المنافس للجبهة القومية التي انفردت بالحكم بعد الاستقلال في جنوب اليمن.كان حسين عضواً في جبهة التحرير، وكذلك أغلب مجايليه من آل البان، وكان قد تزوج من صالحة عبدالعزيز البان، وقد رزقا بخمسة أبناء، أكبرهم هاشم، وأصغرهم بليل. وكان سلطان واسطة العقد. أما صباح ودرويش فقد ماتا بعد عام من اعتقال الأب.
كان بليل صبيحة ال22 مايو (!) يلعب مع صحبه في القرية، وقد سمع جلبةً في الجوار، وراقب من بعيد، رجال الأمن يقتادون الكبار من أفراد أسرته.
أما صالحة الشابة التي لم تكمل عقدها الثالث، فقد قدِّر لها أن تجسد المأساة المستمرة منذ ذلك التاريخ. ففي «غمضة عين ثورية»، أو بتعبير تلك الحقبة «لحسة واحدة»، فقدت زوجها ونجلها الأكبر وأخاها. وبعد أقل من عام كانت قد فقدت إبنتها الوحيدة صباح، وإبن آخر (درويش) جراء العوز. وقد أمضت، وما تزال، عمرها في انتظار الأحبة. وعندما تحققت الوحدة في 22 مايو 1990، كان مقدراً لها أن تحيا في قلب المفارقة: إنها وحدوية بإمتياز!
<<<
صبيحة 22 مايو 1971 كان حسين وصهره أحمد عبدالعزيز البان (شقيق صالحة) ونجله هاشم وإبن شقيقه سيف علي صالح البان، ينتظرون مهندس السيارات الشاب قادري أحمد علي البان لاصلاح عطب في إحدى السيارتين.
وصل قادري في التاسعة والنصف من قرية مصعبين، رفقة صالح حيدرة البان وعلي حيدرة البان وأحمد هداس، وتحلَّق الكبار حول السيارة منتظرين، وحمل الفضول عديدون من صبية القرية إلى المكان لمتابعة المهندس الاستثنائي (السوبرمان القادم من قرية مصعبين).
لم ينجز المهندس المهمة، فقد حط 15 عنصراً أمنياً في المكان في مهمة ثورية تطهيرية. علم حسين ورفاقه بأنهم مطلوبون أمنياً لاستجوابهم، مع «وعد خرافي» بإعادتهم «سالمين».
كان رجال الأمن متسامحين(!) فقد تركوا الفتى سلطان وأقرانه، وأخذوا الآخرين. كان الآخرون جميع البالغين المتواجدين في المكان، علاوة على هاشم شقيق سلطان الأكبر، الكان ساعتها في الخامسة عشرة من عمره.
«أذكر جيداً المشهد كأنني أراهم الآن أمامي»، قال سلطان حسين صالح البان المشرف الآن على الخمسين، لـ«النداء». 36 عاماً حتى الآن وهو في انتظار «الوعد الخرافي»: إعادة المقبوض (والمغضوب) عليهم.
لم يعد الكبار إلى قرية بير جابر. لكن «الوعد الخرافي» تجسد بمنطق الشرعية الثورية. فبعد ساعات عاد إلى القرية رجال الأمن. عادوا هذه المرة لمصادرة مشروع عمر «حسين»: سيارتا اللاندروفر. كانت الأولى تحمل لوحة برقم 162 المحافظة الثانية (لحج)، وحملت الأخرى لوحة برقم 718.
لم يظهر أثر للمطلوبين أمنياً رغم متابعة أشقاء حسين، ونجله الأوسط سلطان. لكن السيارتين ظهرتا بعد شهور في مقر شرطة عدن الصغرى. وقد حرر قائد شرطة الشيخ عثمان مذكرة في 22 ديسمبر1971 وجهها إلى شقيقي حسين: علي وناصر صالح تيسير، وإلى نجله سلطان حسين، بشأن مصير السيارتين.
اختار قائد الشرطة أن يصدِّر مذكرته التاريخية كما يلي: الموضوع: سيارات م/ الثانية رقم 162 و718.
ثم أحاط الأخوة علي وناصر وسلطان، بأن «السيارتين المذكورتين أعلاه والتي يملكهما الأخ حسين تيسير موجودات في مقر شرطة عدن الصغرى منذ فترة طويلة، وقد أشعرت الأخ الحداد [ربما قصد قائد شرطة عدن الصغرى] بإشعاركم لاستلامهما دون جدوى».
كان قائد شرطة الشيخ عثمان، يحمل نوايا طيبة تجاه ضحايا «الشرعية الثورية»، وقد أضاف في مذكرته فقرتين بيَّن فيهما مغبة بقاء السيارتين في شرطة عدن الصغرى، وما سيترتب على ذلك من تلفهما، راجياً من أقارب حسين «الحضور فوراً حال استلامكم هذه الرسالة لاستلام السيارات المذكورة والاستنفاع بها».
«لكن أين أخي حسين وأين بقية الأخوة، وماهو مصيرهم»، رد علي صالح البان على مذكرة قائد الشرطة.
وبحسب سلطان، فإن عمه أبلغ قائد الشرطة ما مفاده: «نريد البشر أولاً... نريد مُلاَّك السيارات»! لكن العم الطيب مات عام 1979 قبل أن تتحقق إرادته، لم يعد شقيقه حسين ولا نجله سيف، ولم تعاود المذكرات الرسمية الإشارة إلى السيارتين.
<<<
في 22 مايو 1971 كان حسين في ال34. بعد عام فقدت صالحة إثنين من أبنائها. في 1979 توفي علي صالح تيسير (شقيق حسين، ووالد سيف).
في 22 مايو 1990، انتعشت آمال صالحة وقد بادر سلطان وآخرون من آل البان بمتابعة الموضوع لدى الجهات العليا في الدولة.
بانصرام سنوات الوحدة بهت الوعد الوحدوي، قبل أن يحتل موقعه في «المقبرة الوطنية» إلى جوار «الوعد الثوري».
وفي فبراير 2004 ضاقت سبل الحياة بسلطان حسين صالح البان، فتقدم بملف إلى محافظ عدن (يحيى الشعيبي حينذاك)، مشفوعاً بطلب اعتماد رواتب لأسر المختفين قسرياً: حسين صالح تيسير البان، وهاشم حسين صالح تيسير البان، وسيف علي صالح تيسير البان. بعد 3 أسابيع رد مدير فرع مكتب رعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة اليمنية في عدن، على توجيهات المحافظ، قائلاً: «هذا الموضوع قديم، وفرع الهيئة في عدن ليست لديه اعتمادات، وكل شيء معلق بالهيئة في صنعاء».
في الشهر نفسه وجه ناصر عبدالعزيز محمد شيخ آل البان في بير جابر مذكرة إلى المحافظ، أشار فيها إلى الأوضاع الصعبة لأسرة حسين البان، مؤكداً بأن حسين البان وابنه هاشم، وأبن أخيه سيف اختطفوا عام 1971، بالإضافة إلى مصادرة سيارتي حسين.
في 5 مارس 2007 صدر حكم بانحصار ورثة هاشم بن حسين بن صالح، من محكمة الحوطة الابتدائية، وذلك لغرض تقديم طلب باستلام راتب من مكتب رعاية أسر الشهداء. وفي الحكم اعتبر هاشم النجل الأكبر لحسين، متوفياً بسبب القتل في محل مصعبين بتاريخ 22 مايو 1971.
في 6 مارس 2007 صدر حكم آخر من نفس المحكمة بانحصار ورثة المتوفي حسين بن صالح بن تيسير في 22 مايو 1971 نتيجة القتل في قرية مصعبين. وفيه حملت الزوجة المنتظرة صالحة عبدالعزيز وصف الأرملة!
في 10 مارس 2007 صدر حكم ثالث بانحصار ورثة الشاب سيف علي صالح البان المولود في بير جابر عام 1950، والمتوفي نتيجة القتل في 22 مايو 1971. وفيه انحصرت وراثته في والده علي صالح تيسير المتوفي عام 1979! ووالدته سايبة سيف سالم.
بإستثناء أحمد عبدالعزيز البان لا ترد اسماء ضحايا 22 مايو في أي قائمة من قوائم وزارة حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان.
ومن جملة آل البان المختفين يرد إسم آخر: أحمد سكران البان المولود في 1945، والمختفي عام 1975، بحسب قوائم المفوضية، وتظهر معلومة أخرى في بياناته تفيد بأنه كان عضواً في الجناح العسكري لحزب البعث.
سلطان أكد لـ«النداء» بأن لم يتلق أي إتصال من أي منظمة حقوقية، محلية أو خارجية. وهو قال متهكماً: يبدو أن هذه المنظمات لا تعتبر المختفين قسرياً من فئة الإنسان الذي تطالب بحقوقه».
اضطر سلطان وبليل ووالدتهما، فضلاً عن والدة سيف، إلى استصدار أحكام بانحصار وراثه، لأحبتهم المختفين لغرض ادراج أسمائهم ضمن المستحقين لرواتب هيئة رعاية أسر الشهداء. وقد حرصوا جميعاً أن يبينوا هذا الغرض الوحيد في الاحكام الصادرة من محكمة الحوطة.
لم يحظ سلطان بفرصة عمل قط، فقد تم تعيينه(!) منذ نعومة أظافره كعنصر من قوى الثورة المضادة. وهو يقطن بير جابر رفقة «الأم». ويعمل أحياناً في الزراعة. وقد حُرم من فرصة متابعة تعليمه. كذلك حال شقيقه الأصغر بليل، الذي يعتاش من سيارة تاكسي يملكها. لكن بليل الذي يسكن عدن الصغرى لم يفكر قط بزيارة مقر الشرطة المجاور للسؤال عن سيارتي اللاندروفر، فهو كما سلطان ووالدته صالحة، ما يزال مؤمناً بالشعار الذي رفعه عمه علي قبل 36 عاماً: نريد البشر أولاً!
***
طاهش الحرب الذي سرق الفرحة من عبدالمؤمن وأسرته
نادرة عبدالقدوس
nadra
عبد المؤمن اسم يضاف إلى قائمة المفقودين الذين ابتلعتهم الأرض في غفلة من الزمن. ولد عبد المؤمن لأسرة متوسطة الحال، في قرية الأعبوس بتعز. وكان ترتيبه الخامس بين سبعة أخوة، تميز عنهم بحبه للتعليم، لذلك ترك حضن أمه والقرية ليلحق بأبيه في مدينة عدن. وقد كان الأب يعمل في مطعم صغير في شارع الزعفران بكريتر، وكان عبد المؤمن (حينها) لم يتعد سن الطفولة، لكنه أنهى التعليم الابتدائي في مدارس تعز، وأكمله في مدارس عدن
 .
.شطحت أحلامه بعيداً، إلى التخصص في العلوم الزراعية. ولأن النظام السياسي في عدن آنذاك لا يفرق بين أبناء المناطق اليمنية، وكيف له ذلك، وهو الذي كان يرفع شعار النضال من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية وتحقيق الوحدة اليمنية!! وكان أبناء اليمن جميعهم دون تمييز، يحصلون على حق التعليم المجاني في كل مراحل التعليم داخل الوطن، وعند الابتعاث إلى الدراسات العليا في الخارج، إذ كان لا يفرق بين ابن فقير أوغني، أو ابن خادم أو وزير... وهكذا حظي عبد المؤمن بالحق بالتعليم العالي في الاتحاد السوفيتي ليلتحق بكلية الزراعة في موسكو عام 1975م.
عبد المؤمن عبده نعمان. من مواليد تعز عام 1952م، الطول: 5 بوصات و5 أقدام، لون العينين: أسود، لون الشعر: أسود.. هذه المعلومات بحذافيرها مسجلة في جواز سفره الصادر في عدن بتاريخ 2/7/1975م. وكان آخر تجديد له في 29/ 6/ 1982 م.
تخرج عام 1981م ليعمل في محافظة أبين مهندساً زراعياً في مركز الأبحاث الزراعية منطقة الكود. ولم يتبق غير أن يكمل نصف دينه بعد ما تحقق حلمه في التعليم والعمل بالتخصص الذي شب معه.
خطبت له أمه فتاة من القرية، وكان إحساس أمِّه صائباً، فقد كانت نعم الزوجة المحبة، ونعم الأم الرؤوم، ونعم الأرملة التي حافظت على ذكرى زوجها، الذي لم تعترف برحيله عن دنيانا وعدته فقيداً وحياُ يرزق.. فهو أخبرها بنيته لزيارتهم في القرية حيث كانت مع أطفالهما هناك ريثما تنقضي فترة النفاس، إذ وضعت طفلهما الرابع. "انتظرت الأسرة مقدم الأب الحنون". هكذا وصفته ابنته الشابة " رنا "، الكبرى بين أخوتها، التي التقيتها بعد موعد اتفقنا عليه لسرد قصة الأب، الذي انتظر حتى يهدأ " طاهش " الحرب ليحمل هدايا عيد الأضحى لأطفاله الأربعة، من بينهم المولود الجديد الذي طلب من زوجته أن يحمل أيضا اسمه في بدايته حرف الراء كبقية أسماء أخوته، فهناك غير رنا، " رانية " و " رامي " فليكن اسمه " راني ".. إلا أن طاهش الحرب يبدو أنه تربص بالأب المسكين وهو في طريقه إلى مدينة تعز، ولم يمهله الفرصة لرؤية طفله المولود، وطبْع قبلة شكر على جبين زوجته، التي أنجبت ولداً جديداً إلى جانب الولد الثالث في ترتيبه بعد أختين تكبرانهما.
لم يعرف أحد سيناريو الخطف أو القتل أو... ولم تجد الأسرة أي دليل يوصلها إلى الحقيقة، التي غابت في الرمال... انتهت الحرب ولم يصل هو إلى القرية. كان يحمل بين ثنايا فؤاده حلماً صغيراً وفرحة كبيرة تجاوزت سعة الدنيا... حسدته الدنيا، كان ذلك في 27/7/1994م.
تقول ابنته: " كل يوم نعيش في رعب الطرد من البيت الذي يأوينا في الكود، وهو البيت الذي حصل عليه أبي من مركز الأبحاث الزراعية، إذ يقولون إننا لم نأتِ بدليل يؤكد مماته، أو أنه على قيد الحياة، لذا فإنهم أيضاً لا يمنحوننا الراتب لبضعة أشهر... لقد تناسوا أن أبي حافظ طوال الحرب على أجهزة ومعدات المختبر في المركز. أبي لم ينتم إلى أي حزب أو تنظيم سياسي، كان لا يهتم إلا بعمله وبيته وأسرته ". ورنا، الفرحة الأولى لعبد المؤمن، الحاصلة على معدل جيد جداً في الثانوية العامة العام المنصرم في القسم العلمي، يؤهلها للدراسة في كلية الهندسة "برمجة حاسوبـ" بجامعة عدن (هكذا تحلم)، والحاصلة كذلك على منحة مجانية في "الأميدست" لتعلم اللغة الإنجليزية لتفوقها في هذه اللغة بالمدرسة تضيف قائلة: "إننا نعاني من مشاكل كثيرة منها أنهم في مركز الأبحاث يهددونا بقطع الراتب، لا أدري كيف سنعيش بعد ذلك!؟ وأخوتي ما زالوا في المدرسة، فأختي رانية في الثالث ثانوي، وأخي رامي في الثاني ثانوي، أما أخي نديم ففي الثامن ابتدائي.." قاطعتها: " لماذا نديم أليس اسمه راني؟ " ومن خلف ابتسامة حزينة جاءت كلماتها متلعثمة: " كان من المفترض أن يكون اسمه راني، لكن أمي أسمته "نديم" تعبيراً عن ندمها على بعدها عن أبي في تلك الفترة، وعلى حزنها الشديد عليه.. ".
***
(6)المختفون قسريا
العدد 109-27 يونيو 2007ً
إثارة الاشمئزاز
سامي غالب
Hide Mail
توقعت أسرة «النداء» الأسوأ عندما قررت في أبريل الماضي فتح «ملف المختفين قسرياً» الملف الموحش الراسب في أعماق الذاكرة الوطنية، وإنْ طفا ففي علب مصممة من شعارات جوفاء وزخارف لفظية.
كان التقدير أن البيئة السياسية والثقافية والحقوقية ليست جاهزة بعد لمقاربة الملف بعقل مفتوح وقلب سليم. فإلى الحرب الدائرة في صعدة والحروب الصغيرة الناشبة في العاصمة، والالتهاب المزمن في المحافظات الجنوبية والشرقية، فإن النخبة السياسية في الحكم و(أغلب) المعارضة متورطة، على تفاوت ملحوظ، في جرائم الاختفاء القسري التي وقعت خلال العقود الأربعة الماضية.
وكان التقدير أن فتح الملف، كيفما اتفق، دون تحوط لسوالب البيئة ومثالب النخبة، سينزل «النداء» منزلاً تطوقه «شياطين التأويل» بما هي الطابور الأول، والأكثر جاهزية ومبادأة، في جيوش دويلات الحرب، المشتبكة غالباً، والمتعايشة احياناً داخل الوطن الافتراضي.
وقد توجب على «النداء»، إذ تُقدم، أن تدفع كل هذه الأخطار بآليات حمائية متنوعة، بعضها ناجز: فإلى «ميثاق شرف» الصحيفة، لزم مراعاة اعتبارات سياسية وإنسانية شديدة الحساسية، تخص أسر الضحايا، والتسلح بوعي شمَّال لخصوصية الملف، وسياقاته التاريخية ومترتباته المستقبلية خصوصاً وأن شواهد عديدة ماثلة تقطع بأن التغطية الموضوعية المعمقة والمستمرة، المنزهة من التحيزات السياسية والعقائدية- ستربك جماعات في الحكم والمعارضة، على السواء، دأبت على مدى سنوات، على تطوير آليات حمائية تحول دون تسرب ضحايا الاختفاء القسري إلى «سوق السياسة» التي يتوزعها حفنة من الكبار (الصغار) لا يقيمون وزناً لحقوق المواطنة في تجاذبهم وتنافرهم، وفي حروب احتكار التمثيل، وإذ يخوضون في المناقصات والمزايدات (الوطنية)، وحين يشنون حروبهم الداخلية، وساعة يبرمون صفقات يخلعون عليها وصف المصالحات الوطنية.
كان الأسوأ منتظراً. وإذ جاء، ففي قالب من الفظاظة والفظاعة. ومنذ نشر أولى حلقات الملف، منتصف مايو الماضي، هاجت شياطين التأويل، ترشق «النداء» ومحرريها، دون أن توفر الضحايا، بأقذع السباب.
منذ الحلقة الأولى فعَّل الجناة (ومَنْ غير الجناة يستفزه بوح الضحية؟!) آلياتهم للنيل من مصداقية الصحيفة والتزام محرريها المهني والأخلاقي. فعلاوة على دعاوى الإساءة لرئيس الدولة، والتشويش على عدالة الحرب في صعدة، وإحياء ملفات الماضي (لكأن المطلوب أن تحيا أسر الضحايا وحدها في الماضي!)، ومحاولة تفكيك الاصطفافات السياسية والجهوية الراهنة، أطلق الآثمون تهمة المناطقية على الصحيفة، في إسقاط يثير من الاشمئزاز أكثر مما يثير من الغضب.
باسم المصالحات المزعومة، والمراحل الانتقالية، والتسامح المفترى عليه، والوحدات الوطنية التي تجُب ما قبلها، أفلت الجناة دوماً من المساءلة والعقاب، وحُكِم على أقارب الضحايا بالإقامة المؤبدة عند تواريخ اختفاء أحبائهم، واحتفظت الثوابت الوطنية والقضايا الكبرى بقوتها الأدائية الرهيبة، عابرة الأزمان والمصالحات والاتفاقات.
ومن هذه الزاوية حصراً، تتبدى الوظيفة المستقبلية لملف «النداء»، بخاصة مع إعلان وقف النار صعدة، والإشارة صراحة في الإتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثي، إلى معالجة ملف المفقودين جراء الحرب هناك.
***
ذهب يصطاد.. فاصطادوه!!
- فهمي السقاف
شأنه شأن معظم أبناء قريته عمل صالح سعيد عاطف، المولود في قرية المحلة 1938م (إحدى قرى لحج)، في الزراعة، وتربية المواشي وبيعها، وكذلك بيع المحاصيل الزراعية وهي بطبيعة الحال، موسمية، لينفق من عائداتها على أسرته، ويدخر ما زاد عن حاجته. طموحه وحسه التجاري حفَّزاه للعمل بدأب ومثابرة، ليضاعف مدخراته الأمر الذي مكنه من فتح متجر خاص به في مدينة الشيخ عثمان- حافة «الروضة» لبيع مواد البناء.استمر الشاب القادم من قرية المحلة، بدأبه ونشاطه منمياً تجارته الجديدة (بيع مواد البناء)، اتسعت تجارته وزادت مدخراته، ذلك دفعه لبناء منزل في شارع الحرمين، بالشيخ عثمان. بناء المنزل يشير بوضوح، الى عزم صالح علي للإستقرار والمضي قدماً لدخول القفص الذهبي ليتزوج من ابنة عمه، شمس صالح عاطف ويرزق بتسعة أبناء، سبع إناث وولدين هما عبدالكريم، وعبدالحكيم، أصغرهم.

استمر صالح في دأبه ونشاطه التجاري بنجاح. ودماثة خلقه وأمانته وحسن تعامله مع الجميع من تجار كبار وايضاً مع زبائنه، هذه الصفات التي يتمتع بها صالح، كانت اساس وعماد مهنته لتدر عليه ارباحاً ومكاسب في بيعه وشرائه مكنته من شراء سيارة مرسيدس تحمل لوحة رقم 12682م/الأولى. لم يكن صالح بعيداً عن الهم الوطني، حينذاك (عند انطلاق الثورة وبداية مرحلة الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني ) يدرك صالح جيداً أن عليه واجباً تجاه وطنه، وعليه أن يؤديه، لم يبخل ولم يتردد، بل جاد بالمال داعماً بسخاء.
13 يناير 1966م اقتتل الاخوة الاعداء، الجبهتين القومية، والتحرير، عرف هذا الاقتتال في عدن بـ«الحرب الأهلية» بعد أن وضعت هذه الحرب أوزارها، ظلت مشاهدها الدامية ومآسيها حاضرة بقوة في ذاكرة صالح، عذابات تلك الحرب وشراستها زرعت الخوف في نفس صالح على أسرته مقرراً حينذاك بيع منزله في الشيخ عثمان لأحد أقاربه ونقل أسرته إلى منزله الأول في مسقط رأسه بقريته «المحلة».
مساء يوم3/4/ 1972. قرابة الخامسة والنصف وبعد يوم عمل لا يخلو من تغب ومشقة أغلق باب متجره كالعادة، وأدار محرك سيارته المرسيدس (بيضاء اللون) مصطحباً معه ابن عمه درويش أحمد عاطف، الذي كان يتشارك وإياه هواية محببة لنفسيهما، بل انها متعتهما، يروحا عن نفسيهما بعد ان ينهيا أعمالهما بممارسة هواية التجليب (صيد السمك)ككثيرين من أبناء عدن، وكذلك ابناء المدن الساحلية.
اعتاد الذهاب لمنطقة كالتكس بالمنصورة للتجليب بشكل شبه دائم. يروي نجله عبدالكريم صالح، الذي كان عمره حينذاك 11 عاماً ( من مواليد1961) هذه الرواية التي سمعها عدة مرات من العم درويش ومن والدته ومن اعمامه الآخرين، وصلا المكان الذي اعتادا التجليب فيه ضمن عدة اماكن أخرى في المنطقة، لكن هواة مثلهما سبقوهما. ركن صالح سيارته واخرجا عدة التجليب، وشرعا في الصيد، صالح كان ذهنه متجهاً صوب سيارته. لم تعجبه وضعيتها لأن المكان الذي اعتاد أن يركنها فيه سبقه إليه احد هواة التجليب.
علقت بسنارة درويش سمكة، صالح اقترح على درويش الذهاب الى مكان قريب اعتاد التجليب فيه، لوجود مساحة فسيحة تتيح له أن يركن سيارته باطمئنان، درويش تفاءل بالمكان الذي هو فيه قائلاً له: سأبقى أنا هنا واذهب أنت هناك ولا تنس أن تمر علي في طريق العودة. وأردف، قائلاً: «تفرقوا ترزقوا». مضى صالح إلى المكان الآخر، ركن سيارته وأخرج عدته وشرع بالاصطياد (لايبعد المكان سوى أمتار قليلة). يقيناً لم يدر بخلد صالح وهو يصطاد أنهم عما قليل سيصلون ويصطادونه. مجموعة لا يعرف عددهم على وجه الدقة، كانوا يتابعون تحركاته وخطواته، سيارات قليلة تمر بعضها لهواة التجليب كصالح، وبعضهم يأتي ملتمساً نسيم البحر العليل في ليلة صيف، بعيداً عن ضوضاء المدينة. بعذ زهاء عشرين دقيقة أو أكثر قليلاً من مغادرة صالح باتجاه الموقع الآخر الذي اعتاد الاصطياد فيه، وبينما كان الليل قد بدأ يرخي سدوله بعيد مغرب ذاك اليوم، شاهد درويش من موقعه سيارة تمشي على مهل في ذات الاتجاه الذي قصده صالح، لا شيء يثير الشك أو الريبة في تلك اليسارة، استمر درويش بالتجليب، لم يمض كثير وقت، درويش يشاهد من موقعه سيارتين مغادرتين من اتجاه الموقع الذي يتواجد فيه صالح وتمران بالطريق الذي تفصله عنه قرابة 200إلى 250 متراً، لم يكن بوسعه تمييز سيارة صالح. السيارتان تمشيان على مهل، واصل درويش تجليبه بعدها انتبه درويش أن ساعة العودة قد أزفت، بدأ التوتر على درويش الذي كان يلقي سنارته ويرفعها بحركة عصبية، شعر أن انتظاره لصالح طال أكثر مما ينبغي، بدأ الضجر والتبرم من صالح الذي نسي نفسه ولم يأبه لوقت العودة. سيأتي الآن، سأبلغه بأني لن أصحبه مرة أخرى!! طال انتظار درويش واستحال إلى قلق أصبح نهباً للوساوس، قرر المشي الى موقع الذي ذهب إليه صالح. ليرى ما أعاقه، ما سبب تأخره!؟ ويتمتم، اللهم اجعله خير، اقترب من المكان وبدا كمن يصرخ في البرية يا صالح.. صالح ياص....ال....ح. لا رد ولا جواب. لم يدر درويش حينذاك أن نداءه ونداء اسرة صالح وذويه سيتمد ل35 عاماً دون جواب. إلا من رجع الصدى، أجال بصره في المكان الذي اعتاد صالح إيقاف سيارته فيه ليرتد اليه بصره منبئاً إياه أن لا وجود للسيارة.
تذكر السيارتين اللتين مرتا بمحاذاته، تساءل أتراه عاد ولم يمر بي؟! أنسيني؟! قطع المسافة راجلاً حتى وصل جولة كالتكس، أننتظر وصول سيارة أجره أشار لها، وقفت جواره، وركب عائداً إلى منزله في الشيخ عثمان، سأل ما إذا كان صالح أتى؟!
ألم تكونوا معاً؟! لم يأت جاءه الجواب. بلى كنا معاً لكن كل منا كان يجلب في موقع من المواقع التي اعتدنا الاصطياد فيها. سأل اقاربه الذين في الشيخ ما إذا مر بهم صالح، أسرته حينها كانت في زيارة أقارب لهم في الشيخ سألهم درويش أيضاً عن صالح. كل الاجابات التي تلقاها بأنه لم يأت بعد. عادت اسرته للقرية «المحلة». سألوا عنه هناك انصرف ذهن زوجته لعله ذهب هناك لم نره لم يأت. كانت الإجابة. القلق على مصير صالح تملك جميع أفراد اسرته. ثلاثة ايام مرت وهم يسألون أقاربهم وأصدقائه، والإجابه واحدة: لم نره، لم يأت!!
عرف درويش، وبعده أيضاً عرفت أسرة صالح، بأنه أصطيد أو أقتيد سيان، مساء يوم 3/4/1972. وفوق سيارته ومحاط بمتعقبيه كانت سيارة صالح تتقدم سيارة مصطاديه، ليمضي، رحلة طويلة الى المجهول.
يروي نجله عبدالكريم مواصلاً: ذهبت وعمي تتابع جهات الاختصاص، عن والدي نريد معرفة ما حل به، كنت حينها في الثانية عشر من عمري، لكن لا جواب منذ اختفائه قسرياً، ومطالبتنا للجهات المختصة مستمرة نريد أن نعرف مصيره.
ذهبنا لصالح مصلح، وزير الداخلة حينذاك، وكان مقر الوزارة في مدينة الشعب، خاطبناه شارحين له الطريقة التي اختفى بها والدي واننا نريد ان نعرف اين هو؟ وماذا حل به؟! رد علي وزير الداخلية قائلاً:إذهب لـ«محسن» رئيس جهاز أمن الثورة حينذاك (يقصد محمد سعيد عبدالله..) ذهبنا لمحسن رئيس جهاز أمن الثورة مرات عدة، ولكن رده علينا دائماً كان:« إنه غير موجود لدينا أذهبوا لوزير الداخلية»، أجبته بأن وزير الداخلية قال انه عندكم. رد غير موجود عندنا.
قابلت علي ناصر محمد، أردف عبدالكريم قائلاً، هو يعرف الوالد جيداً ويعرف ما قدمه من دعم للثورة، بود ظاهر، صادق، قابلني (يقصد علي ناصر) واعداً إياي: «سأبحث عنه... كان الوحيد الذي مد لنا يد العون والمساعدة، وفي مرات عدة ومناسبات عدة.
باختفاء الوالد قضوا على مستقبلنا، انا لم أكمل دراستي اضطررت للعمل لأضمن لقمة عيش كريمة لاسرة قوامها عشرة أفراد.
كان على شمس صالح عاطف( زوجة صالح) مواجهة أعباء الحياة لأسرة قوامها تسعة ابناء. فقدان شمس لزوجها أبو ابنائها وابن عمها بهذه الطريقة، مثّل لها صدمة عنيفة، اسلمتها لعدوين لدودين هما السكن وضغط الدم، هي مازالت منذ 35 عاماً تنتظر الزوج الغائب عله يطرق الباب الآن مع كل مناسبة كرمضان أو الاعياد الدينية والوطنية تتقد جذوة الأمل في نفسها عله يعود، يفرج عنه وعندما تسمع ما يشاع احياناً حول عودة بعض من اختفوا وحالفهم الحظ ليرجعوا لأهلهم تسكنها حالة ترقب وانتظار عودة الزوج وابن العم لتجتاحها حسرة عندما يمضي الوقت ولا يطرق الزوج الباب.
عديدون تقدموا طالبين الزواج من بناتها، ترفض طالبة من المتقدمين الانتظار حتى عودة الأب!! ألم وأمل في آن.
يكمل عبد الكريم روايته عندما سألته عن مصير سيارة والدة، قال:« لم تظهر إلا في عام 1978 وكانوا يدربوا عليها سائقي تاكسي لأول مدير للنقل البري في عدن آنذاك» طالبنا بها ولم يعيدوها لنا رفضوا!».
ألم يصرفوا لكم راتباً أو معاشاً شهرياً. مطلقاً منذ اختفاء والدي وحتى اللحظة التي اخطابك فيها لم نتسلم حتى فلساً واحداً من أي كان في الدولة سواء هذه أو التي كانت قائمة قبلها قبل الوحدة». اتصل بكم اي من منظمات حقوق الانسان الوطنية أو الاجنبية؟!تقصد المنظمات الوطنية المنظمات المحلية؟ «لم يتصل بنا احد يا أخي، الناس على دين ملوكهم هنا في هذا الوطن. ربما هم أنفسهم لم يحددوا بعد حقوق اي انسان يقصدون!! منظمة ا لعفو الدولية اتصلت بنا واستلمنا منها رسالة من فرعها في السويد 25/3/1994 (تاريخ وصول الرسالة).
وكذلك اتصلت بنا منظمة أخرى ذكرو في مراسلاتهم انهم سيخاطبون الحكومة لمعرفة مصير والدنا. نحن لم ولن نيأس من المتابعة والمطالبة لمعرفة ماحصل لذوينا اذا كانوا؟ أحياء اين هم؟ وإن ماتو» كيف؟ نريد معرفة ملابسات موتهم وإن قتلوا بأي ذنب قتلوا؟! وأين جثثهم وقبورهم؟ وإذا لم نتمكن من الحصول على إجابة لهذه الاسئلة فأولادنا واحفادنا سيواصلون من بعدنا».
ندوة العدالة الإنتقالية وانتهاء حرب صعدة
ماذا عن مصالحة وطنية لا تنتصر للأقوياء وحدهم..؟
وضاح المقطري
يبقى دائماً في خروج بلد ما من الحرب ما يعني بالضرورة احتمال دخوله في حرب أخرى مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرب السابقة؛ ما لم يتم بتر أسباب هذه الحروب وتحقيق سلام قائم. على ثقة تامة بنتائج الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي تم بها إنهاء الصراعات، بتحديد أسبابها وإيجاد بدائلها المنصفة للفئات والطوائف المختلفة داخل المجتمعات المحلية كخطة مثلى لتحقيق العدالة الانتقالية؛ ذلك أن هذه العدالة لا يمكن تحققها بغير إنهاء أسباب الحروب المرتكزة بشكل أساسي في الظلم الاجتماعي الناتج عن سوء التوزيع، واستغلال الموارد الاقتصادية، والهبات الدولية لصالح الجهات والعشائر التي تحسب رموز الانظمة السياسية عليها.
في الندوة الإقليمية عن العدالة الانتقالية والنوع الإجتماعي التي نظمها منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، قُدم الكثير من الأوراق التي تحدثت في مجملها عن العدالة الانتقالية، وإجراءات تنفيذها، وطرق تحقيقها من جوانب حقوقية بحتة، ولم يتم الحديث عن إصلاحات سياسية وديمقراطية واجتماعية لتحقيق هذه العدالة سوى في لمحات ولقطات متفرقة منها ما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيسة منتدى الشقائق أمل الباشا، وأهمها وأوضحها ما قدمه الأخ سامي غالب في مداخلته من أن تاريخ اليمن تاريخ جماعات وليس تاريخ وطن، وهو زاخر بالمصالحات التي تتم بين هذه الجماعات التي يحتكر زعماؤها تمثيلها، فتقوم المصالحات على أسس غير حقوقية تنتقص حقوق الأفراد داخل هذه الجماعات، ما يعني أن مثل هذه المصالحات لا تحقق عدالة من أي نوع، لأنها لا تؤدي إلى التطهر من حمولة ماضي القمع والإلغاء.
قد ينطبق ما قاله سامي غالب على وضع المصالحة الحادثة الآن في صعدة بعد أربع سنوات من حرب لم يكن لها معنى واضح أو محدد، وانتهت مؤخراً باتفاق لم تتضح بنوده الحقيقية بعد، وإن كان على ما يبدو لا يحفظ للضحايا المدنيين قتلى وجرحى ومشردين حقوقهم أو يعيد لهم الاعتبار.
يتطلب الأمر دائماً إعادة البناء الاجتماعي، وتحقيق العدالة التوزيعية في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وصناعة وعي شامل بحقوق الإنسان والمواطنة والحريات وحركة تنقلات الأفراد والجماعات وحرياتهم الشخصية والجمعية وقناعاتهم الفكرية، ومساهمة كافة الفئات والطوائف والأجيال والأنواع في مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وحينها فقط يمكن الحديث عن قيام ثقافة سلام بديلة لثقافة الحرب.
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن إلغاء الانقسامات الداخلية، وإيجاد وحدة حقيقية من خلال مشاريع التنمية ونشر ثقافة و طنية وعلمانية تتجاوز الانتماءات القبلية والدينية أو تلغيها، ما يؤدي بالضرورة إلى إصلاحات قضائية وقانونية تكفل تحقيق المواطنية الخالية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو ا لطائفة أو الدين، وأضع خطاً تحت كلمة «الدين» هنا، كي نتذكر أنه تم ويتم إلغاء الحزن الإنساني فيه، واستخدامه في حروب الإبادة؛ لأن كل طائفة ترى أحقيتها المطلقة في احتكار الحقيقة في وجود دافع اقتصادي غالباً ما يدفعهما بالتالي إلى إلغاء الآخر وحقه في التفكير والوجود.
وعن أطر تحقيق عدالة انتقالية، فإنه ينبغي الانتباه إلى أنه لا بد من معادلة إنصاف تراعي خصوصية كل مجتمع على حدة، من أجل إيجاد تكافؤ بين طريقتي العدالة الانتقالية، وهما المعاقبة القانونية والمصالحة، حيث ان معالجة آثار الحروب في نفسيات الأفراد والمجتمعات المتخلفة قد لا تكون ممكن بالمصالحة وحدها، نتيجة للعديد من الموروثات القبلية والدينية، وتعقد البنيات الاجتماعية والنفسية في المجتمعات المحلية، وبالتالي لا بد من العمل بطريقتي العدالة مجتمعتين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفير كافة الإمكانات التي تحقق الأمان المستقبلي للجناة الراغبين في الإعتراف بخطاياهم من ثارات أو عمليات انتقام قد تحدث لهم من قبل ضحايا مفترضين. وفي رأيي الشخصي أن جيلين على الأقل يتأثران بالحروب ومآسيها، أحدهما هو الذي شهد المآسي بنفسه وعايشها عن قرب، وتأثر بها بعمق، ولهذا فمن الصعوبة إقناعه بمسألة العدالة دون أن يشهد بنفسه عقاباً قانونياً للجناة. فيم يكون الجيل الآخر غير شاهد على مآسي الحرب مباشرة، وإنما جاء على إثرها وطالته آثارها، ما يجعل من الممكن جداً إقناعه بالمصالحة وخلق روح التسامح لديه بواسطة الإجراءات الممكنة على المستويين الحقوقي والاجتماعي السياسي.
ولأنه معلوم أن المجتمعات النامية ما زالت تعطي الدين مساحة واسعة لتحديد قراراتها المصيرية، وبالتالي فإن ثقافة التسامح في المجتمعات الطائفية تواجه بصعوبات بالغة تتمثل في عدم القبول بالتسامح والتصالح مع الطوائف الأخرى، ويتم الاحتكام فيها إلى شرائع تُطبق أحكاماً قضائية غير إنسانية أو عصرية، تتمثل في العقوبات البدنية التي أبرزها الإعدام، كما يحدث في القضاء الإسلامي مثلاً.
إلى ذلك ينبغي أيضاً السرعة في تأهيل مشاريع العدالة الانتقالية سواءً القائمة على المعاقبة القانونية، أو المصالحات وجبر الضرر بالتعويضات المادية والمعنوية، فكلما تأخرت العدالة في الحضور كان حضورها أصعب، إذ تتعمق الآثار النفسية، وربما تمكن الجناة من الهرب، أو قد يموت الشهود أو الضحايا أو الجناة، وفي تأخر تحقيق العدالة تهيئة لصراعات جديدة.
إن استمرار الأنظمة العسكرية والقبلية السياسية الحاكمة المتسببة أصلاً في النزاعات، والمساهمة في حروب الإبادة، يعطل إمكانية تحقيق عدالة انتقالية إلا على هيئة مكرمات تقدمها هذه الأنظمة للشعوب والجماعات، أو بطريقة مصالحات بين الزعماء، على الطريقة التي ذكرها الأخ سامي غالب، تلغي دور الأفراد وتنتقص حقوقهم. وعليه لا بد من الضغط على هذه الأنظمة وإجبارها -بشتى السبل- على القبول بديمقراطية حقيقية تحترم اختيارات الشعوب.
يبقى القول إنه يصعب علينا التفاؤل بإمكانية مصالحة وطنية حقيقية في اليمن، تلغي كل أحقاد وصراعات الماضي، وتعيد عتبار للضحايا، وتكفل حقوقهم، وتعطي للجناة فرصة الاعتراف بخطاياهم والاعتذار عنها، والاندماج في المجتمع دون خوف من نار أو قصاص، فالسلطة دأبت على فتح ملفات منتقاة من الماضي للتشهير بخصومها، أو تأجيج الكراهية، متغافلة عن ملفات كثيرة، وقضايا لا تحصى، ومستمرة في سياسات تنتهك الحقوق في كل مكان كأنها تحرص الناس ضدها، غير عابئة بمطالب شعبية تنشد مصالحة وطنية لا تنتصر للأقوياء وحدهم.
***
إدارة مكافحة الإرهاب تحقق في التهديدات التي استهدفت محرري «النداء»
بدأت الإدارة العامة لمكافحة الارهاب في وزارة الداخلية تحرياتها بشأن التهديدات التي تلقتها «النداء» جراء نشر ملف المختفين قسرياً.
وكان اللواء رشاد العليمي، وزير الداخلية، وجه الخميس الماضي الإدارة بالتحقيق في الموضوع، وذلك بعدما نشرت «النداء» في عددها السابق خبراً عن «مجهولين توعدوا محرريها بالعقاب في حال تابعت الصحفية النشر عن ضحايا الاختفاء القسري».
وكان الزميل فهمي السقاف، الكاتب الصحفي المشارك في تحرير ملف المختفين قسرياً من عدن، تلقى منذ نهاية مايو الماضي اتصالات هاتفية من مجهولين توعدا محرري الصحيفة بالعقاب في حالة تابعت الصحيفة نشر الملف. وتوعد أحد المتصلين محرري «النداء» بتحويلهم الى مختفين قسرياً في حال متابعة النشر.
واستخدم المتصلون لغةً مناطقية وعنصرية حيال الضحايا ومحرري «النداء» وبخاصة رئيس التحرير. واعتبر أحدهم محرري الصحيفة عملاء «يتلقون التعليمات من أسيادهم في الخارج»
ولم تتلق « النداء» أية اتصالات منذ نشر الخبر الأسبوع الماضي.
***
(7)المختفون قسرياً
الانتصار للضحايا لا يعني حفر قبور لجناة نفذوا أمر قيمنا الحاكمة..
«النداء» كـ«مهدد بالاختفاء القسري».. ضد الاشمئزاز، وبحثا عن طرق للتطمين
نبيل الصوفي
nbil
ليس الوقت ملائما لتبادل المجاملات بشأن جمل وأفكار احتوتها افتتاحية ما نشره العدد الماضي من "النداء"، بشأن ملف المختفين قسرياً. الأهم بالنسبة لي أنها ورغم شكواها الحادة من "شياطين التأويلـ" بما هي الطابور الأول، والأكثر جاهزية ومبادأة، في جيوش دويلات الحرب، المشتبكة غالباً، والمتعايشة أحيانا داخل الوطن الافتراضي. لم تغرني أبدا على مجرد التعاطف.
الشكوى، ولجديتها، جعلتني أصطفّ مع "الضحايا"، ولا أقصد بهم ضحايا "الإخفاء"، بل ضحايا "الكشف". فهم وإن كنت متفقا مع زميلي سامي غالب على أنهم دأبوا "على مدى سنوات، على تطوير آليات حمائية تحول دون تسرب ضحايا الاختفاء القسري إلى «سوق السياسة» التي يتوزعها حفنة من الكبار (الصغار) لا يقيمون وزناً لحقوق المواطنة في تجاذبهم وتنافرهم". فإني أعتقد أن علينا –ونحن نتحدث عن قيم جوهرية لم تكن حاضرة إلا بقدر كونها أداة لتمرير السياسة، كالعدالة والإنصاف والمصالحة مع القيم والقانون لا مع الأشخاص والمواقف والتحالفات- أن نسعى أيضا لتطمين الكان جانياً بأننا ومهما كان موقفنا ضد ما ارتكبه لا نهدف لـ"تكرار فعلته" عبر تحويله هو إلى ضحية. إذ نعرف تماما أن الحركات الوطنية في العالم الثالث لطالما عذبت من اتهمتهم بالتعذيب، وانتهكت حقوق من تتهمهم بانتهاك الحقوق، وهي لعبة في تبادل الأدوار يجب إيقافها، إن أردنا فعلا التأسيس لعهد لا اختفاء فيه.
لا أقول هنا ما يناقض الشكوى، فلقد تمسكت هي بقيم من قبيل "التغطية الموضوعية المعمقة والمستمرة، المنزهة من التحيزات السياسية والعقائدية"، وهي قيم جليلة، باعتقادي أن غيابها هو سبب تتويج نضالنا الدائم بالإخفاقات، مقابل احتفاظ "الثوابت الوطنية والقضايا الكبرى بقوتها الأدائية الرهيبة، عابرة الأزمان والمصالحات والاتفاقات"، صانعة الكوارث ذاتها، ولكن بمبررات تختلف حسب لون وراية كل فترة وعهد. لكنها تحافظ على ذات الأساليب. (شعرت بالقشعريرة وأنا أستمع لقادة من حماس وهم يتباهون بما يقولون إنه صور مخلة بالشرف لخصومهم السياسيين!! وتذكرت كم مرة حدث ذلك صانعا الإخفاق المادي وليس فقط القيمي للعرب والمسلمين، مع الاعتذار لعظماء تلكم الحركة وحكمائها الأحياء منهم والأموات بالطبع).
باعتقادي أننا –كمجتمع وليس كصحيفة، بل وبدعوة منها- مطالبون بأمر هو شديد الحساسية، يتعلق بحاجتنا الحقيقية لوضع مسافة بين الحق والجنحة. ولذا فإني أتعاطف مع "الجناة" وهم يدينون تصدر "النداء" للدفاع عمَّن يعتقدونهم "مجرمين وأعداء للأوطان وللمصالح العليا" يوم كانوا أحياء. ومكمن تعاطفي لا يصل حد إدانة "النداء" وهي تقوم بواحد من أفضل وأهم أدوار الصحافة، وإنما فقط لفت الانتباه إلى أن محاكمة الأمس بمنطق اليوم لا تحقق الإنصاف مطلقا، وإنما تمد عمر الإرباكات. أتحدث هنا عن خطورة أن يتحول كل مختفٍ –بما هو عرضة للعقاب- لبطل قومي مجرد من الأخطاء، إذ لا بد من الإقرار أن الجميع يومذاك كانوا في سباق على الانتهاك وأدواته، والفرق فقط أن من سبق وامتلك الأداة نفذ بخصمه ما يعتقده عقابا طبيعيا.
ثم إن "جناة" الزمن القديم، لم يكونوا خارقين للثقافة العامة وللتعاليم الأيديولوجية، بل لقد كانوا أوفياء للتجربة السياسية للثورات العربية، بل وللنصوص القانونية والتشريعات الدستورية. ومن هنا فأعتقده تجنيا أن يطلب منهم وبشكل شخصي أن يدفعوا الثمن، لمجرد أن الحياة القانونية والحقوقية والسياسية الوطنية قد تطورت أو بالأدق "تغيرت".
إننا لن نحقق عدلا لـ"فلان" بما أنه "ضحية" إلا عبر مساواة حقيقية بين الحقوق والواجبات، ووضع أبعاد محددة ومتساوية الأضلاع بين الأداء والوعي العام من جهة، والأداء والوعي الشخصي من جهة أخرى، سواء تجاه "الضحية" أو "الجاني".
أعتقد إننا حينذاك لن نجد مسؤوليات فردية تستحق أن نخوض أشواطا إضافية من الانتهاكات والصراعات والتهديدات بين الجناة والضحايا، خاصة في اليمن التي لم يكن لمثل تلك الممارسات إرث اجتماعي فني، خلافا للإرث الإطاري أو النظري، لكنها نتجت عن مشروع دولة الثورة الجنوبية أو الشمالية وما رافقه من تصدر تقنيات "ثورية" لحماية المصالح والأفكار في العالم المحيط، وكلٌّ تجاه خصومه، هذا من حيث المبدأ، وبالطبع لا بد أن هناك استثناءات، لكننا لا نتحدث عن ذلك.
هل لديَّ جموح لأكون أداة تعذيب إضافية لأهالي الضحايا؟
للتمسك بحقي في الدفاع عن رأيي، ورفض تهديدي بمصير المختفين بحجة الدفاع عنهم، فسأجيب بـ"لا". وأعتذر من نساء ورجال حفر العمل السياسي والنضال الوطني معالمه في حياتهم الشخصية عبر أقذر الأدوات وأكثر نتائجها كارثية. خاصة وأنهم –اليوم، واستنتاجا مما ينشر- لا يطالبون سوى بمعرفة مصائر ذويهم، وغالب بل كل من نشر عنه حتى الآن لم يعرف بأدوار سياسية وقيادية، بل لعلهم كانوا ضحايا أخطاء ولربما صراعات شخصية.
لكننا في مرحلة تأسيس حقوقي تربوي، وما لم نقر بذلك، ونكتفي بالتحايل على الموانع منها أولا، فإننا سنقع في "الأفخاخ" التي لطالما نصبتها السياسة للحقوق وللقيم بمجملها.
إننا جميعا ما زلنا غير قادرين على تحقيق المبدأ المجرد "ولو على أنفسهم". ولن نعدم أمثلة لمن يطالب منا بالحرية ثم يضيق بأبسط واجباتها حين يكون هو الطرف المتضرر –حسب اعتقاده- منها، ومن يطالب بالعدل، وهو لديه فقط سلاح للدفاع عن الذات. أما بشأن الآخر وبخاصة المختلف معه فالعدل يصبح فائضا مؤذيا من المطالب. ومن هنا فلا مناص من تجنب الشعور بالاشمئزاز مهما كانت ردود الفعل، إلى البحث عن "غرس" عوامل للطمأنينة لدى الجناة وهم نحن جميعا، بالمعنى التربوي والثقافي، بأننا نسعى فقط لقلع الثقافة الصانعة والمنتجة والحامية لتلك الانتهاكات، بانتظار مرحلة أخرى تكون الانتهاكات صارت "جنحة" سياسية واجتماعية، وليست فقط قانونية كما هو حاصل الآن، ليحق لنا بعد ذلك أو لضحايانا أن يحاكمونا أخلاقيا وقانونيا. أو أن نحاكمهم هم بذات الأدوات حتى لا تصبح القيم وسيلة الضعفاء فقط ليصبحوا الأقوياء.
لعل هذه هرطقات، لن تفضي إلا لتعويم المسؤولية. لكني ومن موقف الإصرار على أن "العدالة الانتقالية" بمفهومها الفني، هي ذكاء إنساني يستجيب للخصوصيات الاجتماعية والثقافية، أعتقد أننا نريد، أولا: الانتصار لأهالي الضحايا الذين لا يستطيعون بالضبط تحديد "وضعية" مفقوديهم. وثانيا: إيقاف عجلة الاستهتار بحياة الناس وبخاصة منهم، بل وقصرا المعارضين سياسيا أو فكريا لمراكز القوة في الحكم أو في المجتمع، ومنع شهوة الانتقام سواء تلبست بدعوى الدفاع عن المصلحة والقانون، أم بالثأر لهذه المصلحة والقانون مع تبدل الأدوار والإمكانيات.
وثالثا: حماية الجناة من مصير مشابه للضحايا، وإخلاء ساحتهم من المسؤولية الأخلاقية، وبشكل غير مباشر، خاصة من يساعد منهم بما لديه من معلومات عن الضحايا.
ورابعا يأتي الانتصار للضحايا، والذين لن تعود من أزهقت أرواحهم. ويمكن القول وبصوت خاشع خجل، إن تحويل تضحياتهم إلى إرث عام، وحق عام، يسعنا جميعا كجناة عليهم -مع تخليد تجربتهم- وحدها الوسيلة لأن تضيء للبلاد حياة آمنة من الكوارث.
خلاصة الأمر أن المطلوب، أو المقترح هو أن لا "تحيا أسر الضحايا وحدها في الماضي"، ولا أن "تجرنا معها لنحيا الماضي"، بل فقط أن ننتقل معا لنحيا الحاضر والمستقبل مستضيئين بتضحيات كل يمني كان ضحية، بتخليد حياته التي دفعها ثمنا لأخطائه وأخطاء خصومه، أو جانيا، بحماية إنسانيته التي سلبتها معتقداتنا وإرثنا وصراعاتنا فاعليتها يوم لم نكن نؤمن بأن أي عقوبة تتجاوز الجنحة تصبح جرما يسقط عن فاعله أي دعوى بالفضل والفضيلة.
***
الشقائق تثمن فتح «النداء»
لملفات صامتة وشائكة
الأستاذ/ سامي غالب المحترم
الأعزاء هيئة تحرير صحيفة «النداء» المحترمون
تحية طيبة وبعد،،،
يسعدنا في منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، أن نعرب لكم عن بالغ تقديرنا لما تقومون به من جهد صحفي حقيقي في نصرة القضايا الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان. ونحن نعتبر مبادرتكم لفتح ملفات حقوقية صامتة وشائكة في بلادنا والدفع باتجاه حلها بشكل منصف وعادل تعبيراً عن تميز «النداء» وتأكيداً على انتصارها الحقيقي لقيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
إن ملف المختفين قسرياً، وملف السجناء المعسرين، وكافة الملفات، التي تعمل عليها صحيفتكم، هي ملفات هامة، نعتقد أن دوركم الريادي والمهني في طرحها للنقاش والبحث عن الحلول هو دور يستحق التقدير والاحترام والدعم. ونعتقد أن فتح هذه الملفات بداية لعمل حقوقي ومجتمعي لرفع الظلم وكشف الحقائق. ولا ننسى أن نعبر عن تضامننا معكم ضد تلك التهديدات الخرقاء التي نجمت عن إثارتكم لملف الاختفاء القسري، ونحن أكيدون أنها لن تثنيكم عن القيام بدوركم المتميز.
وتفضلوا بقبول خالص تحيات الشقائق،،،
أمل الباشا - رئيس المنتدى
***
أن تختفي دون أن يعلم أحد
إلهام الوجيه
متى يفهم الجميع بأنهم ليسوا مجرد أسماء وأحرف متناثرة على أوراق الصحف وألسنة منظمات الدفاع عن الحقوق وعن الانسانيه المهدورة، بمرأى ممن يدعون ويتشدقون بإحقاق العدل وترسيخ العدالة؟!!
إنهم أرواح اختفت دونما أسباب اقترفتها سوى أنهم حملوا بداخلهم أفكار وولاءً سياسياًً لم يُرض البعض عنه.وربما لم يكن لهم في السياسة ناقة ولا جمل، ولم يكن لهم ذنب يذكر، سوى أنهم وضعوا دون ضمير على لائحة غيرالمرغوب فيهم منهين حياتهم دون أدنى حق لمن فعل ذلك ودون منح للضحية حق الرفض أو حتى المقاومة!
ما معنى أن تختفي قسريا ؟
معناه أيها السادة الرافعون أعينهم استغراباً أو استخفافاً بهذه القضية، أن تُقتل ولا يعرف أحد بموتك، ويخمنه الأحباء من خلال اللاعودة التي تزداد وضوحاً كلما مر يوم آخر على اختفائك، وانقضاء الزمن دون أدنى أمل بالرجوع !
وفي أحسن الحالات ربما تكون مرميا في زنزانة لايعرفها حتى من أمر بحبسك لتسقط بكل بساطة من كشف الأحياء، وتدخل عالم من النسيان، الذي لايرحمك، ولا يرحم من ينتظرونك...
وهنا أتساءل، ألا تتساءلون معي: هل من الصائب تسمية الاختفاء القسري بذلك الاسم أو أن نطلق عليه أسمه الحقيقي، دون تزييف وهو جرائم قسريه، وقتل وحشي لايمت إلى روح الأنسانيه بصلة! ؟
إن ملف المختفين قسريا هو الملف الأكثر إيلاما، والأطولٍ عمراً، كونه ملفاً مليئاً بالتساؤلات: لماذا، وكيف، ومتى، وأين ؟؟ولكون عمره ممتدا بين أمل ويأس وشك ويقين القابعين خلف سراب الوهم والانتظار...
وعندما تقرر الصحافة وبلمسة إنسانية خالصة فتح هذا الملف المغلق. فهي كمن يفتح النار عليها من جميع الجهات؛ فالجميع متورطون، والجميع قد يكونون شارك، بتلك الجرائم، تحت مسميات عديدة ومختلفة باسم الدفاع عن القضية، أو الحفاظ على النفس والمصالح. ومعنى أن تطرق الصحافة هذا الباب فهي كمن يطرق باباً للفجيعة والألم، ولن يتحرك بداخله سوى الغول النائم عن جرائمه، المتلبس طيبة عبر الزمان المليء شراً ووحشية. يعيش بيننا اليوم وكأن يديه لم تقترفا شيئا يوماً ما، في زمن ما.
كما أن تسليط الضوء على أسر المختفين قسريا، بقدر ما يبعث في قلوبنا رعشة الرهبة والرأفة، بقدر ما يجعل الأمر حقيقة قائمة وليس مجرد أكاذيب وإثارة، لا أكثر. نعم من حق الصحافة أن ترفع صوتها عاليا ضد كل من يحتكر حق الحياة والكرامة، لتطالب بمطالب عادلة,ألا وهي مطالب الناس قبل أن تكون مطالبها هي: من الإيمان بحق الحياة والحرية والمحاكمات العادلة وعدم التعذيب، إلى المطالبة بظروف احتجاز إنسانية وأي خروج على ذلك هو جريمة،لابد أن نعاقب عليها المقترفين لها والتساهل أيا كان، سيقودنا ذات يوم إلى أن نختفي دون أن يعلم أحدا ممن حولنا متى وأين نحن؟؟ والمختفون قسريا هم أحد هذه الجرائم البشعة والكثيرة العدد والبعيدة الأثر...
نعم أعلم أن ما يحدث لنا في الغالب قسري، لايد لنا فيه، كأن الحياة من حولنا تفرض علينا قسرا ما لانريد. ولكن استخدام القوانين الأستثنائيه لأغراض خاصة، ضحيتها هو حياة الإنسان، فهذا ما لايعقل أن نقبل به بجانب ذلك أبدا.
قرأت أن صحيفة "النداء" تعرضت لتهديدات من مجهولين، كعادة من يقترب من الخطوط الحمراء والمحرمة، وقرأت بالمقابل عن تعاون الأجهزة الأمنية مع الصحيفة ضد هذه التهديدات !!
ما يشعرني بالحيرة هو: ما مدى جدية الأجهزة المعنية بالبحث عن حقائق قصص الأرواح الهائمة حتى اليوم، دونما نهاية موثقه أو معترف بها،مقارنة بجديتها في حماية الصحيفة والقائمين عليها من هذه التهديدات!؟..
وبدلا من مراعاة الصحيفة، أفلا نحترم هذه الشجاعة التي تسلحت بها، وهي تفتح هذا الملف الغامض، بالبحث جديا عن المختفين وتخفيف الألم النفسي الأعمق الذي خلفه ذلك الاختفاء في نفوس الأرامل واليتامى من أسر المفقودين !؟ ليس ذلك استنقاص لما يمر به الباحثون في هذا الملف، ولكنها كلمة حق عن معانات أسر المختفين، وطول استمرارها، حيث لانهاية تلوح في الأفق لتنهي حياة البرزخ التي يحياها المختفون المتأرجحون حتى اليوم.. فلا هم من الأحياء ولاهم من الأموات !!
ألم حاضر
الخيواني... أغنية البائسين والمخنوقين والمتسلقين والمتشدقين والمتحررين والمستبدين... لقد أختارك الإجماع على أن تكون كبش فدائهم، وعلى أن تكون مظلتهم وممثلهم، الذي يؤدي دوراً بالنيابة عن الجمع نفسه الذي يتفرج عليك فقط، وأنت ترقص رقصة موتك الأخيرة، وربما ليست الأخيرة، فالخير لاينفذ عند أهل الخير.
الخيواني... وسيلة السلطة لضرب الأمثال للناس لعلهم يتعضون، ووسيلة المعارضة لضرب أمثلتها للناس من اختباء أمام ما يحدث لمن تتشدق بالدفاع عنهم...
لماذا لم نتحدث حتى اليوم ونعتصم بساحة الحرية لنرفض ما قام به الحزب تجاه الخيواني والاستغناء عنه، دون إنذار أو مبرر، سوى ما في نفس يعقوب وذلك لايعلمة إلا الله والحزب، بينما نكاد نقتلع عيون السلطة غضبا لأجله...!؟
ليكن غضبنا عادلا ورفضنا لما يحدث عادلا...فذلك الشجاع المرمي وراء الزنزانة لم يقل يوما إلا ما آمن به، ولم يدافع يوما إلا عنا جميعا.
***
الابتسامة التي نجت من الشنق
محمد عثمان
Hide Mail
أحد لا يقدر أن يقول ما حجم حصتها، فيما مضى، من تلك الحاجة الإنسانية البسيطة، غير الملحوظة تقريبا، التي تجعل الواحد يسعى بين وقت وآخر إلى تبديل موضع الجلوس أو الرقاد داخل الحيز الخاص المسمى المنزل. ما يمكن البت فيه بسهولة، استنادا إلى راهن حياتها، أنها بددت الحصة، أبطلت مفعول الحاجة. أو أنها، في أسوأ تقدير، تضطر إلى الدخول في عراك داخلي معها، لتخرج، في كل مرة، من العراك منحازة تماما إلى مكان جلوسها المعهود، الأزلي حتى، على ذلك المقطع من القطيفة البرتقالية، موشاة برسوم لزهور بحجم ناقوس تقريبا، تمتد طوليا بمحاذاة جدار حجرة الجلوس في منزل ابنها. المقطع في مواجهة باب الحجرة تماما، حيث يسعها من هناك، فيما تريح ظهرها إلى المسند وراءها أو تميل يسارا على "المكرت"، أن تمتلك بصريا، عبر فرجة باب الحجرة، كامل الفجوة التي تشغلها "درفة" الباب الخارجي الواقعة عند طرف "طرقة" داخلية تتفرع عن الصالة، عند النقطة المقابلة لباب الحجرة تماما، وتنار بلمبة اسطوانية ساطعة طوال الوقت. في الواقع، هي لا تبارح ذلك الموضع معظم الوقت باستثناء إذا ما دعت ضرورة إلى التحرك هنا أو هناك داخل المنزل، كأن تلتحق بزوجة ابنها في المطبخ لمد يد العون أو الذهاب إلى جانب "الطرقة" حيث المخزن الصغير الذي تخبئ فيه مؤونتها الخاصة من التمباك والفحم، أو الذهاب لتطمين النداءات النزقة، للفت الانتباه، يصدرها حفيدها، ذو الثلاث سنوات، من مكان ما في المنزل. أو إنجاز تحركات قصيرة، بلا غرض تقريبا، سوى إعاقة تجمد الدم في العروق من فرط ملازمة الموضع الذي منه تحرس "درفة" الباب بحدقات عيونها. تحرس من سنوات. وذلك أنها تنتظر. مرارا وتكرارا تجد نفسها غير بعيدة عن توقع وصوله في أية لحظة. مترددا، وعاجزا عن تمالك نفسه، تتخيله وراء "الدرفة". تهجس خشخشة أصابعه عليها. تفزع من مكانها. تهرول عبر باب الحجرة، تجتاز الصالة، راكضة على امتداد الطرقة الداخلية. تصل. تدير الأكرة، جاذبة، في الآن نفسه، الدرفة الخشبية المدهونة بالبني إلى الداخل. يحدث ذلك بسرعة كبيرة وكأنها تخشى أن أدنى تأخير سيجعله، متآسيا، ينسحب أو سيجعل من اختفائه اختفاء مؤكدا، لا رجعة فيه. تتصرف على هذا النحو من قديم. من قبل أن تحل في هذا المنزل. تحديدا، منذ أن كانت ما تزال تعيش في القرية حين، ذات يوم، انقطعت أخباره عنهم نهائيا. حتى أن أفراد أسرتها ومعارفها لا يجدون في تصرفها مؤاخذة. ينظرون بتفهم إلى عمق الدافع. فيما عدا أنها، في كل مرة تقوم بذلك، لا تصطدم نظراتها بأحد أو بشيء سوى الحيز الذي كان ليشغله جسده.. فيما.. فيما لم تتأخر عن فتح الباب. أو فيما لو، عن البقعة المظلمة التي خلفتها حادثة اختفائه في الذاكرة، تنفك ملامحه. ملامح ملائكية تُهاجم من سنوات من البقعة التي ما فتئت، بلا هوادة، تتفاقم في انتظار لحظة الحسم، لحظة محو تلك الملامح. لكن هيهات، "ليقتلوني قبلهِ". تجزم أمام الجارات اللاتي توافدن، بعد الظهيرة، لزيارتها، دون أن تحيد بعينيها عن الملقط، في يدها، بكشطات أفقية، متأنية، يزيل الرماد عن الجمرات المتوهجة داخل موقد معدني ينتصب على مسافة قصيرة من المقطع حيث تجلس من زمان. باحتدام داخلي مسيطر عليه، تجبر الجمرات المتوهجة على الاندساس بين فكي الملقط. تحرك الملقط باتجاه اليد الأخرى التي تمسك، من قاعدته، مايشبه قمعا خزفيا تتقاطع على سطحه الخارجي المشرخ أسلاك معدنية دقيقة. واحدة تلو الأخرى، ترصف الجمرات فوق حفنة التبغ، داخل الشكل القمعي. ترفعه إلى أعلى من مستوى رأسها. تثبته على القمة المخروطية لعمود أسطواني، أجوف، خشبي وملبس بالفضة من الخارج، ينتصب أمامها منحدرا وسط تكورات متفاوتة الحجم، على مسافات منتظمة، ليتوارى طرفه الأسفل وسط انتفاخ معدني حيث تتصاعد القرقرة مع كل نفس يمتص من المبسم. المبسم موصول بقصبة، مكسوة بقماش أبيض وكحلي، تتناثر في حلقات على أرضية الحجرة، فيما طرفها الآخر مثبت داخل زائدة تشذ عن الانتفاخ المعدني. أبعدت المبسم عن شفتيها ونفثت الدخان: ما بقي إلا هذا، يخلونا ننسى". كان ذلك بمثابة خاتمة للاستغراق الذي لازمها أثناء أداء الطقوس مستمرا إلى لحظة نفث الدخان. "لكن أبعد عليهم من نجوم السماء"، تجزم فيما تمد المبسم إلى إحدى الجارات. في الواقع، هي لا تشعر بالرضا عن نفسها في أي شيء بقدر هذا: الإبقاء على ذكراه طرية في ذاكرتها. كل الجهود التي بذلت مع جهات حكومية ودولية لمعرفة مصيره ذهبت أدراج الرياح. قبل ثلاث سنوات لجنة موفدة من وزارة حقوق الإنسان طرقت الباب. استبشرت خيرا. لكن بعد أخذ ورد مع أفراد اللجنة أتضح لهما، هي وابنها، أن لا هدف للزيارة سوى شطبه من قائمة الأحياء أكثر مما هو مشطوب. إهالة تراب جديد عليه فوق التراب القديم. "جئنا نتوسل موافقتكم لإغلاق ملفه والتوقيع على شهادة الوفاة. خاطبهما رئيس الفريق مشيرا إلى المختفي بضمير الغائب وشاهرا، في نفس الوقت، شهادة الوفاة أمام اعينهما. "شهادة وفاة؟!!"، سبقت ابنها إلى الصدمة: "نوقع على شهادة وفاته؟ هكذا بدون أدلة وبدون أن نعرف إذا كان حي أو ميت ولا أيش اللي حصله بالضبط؟ هذا يرضيكم بالله؟ ضعوا أنفسكم مكاننا وبعدين شوفوا". وبدا أن كلماتها اخترقت أعضاء اللجنة في الصميم. لكن ما تلا تكفل برفع الغشاوة. بعد صمت متعاطف ودون أن يخلي وجهه لافتة الشفقة، عاد رئيس اللجنة إلى الحديث. هذه المرة بدا حريصا على توجيه كلامه إلى الابن: "أنت متعلم!!"، نقر على ما ظنه الوتر الحساس، وأقعى لوهلة يتكهن ردة الفعل، "ولا أظنك تجهل ما يترتب على التأخر في إيجاد الحلول لهذا الملف ( يقصد ملف المختفين قسريا) حياة أبوك غالية، لا خلاف على ذلك، لكن أبوك هو مواطن واحد، ونحن في وضع يفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالح ملايين المواطنين، الذين سيتضررون من جراء بقاء هذا الملف مفتوحا. هذا الملف يهدد حتى المصالح العليا للوطن". وأبقى نظراته في عيون الابن تتوسل التأثير المطلوب. "أيش قصدك بالمصالح العليا للوطن؟"، نجح الابن في التصدي للتأثير. تلبك الآخر. تغلب على تلبكه: "أنت تعرف الوضع الاقتصادي للبلد وتعرف أيضا أن لا حل للتردي خارج إطار المساعدات والقروض التي تقدم من دول مانحة، لكن هذه المنح صارت مشروطة اليوم بحالة سجل البلد في مجال حقوق الإنسان". "دلونا على مكان أبي أو قدموا أدلة قاطعة على موته وسجل البلد بيتحسن، ابعدوا عن أذهانكم أننا سنوقع على شهادة الوفاة قبل ذلكـ"، قاطعا، جاء رد الابن. ولد الابن قبل اختفاء أبيه بأسبوع.. مضى على اختفاء الأب حتى اليوم تسعة وعشرون عاما بالتمام. ما يعني أن عمر الابن يتفوق على عمر اختفاء الأب بفائض أسبوع. كل عام، بمجرد حلول الذكرى السنوية لاختفاءه، تغرق الأم في الحسابات، مكتشفة أن عمر الابن ما يزال يتفوق على عمر اختفاء الأب بنفس المقدار. دائما ثمة أسبوع فائض في خزينة عمر الابن. من جهة أخرى، كان عمر الأب حين الإختفاء عشرين عاما. وبما أنه لا يسعها أبدا أن تتصور كيف يمكن لأحد أن يكبر بعيدا عن أسرته ومحبيه، وبشكل خاص لو كان هذا الأحد مختفياً قسريا. فإن عمر الأب، أينما كان مكان الاختفاء، سيظل، على الدوام، عشرين عاما.. لا شك أن التفكير على هذا النحو يبعث على العزاء، لكنه في الوقت نفسه يفقش القلب. فإذا كان الأب لما يزل في العشرين من العمر، فلا مفر من مواجهة حقيقة أن عمر الابن يتفوق على عمر الأب بتسع سنوات. عمليا، صار الابن مسؤولا عن أسرة صغيرة، ناهيك عن مسؤوليته عنها: الأم، وعن الأب كذلك بما أنه، منذ سنوات، لا يتوقف عن التقصي عنه مخاطبا جهات محلية ودولية، وذلك يتناقض مع طبيعة الأمور. بحنو متآسٍ تتابع، من يوم إلى يوم، تراكم الشعرات البيضاء في مفرقه و فوديه، وتغرق في الحساب. منذ تسعة وعشرين عاما وهي تحسب، ليس لأنها تجد في ذلك غواية من نوع ما، لكن لأن ما من خيار أمام المنتظر سوى الحساب. إنها تتوق لعودة الأب، على الأقل لكي تَسْكَه من تعب الأرقام، لكي تكف عن حساب عمر الابن انطلاقا من تاريخ اختفاء الأب. ما ذنب الابن لكي يشب ويكهل ويشيخ في ظلال تواريخ جريحة؟ إلى متى سيظل يجرجر عمرا معلَّما بطعنة؟ كلا. ليس عدلا أن يستمر الحال على ما هو عليه. ليس فائضا عن الحق أن يجيء اليوم الذي ينفك فيه عمر الابن عن عمر الاختفاء لتنسرح حياته، هكذا، في مجرى لحاله. مش كثير على القدير الجبار الذي هو فوق الناس كلهم أن يعجل باليوم الذي يتحرر فيه الأب من قبضة اللا زمن الغليظة بما يسمح له، ولها أيضا، أن يتقدما في العمر شأن الآخرين. زمنها، هي الأخرى، لا يشبه زمن الآخرين. زمن الآخرين سائل. زمنها ينكفىء على نفسه، في بقعة واحدة، مثل سكبة دم متجمدة، بأي حال من الأحوال، لا تسمح لأي كان أن يرش عليها ماءاً فتتبدد. لسبب لذاته، ربما، أن زمنها لا يشبه زمن الآخرين، وفر شبابها نفسه: ذلك التورد الطبيعي في الخدين، النعومة في الكف، وذلك الوميض الذي لا يتناقص من عينيها مهما تتكلم أو تضحك. كأنها أرادت، حين عودته، أن تكون له دون أدنى تبديل. لكن الفريق الذي قدم إلى المنزل قبل ثلاث سنوات بدا معزولا عن هذه المرارات، متعاليا على التطلعات، بل متعاليا على حياتها وحياة أسرتها بالكامل. ما أراده فحسب، جعل عمر الاختفاء عمرا مفتوحا لا نهاية له. لكن هيهات. "قولوا لنا فين هو أو هاتوا أدلة على أنه مات وسجل البلد بيتحسن، بدون هذا لن نوقع على شهادة وفاة"، بطريقتها الخاصة، رددت على مسامع أعضاء اللجنة، ما قال الابن. وبدا رئيس اللجنة مستنفدا كل الوسائل. لم يتبق أمامه سوى الإمساك، بمن يفترض انه ليس الخصم، من اليد المصابة: أنت تعرفي أن الجهات التي كان يعمل فيها المختفون قسريا تشترط شهادة الوفاة للاستمرار في صرف الراتب، على الأقل علشان..علشان تستلمي الراتبـ". احتدت. قفزت فوق الجراح: "يُخَلو الراتب لهم مشتيش راتب أشتي اعرف فين ودوا زوجي، أشتي زوجي يرجع. المشار إليهم، في نرفزتها، بالضمير "هم"، في إيمانها البسيط، لكن الراسخ، لا يعدو عن كونهم، بمعنى ما، كائنات بشرية بوجود واقعي، ملموس، بالقدر نفسه من الوجود الذي لزوجها حين يقرن بالضمير "هو"، بقطع النظر عن الإخفاق في تحديد مكان الإخفاء، أوتعيين هوية الجناة.
بالاستناد إلى معطيين، تقادم القضية في الزمان، و"انقراض" أو تبدل السحنات التي تناوبت على كراسي الجهة المسؤولة، حاولت اللجنة النيل من هذا الإيمان. خالصة، بتفوق لغوي واضح لا يخلو من استدلال، إلى أن "هم" مقترنا بالفاعلين، بنفس القدر نفسه من"هو" مقترنا بالزوج، وفي هكذا واقع، لم يعودا يشير ان إلا إلى اللا اللا أحد. مجرد لفظان يحلقان على فراغ. واستطرادا، فلا موجب لبقاء ملف القضية مفتوحا. عند هذا الحد تصاعدت النيران إلى الرأس، رأسها أكثر من رأس الابن. الأخير، مع انه لا يتوكأ، شأن أمه، بأكثر من حدوس تدحض إمكانية تركيب ضمائر الغائب على فراغ. لكنه، بالمقابل، غير مجرد من ترف الوعي بشبكة المصالح المعقدة، ناهيك عن التبلد العاطفي العام اللذين يحولان بينهما، وأمثالهما من أهالي المختفين قسريا، وبين معرفة الحقيقة. شبكة المصالح لم تهترىء بعد. لكن ليس من المستبعد أنها في اللحظة الراهنة تتعرض لخضة، وأن الخضات مرشحة للتوالي إلى أن يتمزق الرابط وتتفكك الشبكة. ما يؤرقه حقا أنه في كل مرة يتحدث في ذلك إلى الأم، يجد صعوبة في الوصول إلى فهمها. يضطر في النهاية إلى التخلي. يتركها تتدبر أمر نفسها أمام الجدار من الغوامض، السميك والبلا قلب، حيث إيمانها وحده يفي بالغرض. هكذا حدث أن رفضت المصادقة على شهادة الوفاة. ومنذ ذاك، وكلما هالها تذكر الزيارة، غضبها يتصاعد في ملفوظات تنسف احتمالية الخضوع لشروط الأقوى: "لكن أبعد عليهم من نجوم السماء"، المأثور الأكثر توافرا في متناول حنقها. "شاحسب وأزيد أحسبـ"، اللا مأثور المتوافر بنفس الكثافة. ستستأنف، ضدا على ما تلقى من تعب، الإمساك بنفس شريط القياس. ستنفخ، بلا انقطاع، في ذكرياتها معه بحيث تبقيها في درجة من التوهج لا يسمح للبقعة المظلمة النيل منها. في الواقع، هي لم تعد تغادر مدارها داخل مجرة الذكريات. لم تعد تجيد نفسها إلا في الكلمات التي تشير إليه. بشغف، كأنها ستستحضره. أو لكأنما، بفعل كاريزما كلماتها، يتراءى لها على سُمك قشرة من المثول.
لم تكن المدة التي قضياها معا كبيرة.
" لا تتجاوز الشهر والنصف". شهر العسل. ثم بعد ذلك بقرابة شهرين، إجازة مدتها أسبوعان أمضاها في القرية. حينذاك، كانت حامل بالإبن. تتذكر أنها، في الأثناء تخوفت على مسامع الزوج: "شاموت بسبب الحملـ". لكن الشاب الذي لم تهتز بعد ثقته بالحياة مازحها: "لا شتموتي ولا شيء، شارجع بعد شهرين ولا بك حاجة". لم تمت، لكن شريك حياتها لم يرجع. الخبر السار بقدوم مولودهما البكر بلغه، بعد أشهر، إلى صنعاء حيث يقيم. بادر إلى إرسال مصاريف إلى أسرته لتغطية نفقات المناسبة السعيدة. بعد أسبوع من قدوم الإبن تلقت الخبر الأليم: زوجك أُعتقل. بين المعتقلين كان أخوه الأصغر وأخوها وآخرون. بعد عام أفرج عن الاثنين. "لكن الزوج ما خرجش، ضاع ولا أحد شافه، ضاع وهي":
من مكانها المعلوم، قبالة باب الحجرة، تحدثت إلى الصحفيين. سهوا أو قصدا، خر من لسان أحدهما تلميح إلى احتمال الموت من زمان. "كيف أقتنع أنه مات؟ لو شفته بعيني ميتا، كنت شاقول الحمد لله على كل حال، لكن لا جابوا جثة ولا جنازة ولا سلموا ثيابه أو بطاقته، ولا شيء". هكذا توالت زفراتها في التحقيق الصحفي الذي، تاليا بأيام، سيظهر في الأسبوعية "النداء". كيف كان شكله؟"، ينبهها السؤال الذي طرحته إحدى الجارات إلى ما فاتها: عدم ملاءمة المكان الذي تعلق فيه الصورة على جدار الصالة. تغادر بقعتها. بتوازن مدهش، كما يخلق بزوجة مختفٍ قسريٍّ أن تفعل، تتخطى المتحلقات حولها في تنويعات مختلفة لذات الوضعية: وضعية المتعبد. تذهب إلى الصالة وتعود وبين يديها إطار في داخله بورتريه الزوج بالأسود والأبيض. تمرره أمام أعين الحاضرات دون أن تسيبه من يديها. تدير الإطار ناحيتها. تبحلق بحدة. لا يقدم صورة وافية عن الزوج. تكمل من ذاكرتها: "كان أسمراني وطويل...". وتروح عيناها تفتشان في جدار الغرفة عن مكان آخر مناسب. ترى مسمارا شاغرا في ناحية. تتجه إليه. تمرر المسمار في حلقة الإطار. تعود إلى مكانها: "وعيونه كبيرة... وحدقاته شفتين العسل الصافي... وجنب واحدة منهن حبة خال صغيرة... وما كان يلبس إلا المقاطب والشمزان... وكان مغرم بالرقص... في شهر زواجنا رقصنا أني وهو لما تكسرين رجولنا..كان يفتح صوت أيوب والا فيصل علوي ويمسك بيدي ويجرني لوسط الغرفة وهات يا رقص... ساعة نرقص الزبيرية وساعة لحجي..." ذكريات المدة الوجيزة تتحرك، في حديثها، عبر حشد من التفاصيل الصغيرة التي، بفعل قوة الارتباط والرعاية، تتمدد وتنفلش لتشغل كامل الحيز الذي لحياتها فيما لو مرت بطريق آخر، عدا ذاك الذي يمر بالكارثة. ما لا تعرف أن تحكيه. ما يصيبها بالتشوش والارتباك، فعلا، كلما حاولت أن تحكيه الوجه الآخر لحياته. نشاطه السياسي. خلال المدة التي قضاياها معا لم يبح بكلمة. حين يرتطم لسانها بذلك الوجه ترتد، في العادة، نحو زفرة حارة، مع تربيتة على ركبتها: "ألله يسامحه، كيف طاوعه قلبه مقليش؟". القليل الذي تعرفه لم تعوزها الحيلة إليه. خلال السنوات التي أعقبت اختفاءه، في الأعياد، إذ يتواجدون في القرية لقضاء الإجازة، رفاق الزوج يأتون للمقيل في منزل والد الزوج، حيث تعيش. كانت اللقاءات مناسبة للخوض في سيرة الرفيق المختفي. حينئذ، سعيهما، هي والأم، إلى التشبث ببريق أمل ولو شاحب، يدفعهما للاقتراب من باب الحجرة حيث ينعقد المقيل. تتسمران إلى جوار الباب من الخارج. ترهفا السمع. المرة تلو الأخرى، تترصع الأحاديث بكلمات مبهمة يتقاصر عنها الفهم من قبيل حزب، خلية، منشور... إلخ، لذا تُفاجأ بعد وقت قصير بخلو ذاكرتها منها. ما يتبقى، في كل مرة، الانطباع بأنهم، إذ يتحدثون عنه، فإنما يتحدثون عن وريث سلالة فريدة، بطل على الأرجح، يخص كثيرين غيرها بقدر ما يخصها. منذ ذاك، لا تبارح الإحساس شديد الوقع، المتولد حينها، بأنها، بلا دراية، وهبت قَدَرا غير عادي لمجرد الرابط الحميمي بالشخص، مدار كل ذلك التبجيل. وبأنها، نظرا لأن تلامس الجسدين مؤكد، اكتسبت، بدورها، قداسة خاصة لم يفتها ملاحظتها في أعين المحيطين. وعليه يلزمها من الآن فصاعدا، أن تكون بمستوى القدر الذي انتقاها من دون فتيات القرية جميعا. بمستوى القداسة. هكذا حدث، فيما بعد، حين يئس الآخرون- فيما عداها بالطبع- من عودته، أن رفضت عروضَ زواجٍ. رضيت عن طيب خاطر بالمهمة المقدسة: انتظار الغائب. لم تعد تخرج من البيت. وإذا ما خرجت، وذلك في حكم النادر، تعود باكراً. ذلك أنها ترغب أن تكون، حين عودته، في الانتظار. لم يكن طالبو القرب فقدوا الأمل بعد. ما إن تتفوه إحدى الوسيطات بعرض زواج حتى تفزع في وجهها: "أني أتزوج، حُرِم علي أعملها قبل ما أعرف مومصيره؟ حينئذ، يصعب على من يراقب انهمار دموعها التكهن بهوية الدافع: التحسر على شبابها الضائع، أم مأساة الزوج؟ إلا أنها في كل مرة كانت تنجح في مقاومة الإغراءات والتشبث بموقف الرفض. لم تعد تتلقى طلبات زواج الآن."أغلقتُ الباب عليهم بالمرة..."، تقول فتغمر وجهها ابتسامة مثقلة بأنوثتها. فيما تلوح على وجوه الجارات، إذ يصغين، نظرة رومانسية مشفوعة بالتنهد، كما لو كن في حضرة التجسد الكامل لمثال الحب المستحيل. بل إن نظرات البعض تذهب إلى حد التساوي بالحسرة، ربما، من فرط الإحساس بالعوز إلى نفس المصير. بالنسبة إليهن، كانت من ذلك النوع من البشر الذي يتقاصى بسهولة في الذاكرة بمجرد الابتعاد عنه، ويسهل توهم حتى الاستغناء عن صحبته. ثم، بمرور وقت، على نحو ملح، يعاود السطوع متشحا بجاذبية خاصة مستمدة مما يفتقرن: المثابرة على شيء مفرد، وبالأخص، فيما يعنيها بالذات، فرادة المصير. عندئذ يجدن أنفسهن في قبضة الحاجة الملحة إلى أن يكن في حضرتها، مستسلمات لسماع أحاديثها، علهن بذلك يعوضن ما خُسر في فترة النسيان. وهكذا تسارع سماعات هواتفهن إلى عقد الاتفاق حول موعد الزيارة. وأحيانا يداهمن منزلها دون اتفاق مسبق، معتمدات فقط على حسن المصادفة. يحطن بمكان جلوسها. يصغين، بما يلزم من انتباه، لاستخراج الوقود المعنوي الذي يعين، إذا ما اقتضت شدة، في التغلب على جور الزمن. لا يُعرف مكان يتجمع فيه أوسع من البرنامج التلفزيوني الشهير " نوح الطيور"، الذي تبثه فضائية صنعاء عصر كل سبت. موعد بدء البث الرابعة عصرا، الساعة التي، دون استعانة بساعة، تحددها بدقة متناهية. تتابع على الشاشة تدحرج المأساة على هيئة وجوه، نسائية في الغالب، تذرف الدمع وتتوسل، عبر ميكرفون البرنامج، رأب الصدع بأقارب لم ترد عنهم أخبار منذ سنين. إذ تبحلق بملامح خبيرة في الانتظار، لا تستطيع إلا أن تتذكر مأساتها الخاصة وتسكب الدمع. لا تنوي أن توجه مناشدة مماثلة بالطبع. ليس لأن الجرأة في الوقوف أمام كاميرا البرنامج معدومة. لكن لعدم القدرة، فيما لو فعلت، على تحمل ألم أن لا ترى لمناشدتها صدى في الحلقة القادمة. أحيانا في المطبخ، إلى جوار زوجة الابن، إذ تنشغل بتقطيع الخضروات، تتجمد حدقتاها فجأة على نضارة الأشكال الخضراء والحمراء بين يديها، تستغرب بينها وبين نفسها، فحسب، كيف الأرض التي أنبتت كل هذه النضارة بوسعها أن تنبت في نفس الوقت بشرا بقلوب تقوى على حرمان الحبيب من الحبيب! كان ذلك إلى ما قبل الزيارة المشؤومة للجنة وزارة حقوق الإنسان، عندما رست على إبقاء خاطر كهذا رهينة كرب عالمها الداخلي. لم تعد تبوح حتى لزوجة الابن. في الحقيقة، لم تعد تبوح لأي كان. تعلمت أن تتلقى الهبوب البارد لمثل هذه الخواطر وحدها. يتراءى عليها ما يشبه العثور على الترجمة الدقيقة لشعورها -بأن مأساة الواحد لا يمكنها أن تكون سوى مأساته بالذات- في ترداد: "من يده في الماء مش مثل اللي يده في النار". الآخرون، مهما تفننت وجوههم في تشكيل الخطوط التي تعني التعاطف، يبقون على مسافة من قياس عمق الحفرة التي تتدلى، هي، من خيط رفيع فوقها. لكن ما بدر عن اللجنة يدفع الواحد إلى الكف عن حصر وجعه بالعالم الداخلي. يجعله أضعف من أن لا يصرخ بمأساته على مسامع جميع الناس. يركض بلا توقف داخل رأسه. متفقدا مدخراته من الذكريات. راصداً هكذا جماع أعصابه وطاقته في مواجهة غطرسة المحو. تأتي لحظات تحس نفسها مرهقة. تفكر أن تكف عن الجهد الذي بلا طائل. أن ترفع الراية البيضاء وخلاص. حينئذ، من باب التعاطف، كائنات فوق بشرية، رسل سماويون على الأرجح، ستجهد في تخيلهم، يقبلون عبر ضبابية الفرجة التي تفصل بين النوم واليقظة، بالهمس، أو حتى ستكتفي بأن يلمحوا تلميحا –فيما تستند إلى جذع قيلولة ما- الخبر وترتاح. لكن الراحة لا تأتي. الرسل لا يصلون. تستيقظ متكدرة. تشعر بالذنب. ترى سادة غلاظ"، مجللين بالسواد يحدقون بها. يدفعونها أمامهم باتجاه حبل المشنقة. "أعوذ بالله من النفس الأمارة بالسوء"، تتمتم. "كيف طاوعتك نفسك!"، تخاطب أخرى غير مرئية إلى جوارها. وربما، إذ تفتح عينيها، أنقذها من الأفكار الكئيبة مثول حفيدها، بالشقاوة في عينيه، فوق الرأس. يوشك أن يشد شعرها. تقبض على يده الغضة. تخصه بابتسامة، الابتسامة الوحيدة التي نجت من الشنق. يغافلها ويخلص يده في نزق، قبل أن يركض بضحكته العريضة بعيدا عنها. تستنفر حركته حنانها. تروح تركض وراءه. عند نقطة ما في الصالة تتناهى إلى مسامعهما طرقة على الباب الخارجي. يشنفان آذانهما معا بنفس القدر. يحرف الحفيد مساره إلى تلك الناحية قبلها. رؤيته يفعل ذلك تضخ البهجة في وجهها. تنتشي إذ ترى، على الوجه الغض، الطاقات الضئيلة مستنفرة إلى حدها الأقصى. تواصل وراءه. تحاذيه. تبقى بمحاذاته لبعض المسافة، متظاهرة بأنها معنية بالسباق، ثم، طوعيا، تتخلى له عن متعة الفوز بأداء المهمة. إنها تتسلى فعلا. متصورة، في الظاهر فحسب، أن المسألة تتوقف عند هذا الحد. أما في الأعماق، أعماقها بالذات، ليست بعيدة البتة عن تهجي السر الذي يرقد في قلب الشغف الذي يبديه الحفيد بفتح الباب. غير بعيدة عن المكان حيث الطمأنينة المستمدة من الإدراك أنه بوجود الحفيد، وقبله الابن، لن تكون الأرض مهددة بالجفاف من السلالة الموسومة بقدر الانتظار. لا، ما من مبرر للخشية أن لا يكون الزوج، في حال التمادى في الغياب - بعد ذهابها من الدنيا - في مأمن من التردي في وحشة أن لا ينتظره أحد. في أحايين أخرى، خصوصا تلك حيث احتمال قدوم زائر معدومة، إذ تترامى من جهة الباب، طرقة، حقيقية أو متوهمة، تجد نفسها عاجزة عن تمالك لهفتها. بقلب أعمى تماما عن الحفيد، يركض إلى جوارها، تصل إلى الباب قبله. حينئذ، ما من مفر من التعامل بقدر من الحكمة مع البرطمة الاستنكارية التي ستعلو ملامحه. لم يعد في مزاج مناسب لتبادل الكلام مع أحد. وسيناسبها، في الواقع سيناسب بقية أفراد العائلة، تركه يحتفظ بما يكفي من الغضب لكي يتجول، لبعض الوقت، متبرما، مسقطا القلافد المنظومة هنا أو هناك، على الطاولات والرفوف الخفيضة. "والله إنه أخذ طبع جده"، تقسم: "أني متأكدة لو ما كنش جده أكه عنيد وشكس ما حصله اللي حصلـ". ليس بدافع التشفي بالطبع، إنما نكاية بالاحتمال الذي، دون سواه، حاز ميزة التجسد واقعيا، وأكثر من ذلك، يمارس عليها وطأة تفوق وطأة الواقع. في كل حال، الانطباع حول الزوج ليس مستخلصا من خبرة عملية. مدة المعاشرة كانت أضيق من أن تسمح بتفتح كامل لطباعه أمامها. فيما لم تتعد معرفتها به قبل الزواج الثلاث المرات. في الأثناء، رأته من بعيد، يسير مجتازا مخاليف قريتها، التي تبعد بضعة فراسخ عن قريته. كان يتردد على أخيها الذي لن تنسى، ما حييت، تربيته، صباح العرس، على كتفها. وبشكل أخص كلماته: "شوفي زوجتك شاب غير الشباب كلهم.. ضعيه في حدقات عيونكـ". بقي المغزى محجوبا لبعض الوقت، بالتحديد إلى أن وصل خبر اعتقالهما. حينئذ، ستعرف أنهما، الأخ والزوج، كانا نديمي الأحلام والاهتمامات السرية ذاتها. لم تعوز الوسائل لإكمال الصورة. إلى أحاديث الأم والأب والإخوة، آخرون، فيما مضى، سردوا عنه الحكايات. حسب شاهد عيان على اعتقاله: سار وسط رجال الأمن في هيئة من يستعرض أمجادا شخصية. وفي عشية يوم الاعتقال جيء به لبعض الوقت إلى زنزانة يقبع فيها معتقل آخر من أبناء قرية مجاورة. كانت الدماء تسيل من رأسه وتغطي ملابسه، مع ذلك أبدى من رباطة الجأش ما رفع معنويات الرفاق. دون أن يكف فمه عن رشهم -أي جلاديه- بالسباب. حدث ذلك في صيف العام 1978 حين اقتضت سادية بعض رموز النظام الزج بمئات الأبرياء، معارضين وغير معارضين، في المعتقلات وإرغام بعضهم على عدم مغادرتها إلى الأبد، بمبرر وضع حد لتقلقل كرسي الرئاسة الذي في صنعاء، حيث تقيم منذ خمس سنوات، ليس عن رغبة. لكن لأن، في اللحظة الأخيرة، قبل أن ترد بالرفض على عرض الابن لها بالانتقال إلى العيش بجواره، السلك الخفي الذي هجست وجوده بينها وبين الزوج بدا قابلا للتحقق نظراً لقرب المسافة. لم يتحقق السلك. سوى أنها حين تتذكر مثل تلك الحكايات، تتوزعها مشاعر متضاربة تتراوح بين الفخر والتألم لأجله. تتألم لدرجة تتمنى لو، عوضا عنه، تقاضت، هي، القسط المقدر من العذاب. لا تعرف بالضبط في الميل إلى جوار أيِّا من هذه المشاعر تجد راحتها أكثر. لا تعرف من، على وجه التقريب، يتخبط في المحنة أكثر، هي أم الزوج؟ إمعانها في محنته يخلّيها بمنأى عن أن تعرف. محنتها لا تبدو أكثر من غبش خفيف سرعان ما ينقشع في مهب النور الساطع المنبعث من محنة المختفي.
***
كان يرسل بيانات «الثورة» عبر الأثير فأُرسل إلى المجهول
 كان عمر "فرسان" 3 سنوات و9 أشهر حينما عاد والده، علي حسن الشعبي، قادماً من نيجيريا في زيارة قصيرة للوطن. وصل علي حسن الشعبي عبر ميناء عدن الجوي بتاريخ 19/4/1973 بموجب تاشيرة دخول رقم (ع/ق73) بتاريخ 17/4/1973 صادرة عن سفارة اليمن الديمقراطية الشعبية- القسم القنصلي بالقاهرة. "زيارة لمدة شهر واحد "سياحة" بموجب جواز نيجيري رقم 157952"، يؤكد ذلك في روايته لـ"لنداء" فرسان علي حسن الشعبي، وقد صار عمره الآن 37 عاما, كل ما يعرفه عن والده أنه كان مناضلاً وإعلامياً بارزاً.. وأنه "خرج ولم يعد" قبل 34 عاماً في عاصمة محافظة لحج "الحوطة". كيف اختفى ولماذا؟ السطور التالية تكشف بعضاً من جوانب القضية المثيرة الغامضة.
كان عمر "فرسان" 3 سنوات و9 أشهر حينما عاد والده، علي حسن الشعبي، قادماً من نيجيريا في زيارة قصيرة للوطن. وصل علي حسن الشعبي عبر ميناء عدن الجوي بتاريخ 19/4/1973 بموجب تاشيرة دخول رقم (ع/ق73) بتاريخ 17/4/1973 صادرة عن سفارة اليمن الديمقراطية الشعبية- القسم القنصلي بالقاهرة. "زيارة لمدة شهر واحد "سياحة" بموجب جواز نيجيري رقم 157952"، يؤكد ذلك في روايته لـ"لنداء" فرسان علي حسن الشعبي، وقد صار عمره الآن 37 عاما, كل ما يعرفه عن والده أنه كان مناضلاً وإعلامياً بارزاً.. وأنه "خرج ولم يعد" قبل 34 عاماً في عاصمة محافظة لحج "الحوطة". كيف اختفى ولماذا؟ السطور التالية تكشف بعضاً من جوانب القضية المثيرة الغامضة.باسم فضل الشعبي
shab
أول الطريق
وُلد علي حسن الشعبي في 15/3/1944، في نيجيريا، لأب يمني وأم نيجيرية. عاد به والده وهو لم يتجاوز الخامسة من عمره، إلى أرض الوطن، وتحديداً الى منطقة "وادي شعبـ" ناحية "طور الباحة" محافظة لحج. وفي قريته الوادعة رضع الطفل الصغير مبكراً معارفه الأولى من كتاتيب القرية على أيدي فقهاء أجلاء. ويحكي عنه أهل قريته أنه كان شغوفاً منذ صغره بالقراءة فضلاً عن كونه طاقة من النشاط والحيوية, لذلك لم يكتف الطفل بما تلقاه من معارف أولية في كتاتيب القرية، شأنه شأن عدد كبير من أبناء قريته الذين انخرطوا في النضال ومارسوا السياسة من قبله ومن بعده؛ إذ سعى بجهود ذاتية الى تثقيف نفسه من خلال مطالعة بعض الكتب والمجلات التي كان ينفق عليها القدر الأكبر من مصاريفه التي كان يبعث بها والده من نيجيريا، حيث كان اغترابه عن الوطن, قبل أن يتوجه علي حسن الشعبي الى مدينة عدن ومنها الى تعز. كان قد اختار طريق النضال والكفاح المسلح كما يشير إلى ذلك عدد من كتاباته الصحفية في عدد من الصحف الصادرة في تلك المرحلة وكما يحكي عنه رفاق دربه. بعد تفكير عميق وتأمل واسع لحق بعدد كبير من ابناء قريته حيث قرر الانضمام الى الجبهة القومية و كان عمره حينها 21 عاماً ليحصل على بطاقة عضوية برقم 741 بتاريخ 5/3/1965, وجد الشاب العشريني نفسه مبكراً في مدينة تعز حيث كان المكتب المركزي للجبهة القومية. ولما كان الشاب المتوقد حماساً يمتلك قدرات بارعة في الكتابة والخطابة، رتب له وضعاً مناسباً وفق رؤية قيادية تكتيكية تتناسب مع طموحاته وتطلعاته الإعلامية التي بزغت مبكراً. وفي تعز أسهم "الشعبي" في دعم الثورة إلى جانب رفاق الدرب من خلال الإشراف والتحرير لعدد من المطبوعات الإعلامية الصادرة من هناك، فضلاً عن كتاباته المتعددة لعدد من الصحف التي كانت تصدر في تلك الفترة عن جهات نضالية متعددة في الشمال اليمني. كان مؤمناً ايماناً قوياً بأن الحرية حق، وإن الحق لا يستعاد إلا بالقوة والكفاح المستمر. "إن مطلب الحرية حق أساسي مشروع لكل شعب يريد الحياة والحرية أبداً لا توهب؛ لأنها ليست صدقة ولا نافلة من النوافل، بل تؤخذ؛ لأنها حق، والحق دائماً يؤخذ ولا يعطى".
العبارة مقتبسة من مقدمة مقال كتبه المناضل علي حسن الشعبي لجريدة "الأخبار" اليومية الصادرة في تعز عن وزارة الاعلام والإرشاد القومي (العدد 689 بتاريخ 12/7/ 1967) بعنوان "ماذا تعني بريطانيا عندما تتحدث عن الإرهاب؟! ثورة شعبنا في الجنوب أقوى وأعتى من الإستعمار وقواته".
في إذاعة تعز
واصل المناضل علي حسن الشعبي كفاحه ونضاله عبر الكلمة والقلم، حيث كانت هذه الأداة في نظره لا تقل في دورها عن المدفع والرشاش. ففي الوقت الذي كان يلجأ فيه المستعمر البريطاني إلى بث الإشاعات المغرضة في صفوف المناضلين وقواعد حركات التحرر بهدف إضعافها والتأثير على معنوياتها القتالية، كان الشاب العشريني يتصدى -إلى جانب عدد كبير من المناضلين- لهذا النوع من القتال، عبر كلمات مدوية يرسلها تارة عبر أوراق الصحافة وتارات أخرى عبر أثير "إذاعة تعز" بعد أن أصبح مذيعاً رئيسياً فيها. "إن ثورتنا المسلحة في الجنوب اليمني المحتل التي انطلقت شرارتها الأولى عشية الرابع عشر من أكتوبر عام 63م ضد الوجود الامبريالي البريطاني وعملائه الأذناب في المنطقة, هي ثورة كل فرد من أبناء هذا الشعب، هي ثورة الفلاح والعامل والتاجر والطالب. إن هؤلاء جميعاً هم الذين فجروا الثورة وقدموا أرواحهم وأموالهم وقوداً لها وزيتاً يذكي أوارها ويشعل جذوتها الثورية. سر يا شعبنا في طريقك، طريق الثورة المسلحة، حتى يتحقق النصر لأهدافك مجتمعة, والله أكبر وكلمتك هي العليا ومصلحتك فوق الجميع". بهذه الكلمات كان علي حسن الشعبي يشعل حماس الجماهير ويوجه طاقاتهم نحو النضال وميدان المعركة عبر بيانات الثورة من أثير إذاعة تعز. وقد وجدنا بعضاً منها مكتوباً بخط يده. لقد كان دوره كبيراً في تلك المرحلة الحساسة من تاريخ الجنوب اليمني المحتل. هذا الدور الذي لعبه "الشعبي" دور المذيع اللامع أحمد سعيد عبر إذاعة "صوت العربـ" من القاهرة، إذ أن إشعال جذوة القتال وتحريك طاقات الجماهير وبث الثقة بين صفوفها ورفع معنوياتها القتالية، كانت أهدافاً سامية للإعلام والاعلاميين آانذاك.
في 13 يناير من العام 1966 أعلن عن دمج الجبهة القومية ومنظمة التحرير تحت مظلة واحدة أصبح اسمها "جبهة تحرير جنوب اليمن المحتلـ". وبحكم نشاط المناضل علي حسن الشعبي الإعلامي والصحفي، فقد وجد نفسه عضواً في الجبهة الجديدة وذلك في 14/3/1966. بحكم إيمانه الكبير حينها بدور الإعلام ومدى تأثيره، ظل "الشعبي" محتفظاً بموقعه كمذيع في إذاعة تعز حتى بداية السبعينيات. وفضلاً عن ذلك فقد عمل خلال تلك الفترة مديراً مالياً وادارياً لإعلام محافظة تعز قبل أن يقرر الهجرة إلى نيجيريا التحاقاً بأبيه الذي كان اغترب في عشرينيات القرن الماضي.
يقول ولده فرسان: "ترك والدي تعز في العام 1970 متجهاً. إلى عدن، ومنها إلى قرية شعب حيث كانت أسرته وأقاربه. وقد ظل في القرية لمدة عام وكان يتردد حينها على عدن ولحج لزيارة أقاربه وزملائه من المناضلين. بعدها قرر الرحيل إلى نيجيريا وكان ذلك في بداية العام 1971".
العودة إلى المجهول
مكث في نيجيريا عامين، ثم قرر بعدها العودة الى الوطن. ويضيف الولد الوحيد للمناضل علي حسن الشعبي، إذ أن الأكبر منه كانت فتاة هي الآن متزوجة ولديها عدد من الأبناء وتسكن قرية"شعبـ"، قائلاً: "وصل والدي الى أرض الوطن في 19 ابريل العام 1973 عبر ميناء عدن الجوي، ومنه توجه مباشرة إلى القرية لزيارتنا، حيث مكث عندنا ما يقارب أسبوعاً ثم أخبر الأسرة أنه ينوي أخذها معه إلى نيجيريا للاستقرار هناك وإنه سوف يسافر إلى الحوطة لإتمام معاملات السفر".
صبيحة اليوم التالي ودع "الشعبي" أسرته وأقاربه صوب مديرية طور الباحة. وفي ظهيرة اليوم نفسه كان قد وصل إلى الحوطة متوجهاً إلى منزل قريبه الذي يدعى أيضاً علي حسن الشعبي، والأخير كان مناضلاً بارزاً في صفوف الجبهة القومية أيضاً. وكان الإثنان قد عاشا طفولتهما معاً في القرية ثم في مدينة الحوطة التي شهدت بعد يوم واحد من وصول والد "فرسان" إليها قصة اختفائه المريرة والمثيرة منذ ذلك اليوم المشؤوم وحتى الآن.
في مقر التنظيم
لم يكن المناضل والسياسي "الشعبي" يعلم حينما ودع أسرته وأبناء قريته ذات صباح مشمس، أن ذلك الوداع سيكون الأخير. لم يكن يدرك أن الليلة الساهرة التي قضاها مع عدد من أبناء قريته في "الحوطة" متحدثاً اليهم فيها عن الإستعمار البريطاني وعن النضال والكفاح الذي نال من خلاله شعب الجنوب حريته إلى الأبد، ستكون الليلة الأخيرة وبعدها يختفي من دون أية مقدمات. لم يكن يتصور بالمطلق أن الرجل الذي طالما قض مضاجع المستعمر بخطاباته وبياناته الرنانة عبر أثير إذاعة تعز، وألهب حماس الجماهير. سيختفي عن أعين أهله ومحبيه بمجرد وصوله إلى عاصمة لحج وذهابه لزيارة من كان يعتقد أنهم رفاق الدرب.
في المساء وبينما كان في منزل قريبه المناضل والذي يحمل نفس اسمه (علي حسن الشعبي) تحدث أبو فرسان أنه في الغد سيقوم بزيارة إلى مكتب تنظيم الجبهة القومية في لحج لزيارة من كانت تربطه بهم علاقة صداقة ومسيرة نضال وكفاح مشترك لتحرير الجنوب، ومن ثم سيتوجه إلى معسكر "عباس" لاستكمال إجراءات معاملة نقل أسرته للعيش معه في نيجيريا، ولم يكن يعلم أن تلك الزيارة ستنقله من لحظة العيش مع من كان قد ألفهم من حوله إلى لحظة العيش في المجهول, المجهول الذي ما يزال يطوي حياة مناضل بارز نذر حياته لوطنه وشعبه مقابل ثمن غال ونفيس هو "الحرية" دون غيرها. "ثورتنا المسلحة في الجنوب ليس لها نهاية إلا بنهاية الاستعمار والعملاء، فكلما ازدادت وحشية الاستعمار ازداد غليان مرجل الثورة"، هكذا سطر الفتى العشريني في 7/9/1965 على صدر الصفحة الاولى من صحيفة "الاخبار" اليومية الصادرة من تعز حين ذاك ثم ولَّى يستلهم أفكاراً جديدة لعمل نضالي جديد غير مكترث لبطش الاستعمار ودسائس عملائه.
اللحظات الأخيرة
في صباح اليوم التالي من وجوده في الحوطة، توجه إلى مكتب تنظيم الجبهة القومية لزيارة الرفاق..فكانت تلك الزيارة كما ستعرف لاحقاً سبباً في انقطاع أخباره عن أهله وأقاربه والى هنا انقطعت اخبار علي حسن الشعبي ففي الوقت الذي يتحدث فيه البعض انه اختفى في مكتب التنظيم اي انه دخل اليه ولم يعد ذات صباح مشؤوم يروي البعض عن أن من كانوا في مقر التنظيم أخبروهم أنه ذهب الى معسكر "عباس" لإنجاز معاملة سفر أسرته إلى نيجيريا, لكن "فرسان" أكد لـ"النداء": أن والده اختفى في مكتب تنظيم الجبهة القومية أثناء ذهابه لزيارة الرفاق". وأضاف: "كانت الطامة الكبرى أثناء ذهاب أهل والدي للبحث والسؤال عنه لدى الأجهزة الامنية، وفي مقدمتها ووزارة الداخلية، كجهات اختصاص مناط بها الأمن والأمان والسهر على تحقيقه للمواطنين؛ حيث كانت ردودهم على أسئلة أهل والدي هي: إن هذا الشخص غير موجود في سجلاتنا. وتارات أخرى يردون بأنه غادر خارج البلاد وهي ردود لا تمت للحقيقة بصلة، لأن والدي قد دخل بموجب تأشيرة سياحية لمدة شهر، صادرة عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية القسم القنصلي القاهرة".
وتابع فرسان حديثه مع النداء: "لقد كانت المفارقة في احاديث المسؤولين حينها: خرج ولم يعد, دخل ولم يعد, لكن الحقيقة اصبحت وتجسدت في انقطاع أخباره عن أهله وذويه. وظل السؤال الاكثر إلحاحاً لدى أهله: هل هو حي أم ميت؟ إن كان حياً أين هو؟ وإن كان ميتاً من المسؤول عن موته؟ وكيف مات؟ وأين هي جثته؟".
ويقول فرسان أنه في إحدى المرات وفي فترة الثمانينات وبعد الإلحاح المستمر لمعرفة مصير والده من قبل أهله وأقاربه في قرية شعب، حدث تحول مفاجئ في حديث أحد المسؤولين وهو وزير الداخلية صالح مصلح حينما أوصى باعتماد إعانة شهرية لأسرة المختفي، وأشار بعد سؤال وجه إليه عن سبب اعتماد الإعانة والرجل ما يزال مجهول المصير إلى أن "خطأ ما قد حدث". "حينها شعر أهل والدي بأن عملية "اللحس" قد تمت وأن عملية الإنكار والمماطلة ما هي إلا محاولة لإيصالنا إلى هذه القناعة. مع ذلك نحن لم نقتنع. صحيح أننا مؤمنون بالقضاء والقدر، لكن ما زلنا نتطلع إلى معرفة مصير والدي المناضل علي حسن الشعبي حتى اليوم".
والى اليوم ما تزال الإعانة المقررة لأسرة علي حسن الشعبي متوقفة منذ ما يقارب أربع سنوات، والسبب هو "شهادة الوفاة"، إذ أن الجهات المسؤولة حالياً تطالب بإحضارها لاستكمال إجراءات صرف الإعانة بينما أسرة "الشعبي" وأقاربه عاجزون عن ذلك، لأن مصيره ما يزال مجهولاً منذ 34 عاماً..!
***
مصيرهم الشاق انتظار «عبدالعزيز» والامن الوطني كالمخرز في قلوبهم
أحزان آل «عون»
* محمد خميس لوالده: عاندفنك في حفرة لو مابطلت تدور على ابنك عندنا
 موجع هو الانتظار حين لا ثاني له و الأوجع تلك الذكريات الحميمة التي يحملها المنتظرون عن أعزاء ينتظرونهم.
موجع هو الانتظار حين لا ثاني له و الأوجع تلك الذكريات الحميمة التي يحملها المنتظرون عن أعزاء ينتظرونهم.لكن الانتظار مصير الحالمين الشاق ولا من فرار.
فيما سيبدو صراخهم على أمل الشفاء بمثابة أوجاع تتفاقم خصوصا إذا ما شعروا بان المساحة من حولهم قد صارت لا متناهية بالصمت وفسيحة باللاجدوى!.
البحة المغصوصة في صوت الدكتور جميل عون كانت تشير إلى ذلك وهو يحكي للنداء مأساة أخيه المختطف والمغيب منذ 30 عاما إضافة إلى أحزان العائلة التي ما زالت تنتظر.
فتحي أبو النصر
fathi_nasrMail
إن اليأس يمتزج بالأمل لدى آل "عون" وهم بانتظار عبد العزيز ولا يعرفون مصيره بعدما راح ضحية لجهاز الأمن الوطني الذي صار كالمخرز في قلوبهم.
في 6 فبراير 77م اعتقل النقيب عبد العزيز عون من جانب سور الجامعة القديمة بصنعاء "كلية الآداب حاليا " عبر سيارة فلوكسويجين زرقاء جيب تتبع الجهاز سيئ الصيت.
طبق شهود فان العملية تمت بقيادة نائب رئيس الجهاز حينها.
كان عبد العزيز منذ صغره مأخوذا بالمسألة السياسية وأمنيته أن يصير ضابطا لذا التحق بالبعث ولاحقاً بحزب الطليعة، الذي صار جناحه اليساري وقد عرف كعضو ناشط ومؤثر فيهما كما عد واحدا من انبغ الذين دخلوا الكلية الحربية حيث تخرج فيها بتفوق.
 في العام 53م ولد بقرية المذاحج - تعز وتشكلت لبنات وعيه الأولى ما بينها وعدن بعد انتقال العائلة إليها مؤقتا قبل استقرارها النهائي في تعز.
في العام 53م ولد بقرية المذاحج - تعز وتشكلت لبنات وعيه الأولى ما بينها وعدن بعد انتقال العائلة إليها مؤقتا قبل استقرارها النهائي في تعز.باختصار: انه ابن المناخ الستيني العاصف الذي حرك في المنتمين إليه تطلعاتهم من اجل يمن جديد.
في العام 68م قرر وأخيه منصور أن يلتحقا بالكلية الحربية فكانت مغادرتهما إلى صنعاء لكن والدهما تفاجأ باختيارهما الدراسي إذ كان يريد لهما دراسة الطب أو الهندسة فاستدعاهما للحيلولة دون الحربية لكأنه يحدس ما سيواجهانه من مصائب بسببها.
غير أن منصور هو الذي عاد إلى تعز وتراجع.
لم يعد عبد العزيز إذ كان عشقه الكبير للدراسة العسكرية هو مشتهاه الذي صر على عدم الاحادة عنه.
تم التحاقه بالدفعة التاسعة التي تميزت باحتوائها لنبهاء مبرزين اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
تفرد بتحصيله الدراسي نظريا وميدانيا وظل ترتيبه الأول في جميع المراحل والمتعارف عليه أن الأول في حفل التخرج هو من يسلم العلم للدفعة التالية كما ويبقى ضمن سلك أعضاء هيئة التدريس فيها لكن عبد العزيز حرم من الأمرين معا!
السبب حد إحالة جميل ممارسته للعمل الحزبي ونشاطه الاستقطابي الناجع وسط العسكريين.
بعد التخرج تم تصدير عبد العزيز إلى لواء العروبة في تعز ويتذكر جميل كيف انه كان ملفتا بحيويته العسكرية حتى أن مشيته كانت كذلك في أفعاله المدنية أيضا!.
خلال تلك الفترة وقعت حادثة تعزز من المعطى النبيل لدى هذا الفتى وهي بحسب جميل كالتالي: تم القبض على احد الجنود التابعين لكتيبة كانت ترابط في منطقة الراهدة عند الحدود الشمالية الجنوبية ويشرف عليها اللواء وذلك عقب عودة هذا الجندي إليها بعد فراره لأيام مدعيا انه تاه بين الحدود لكن محاكمة عسكرية تمت له في مقر اللواء بمنطقة الحوبان أقرت اعدامه بتهمة التعامل مع الجنوب وقد أوقع القاضي أمر تنفيذ الحكم على عبد العزيز الذي رفضه بشدة باعتبار المحاكمة غير عادلة أولا وثانيا بان ليس من شانه تنفيذ مثل هذه الأحكام حتى ولو جاءته عبر أوامر عسكرية!
 "مازلت اعتقد أن الجندي كان رفيقا لعبد العزيز وتحديدا كان يؤدي مهمة حزبية أثناء غيابه عن كتيبته"، يقول جميل ويضيف: "كأن الأمر الذي أعطي لعبد العزيز لتنفيذ الإعدام بالجندي قصد إظهاره بموقف النذل مع رفقائه".
"مازلت اعتقد أن الجندي كان رفيقا لعبد العزيز وتحديدا كان يؤدي مهمة حزبية أثناء غيابه عن كتيبته"، يقول جميل ويضيف: "كأن الأمر الذي أعطي لعبد العزيز لتنفيذ الإعدام بالجندي قصد إظهاره بموقف النذل مع رفقائه".قضى عبدالعزيز ثلاث سنوات في تعز قبل انتقاله إلى عمران مع انتقال لواء العروبة وتحول اسمه إلى اللواء الأول مشاة.
هذا اللواء اعتبر واحدا من أهم المواقع الميدانية الحساسة التابعة للقوات المسلحة فيما لم يخفت النشاط السياسي لعبد العزيز. "كان لا يخشى شيئا"...: "كنا نخاف عليه فهو مراقب وعيون البصاصين لا ترحم"، لكن جرعة العقاب تزايدت تدريجياً؛ إذ تمت إحالته إلى التوجيه المعنوي "لكأنه أحيل إلى معتقل أنيق" بحسب تعليق جميل.
آنذاك كان قد أصبح عبدالعزيز منتسبا بكلية التجارة جامعة صنعاء قسم الاقتصاد وكالعادة كان نبوغه هو المتجلي إذ ظل يحصل على المركز الأول بتقديرات عالية لكن قدره مع حق التعيين كمعيد تكرر في هذه الكلية أيضا إذ تم اعتقاله وهو في سنته الرابعة.!
حد شهود فان سيارة الفلوكسويجين الجيب الزرقاء التي نفذت مهمة اعتقاله توقفت لفترة أمام المنزل المشترك الذي كان لأخويه عبد القادر ومنصور والكائن في منطقة غرقة الصين.
 عبد القادر ومنصور كانا في العمل حينها وهناك نسخة من مفتاح المنزل عند المؤجرة التي حكت لهما بان عبد العزيز جاء برفقة شخوص وطلب المفتاح منها فأعطته.
عبد القادر ومنصور كانا في العمل حينها وهناك نسخة من مفتاح المنزل عند المؤجرة التي حكت لهما بان عبد العزيز جاء برفقة شخوص وطلب المفتاح منها فأعطته.المفقودات التي حصرها الأخوان تستدعي الغرابة كما تعمد غباء الأمنيين "عدسة مكبرة للحروف ومجموعة نظارات تتبع عبد القادر المصاب بضعف في بصره إضافة إلى جواز سفر لأخيهما الثالث ياسين وبعض الكتب التي تتبعهما "وكانت دراسية متخصصة وليست سياسية أو ثقافية كما يؤكد جميل مشيرا إلى أن "ما لا يعرفه الخاطفون الامنيون هو أن عبد العزيز كان يسكن بيتا سريا آخر وفيه يجتمع مع رفاقه كما يحوي أية وثائق مهمة له. وقد كانوا فائقي الحرص والتنظيم "
لوالد عبد العزيز مكابدات شتى مع الأمن الوطني إذ ظل مداوما على التردد عليه لمعرفة مصير ابنه حتى وصل الأمر بمحمد خميس أن يقول له "عاندفنك في حفرة لو ما بطلت تدور على ابنك عندنا". لكنه جاهد لمعرفة مصير ولده من خلال التقائه شخصيات اجتماعية مؤثرة وحثهم على المساعدة.
مرة قابل الدكتور عبدالعزيز المقالح في فعالية تأبينية وحين تصافحا قال له بصوت مكلوم "متى ستكفون عن الأموات وتبحثون عن الأحياء؟!".
اثر ذلك تقدم مجموعة مثقفين من بينهم الدكتور المقالح والدكتور أبوبكر السقاف بطلب للآمن الوطني للإفراج عن معتقلين من بينهم عبد العزيز لكن قادة الأمن لا يبالون عموما وعلى نحو خاص ظلوا ينكرون وجود عبد العزيز لديهم "
بيد أن معتقلين سابقين تم الإفراج عنهم اجمعوا على مشاهدتهم له في الأمن الوطني.
الحق أن النداء التقت بمعارف لعبد العزيز شهدوا إحداثيات تلك الفترة جلهم تحسروا عليه واعتبروه "ملحوسا" وفقا للتعبير السائد وقتها أي أن تصفيته قد تمت كما اجمعوا على عدم ذكر أسمائهم هنا والاسباب مختلفة.
لكن الدلائل تظل غير مؤكدة ولذا فان تخميناتهم هي المحصلة الوحيدة كنتاج للرعب الذي انتشر أيامهم وماشاع من أجواء شائكة ومشحونة بمختلف تداعيات سياسية-لازالت تلقي بظلالها إلى اليوم - نتج عنها قتلا مجانيا وافرا لناشطين ومناهضين ما أدى إلى إرباك التوقعات في الوعي العام وبالتالي الخاص ولذا كان لقضايا المعتقلين والمختفين أن يتم ترحيلها باعتبارها شديدة الحساسية بينما كان يحدث أن ترتفع الإشارة إليها بشكل نادر على عكس نسيانها القسري التام في محطات أخرى.. وهكذا .
غير أن الجمرات تظل متأججة وهي تحت الرماد في حين تحمل عائلة عون الأمن الوطني مصير ابنها الملتبس .
ففي ابريل 77م شوهد عبد العزيز في مستشفى "الثورة" تحت حراسة احد ضباط الجهاز الكبار " تولى بعد الوحدة منصب محافظ لإحدى المحافظات الجنوبية".
بعد أشهر قليلة من ذات العام شوهد مرة أخرى في المستشفى العسكري ووضعه الصحي أكثر من سيئ والثابت انه تعرض لتعذيب فادح بسبب نشاطه السياسي حيث الحزبية تتوجب التجريم كما ولإفشاء معلومات عن رفاقه.
لقد غافلني الدكتور جميل بالقول- وكانت نظراته مشتتة لكأنما حنجرته تتمزق -أنا على معرفة بعدة أسماء كانت أخي في مسار واحد وهي اليوم تتبوأ مواقع قيادية هامة في الدولة عسكريا ومدنيا"!
تأثرت العائلة لما حصل للحالم ذي الخمسة والعشرين ربيعا وهي تتكئ منذ ثلاثة عقود على بسمة تركها دونما فائدة وفي العام 2003م مات والده كمدا وحسرة عليه رغم امتلائه بيقين انه حي وحتى الآن مازالت والدته تنتظره على نفس اليقين بل أنها حثت واشرفت على بناء طابق باسمه فوق بيت العائلة ومن راتبه ممنية نفسها أن يعود ويسكنه ولقد شعرت بالدمعة الحرى لهذه المفجوعة بينما كان جميل يحثها هاتفيا على أن يرسل أخاه الأصغر «وجدي» صور عبدالعزيز إلى ايميلي للنشر. وكانت أدعيتها تتصاعد من السماعة على هيئة متصدعة.
يحكي جميل انه وأخاه ياسين حين سافرا للدراسة هو إلى روسيا وياسين إلى القاهرة اضطرا إلى إسقاط لقب "عون" من اسميهما واستبداله بالمذحجي خشية المضايقات فحيث كان لا يتم منح جواز سفر إلا بعد موافقة الأمن الوطني الذي يمنح حسن السيرة والسلوك أيضا كان عبد العزيز مغضوب عليه الأمر الذي انجر على بقية أفراد العائلة حتى أن أخاهم منصور الذي كان ناشطا سياسيا حينها ظل مختفيا عن الأنظار لسنوات بسبب المطاردة قبل أن تعرف العائلة انه سافر للدراسة إلى الخارج.
لم يكن عبد العزيز متزوجا حين تم اعتقاله بل كان يتهيأ لذلك وبين أوراقه الشخصية ترك جملة قصائد. "كان يكتب الشعر ولا ينشر" كما مسودات لمقالات "كانت نشرت له جريدة "الجمهورية" خلال ذلك الزمن عدة مقالات بشكل متفاوت "إضافة إلى الرسومات "حيث كان الرسم هوايته المفضلة".
بين عبدالعزيز وجميل أربع سنوات لصالح الأول وعنه يتذكر الثاني ما يلي: "كان نشيطا وأنيق الملبس ويهوى أغاني فيروز.. كان كريما ومتفاعلا مع مشاكل الناس..كان قارئا جيدا وبالذات للروايات العالمية.. كان جادا ومحاورا مقنعا والصفة التي لازمته كظله هي قدرته على الاستقطاب الحزبي".
وظيفيا استمر عبد العزيز في التوجيه المعنوي حتى اعتقاله في 6 فبراير اليوم المشئوم في ذاكرة عائلة "عون".
لم ينقطع راتبه من التوجيه وإنما يذهب إلى والدته ليس لأنه مفقود أو معتقل أو ميت بل كمتقاعد وبرتبة عقيد!
الدكتور جميل عون أستاذ الفلسفة في جامعة صنعاء يطالب عبر"النداء" الحكومة الحالية بكشف مصير أخيه عبد العزيز وهو يشدد على أن "الاختفاء لا تمحي مسؤوليته بمجرد انه تم في عهد الجمهورية العربية اليمنية بل العكس يتوجب أن تتعاظم المسؤولية اليوم في ظل الهامش الديمقراطي وبما يحقق ولو نزرا يسيرا لذوي المختفين كما أن ذلك ما تستدعيه مقتضيات الشفافية وحقوق الإنسان من الأنصاف وجبر الضرر.
***
النقابي المغيب محمد علي قاسم هادي
 أتذكره كالآن، كأننا لم نفترق: صورته، صوته الخافت، بساطة ابن القرية، الآتي من إب أو من ريفها، سيان. الطالب بجامعة صنعاء، النشط في العمل الصحفي اليومي، فهو الدينامو المحرك لمجلة «الغد»، المجلة الرصينة التي يصدرها ويرأس تحريرها الدكتور حمود العودي.
أتذكره كالآن، كأننا لم نفترق: صورته، صوته الخافت، بساطة ابن القرية، الآتي من إب أو من ريفها، سيان. الطالب بجامعة صنعاء، النشط في العمل الصحفي اليومي، فهو الدينامو المحرك لمجلة «الغد»، المجلة الرصينة التي يصدرها ويرأس تحريرها الدكتور حمود العودي.كان محمد أواخر السبعينيات ما يزال طالباً في الجامعة، ويعمل في صحيفة «التعاون» ومجلة «الغد».
كان الطالب المجد من اوائل المنخرطين في العمل النقابي الصحفي. فهو عضو عامل في جمعية الصحفيين، ربما منذ التأسيس (1976). وهو أيضاً عضو سري نشط وفاعل في الحزب الديمقراطي الثوري الأوسع عضوية والأكبر فاعلية وتأثيراً في كل الأحزاب السرية اليسارية.
- عبدالباري طاهر
لم يكن انتماؤه الحزبي معروفاً إلا في إطار الناشطين في الخلايا السرية. وقد أفاده ذلك في توسيع دائرة نشاطه النقابي الصحفي. ففي انتخابات العام 1980 فاز بعضوية الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين. وأصبح المسؤول الثقافي للنقابة. وكان الأستاذ ابراهيم المقحفي ومساعده الفقيد منبه ذمران هما القيادة الجديدة.
هناك قضية أو سمة ميزت العمل النقابي بصورة عامة سواء في اتحاد العمال أو الأدباء أو الأطباء أو الصحفيين، وهي أن حظر العمل الحزبي وتجريمه (باعتباره خيانة عظمى) قد دفع بالأحزاب المحظورة والحزبيين للعمل من خلال النقابات والاتحادات باعتبارها المجال الوحيد المفتوح لممارسة العمل السياسي، فالتحق العديد من الناشطين الحزبيين بالمجال النقابي. وكانت عيون الأمن والمخبرين السريين مفتوحة على الميدان الوحيد الموارب: النقابات.
لم يكن اختيار محمد علي قاسم مسؤولاً ثقافياً في النقابة اعتباطياً؛ فهو على تواصل مع الجامعة ومع أساتذتها ومع المجلات، ومنغمس في الهم الثقافي والسياسي حتى أذنيه.
لا أتذكر أن محمد علي قاسم قد تعرض لإعتقالات قبل العام 80. ومعرفتي به تعود إلى الأعوام الأخيرة من السبعينيات. ولعل أكثر الزملاء ارتباطاً ومعرفة به، الزميلان العزيزان: محمد علي الشامي، ومحمد لطف غالب عضو البرلمان السابق. فقد عايشاه أكثر مني.
بعد طردي من صحيفة «الثورة» بطريقة درامية، تحمس الأستاذ الكبير الفقيد عبدالحفيظ بهران، أمين عام الاتحاد العام للتعاون، وسانده الاعزاء الدكتور حمود العودي وعلي الحرازي، فانتُدبتُ للعمل في صحيفة «التعاون» التي كان يصدرها الاتحاد ويرأس تحريرها الصديق الحميم الصحفي القدير الفقيد عبدالوهاب المؤيد وهو المسؤول عن الإدارة الاعلامية للإعلام. فعملت إلى جانبه في المكتب والصحيفة. وكان ابن قاسم يعمل كسكرتير تحرير لمجلة «الغد»، وقد تميز ابن قاسم بالصمت والكتمان والحيوية والنشاط، وهي أهم وأبرز صفات المناضل الحزبي في ظروف غاية في القسوة والارهاب.
كان المناضلون من أمثال محمد علي قاسم يخرجون من مخابئهم (شبه السرية) في النهار غير واثقين من العودة إليها في المساء. فالاعتقالات الكيفية، والتعذيب في المعتقلات، والصراع الدامي في الاطراف، وصراع الشمال والجنوب، والشمال والشمال والجنوب والجنوب، كلها تزكي العنف، وتجعل من العمل السياسي جريمة العصر.
وكانت اعتقالات الثمانينيات أكثرها بشاعة ودموية وضراوة. فقد بدأت الأدلجة والتخريب للصراع يتخذ بعداً خطراً. ووضع الاسلام السياسي حامي حمى المقدس في مواجهة الشيوعيين الملاحدة.
ربما كان صعود الفتى محمد إلى قيادة النقابة في انتخابات العام 1980 قد لفتت الانتباه إليه أكثر.
في مطلع العام 81 تم لقاء في عدن بين منظمة الصحفيين الديمقراطيين برئاسة النقيب زكي محمد بركات، الذي «لحسه الرفاق» في عدن في كارثة 86، وبين ابراهيم المقحفي ومنبه ذمران ومحمد علي قاسم هادي: القيادة الجديدة لنقابة الصحفيين في الشمال، للتحاور حول التوحد وهو الحوار الذي بدأ منذ نشأة الكيانين النقابيين. وكان الجاوي وعبدالله الوصابي (أول نقيب للصحفيين في الشمال) وأحمد قاسم دماج (أحد أهم المؤسسين لاتحاد الأدباء والصحفيين)، من أهم الداعين والداعمين للتوحد.
ترافق وصول المقحفي ومنبه وابن قاسم مع مؤتمر اتحاد العرب الذي انعقد في عدن. وكنت عائداً من تونس بعد المشاركة في اجتماعات الاتحاد العام للصحفيين العرب. وفي خاتمة التحاور بين الصحفيين صدر بيان عن التوحيد فيه قدر كبير من تبني موقف الاشتراكي، ولا يمكن بحال أن يقبل به الشمال. وهو بيان يضع ممثلي النقابة في الشمال في دائرة الخطر. وفزع الزملاء. والتقينا، وذهبنا معاً، فالتقينا بالدكتور محمد قاسم الثور عضو المكتب السياسي حينها والأقرب للاعتدال في صراع أجنحة الاشتراكي. وتبنى رؤيتنا لإدراكه الأوضاع في الشمال وخبرته النقابية. ولكن البيان لم يُعدَّل لوجود أطراف نافذة في الحزب تدفع إلى المواجهة، وربما توخت من توريط قيادة النقابة في البيان إرغامهم على البقاء في عدن.
وصدر بيان تكذيب من صنعاء، وأن البيان لا يمثل النقابة. والحقيقة أن البيان/ المكيدة كان زائفاً ومفبركاً يهدف إلى توريط الزملاء. وهو ما حدث فعلاً. فما إن عاد الوفد إلى صنعاء حتى أُقصي المقحفي ورُكن جانباً بعد الوعيد والتهديد. أما منبه ذمران ومحمد علي قاسم، وهما العضوان الحزبيان في «الوحدة الشعبية»، فقد جرى اعتقالهما فور عودتهما، ونكل بهما أي تنكيل!
حينها تسربت أخبار (نتمنى أن تكون كاذبة) أن محمد علي قاسم هادي قد قتل تحت التعذيب هو ورفيقه المهندس الزراعي محمد عبدالقاهر. أما منبه ذمران فقد خرج مدمراً وشبه ميت، ولم يمكث بعد الخروج من الاعتقال إلا مدة قصيرة كان (خلالها) يتردد على الاطباء والمستشفيات حتى لقي ربه. وأصيبت العائلتان بكارثة حقيقية. فأسرة ذمران الصحفي الكفؤ في وكالة «سبأ» للأنباء فقد فقدت بضربة واحدة منبه ذمران ويحيى محمد صالح الخاندار الذي قتل في جولة من جولات صنعاء ذات مساء آثم. ويموت منبه ذمران من آثار التعذيب. ويعاني فائز ذمران حتى اليوم من التعذيب النفسي والجسدي. ويختفي أي أثر للصحفي الشاب محمد علي قاسم هادي.
يتصرف مسؤولو الاجهزة الأمنية اليمنية وكأنهم سباع غابة. فأرواح البشر لا تعني لهم شيئاً. ويصبح القتل والاغتيال والتعذيب كقهوة الصباح، لذيذاً ومنعشاً.
مرة أخرى أجدني ملزماً بشكر العزيز سامي غالب وصحيفة «النداء» في فتح ملف «المخازي الحبالى» كتسمية الرائع يوسف الشحاري ضابط الأمن بل أحد مؤسسيه الذين عانى من هذا الجهاز كثيراً حتى رحيله. وأتمنى على زملائنا في نقابة الصحفيين والأدباء والمهندسين والمحامين أن يهتموا كثيراً بقضايا القتلى والمغيبين، فنحن لن نحمي أنفسنا بالخوف، فالذئاب لا يزيدها مرأى الدم إلا هيجاناً وسعاراً.
وإذا ما استطاع جيلنا تلجم وحوش الدماء «المعمدة» فإننا نكون قد حمينا أنفسنا وحميناهم ايضاً. لأن حديثهم المسهب بزهو عن الدم المعمد، يجعلهم صناعاً وضحايا في آنٍ. وعظات وعبر التاريخ كثيرة. ولكن الميزة الحقيقية لعظات التاريخ لا يتعظ بها أحد، كرؤية الفيلسوف الألماني هيجل.
***
في العدد المقبل
* «النداء» ترصد رحلة أسرة محمد علي قاسم، بحثاً عنه في صنعاء، والصليف.
* حصل على شهادة حسن سيرة وسلوك من مقر الأمن الوطني، وبعد 3 أيام اختفى في دهاليزه.
* عاش بقلب حالم... وبكلية واحدة.
***
الرد الرسمي على تقرير الفريق الدولي:
المختفون قسرياً ضحايا النظام الشمولي في الجنوب!
تلقت الجمهورية اليمنية تقريراً من فريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المعني بحالات الاختفاء القسري الذي زار اليمن في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 1998 بهدف عمل دراسات للحالات المعلقة من الاختفاءات القسرية بسبب الحرب الأهلية في عام 1986 التي نشبت فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. وقد أحتوى التقرير المشار إليه على ما يلي:
- مقدمة.
- السياق التاريخي.
- حالات الاختفاء المعلقة المدرجة في ملفات الفريق العامل.
- المزاعم العامة وحالات الإختفاء القسري الأخرى.
- استنتاجات وتوصيات.
وقبل التطرق إلى بيان ردنا على ما جاء في التقرير، وعلى وجه التحديد الفقرات المطلوب التوضيح أو الرد بشأنها وهي التي تندرج تحت البند (ب)/ التوصيات، فإن حكومة الجمهورية اليمنية، تود التأكيد على ما يلي:
1 - إن الغاية الأساسية من الدعوة لهذا الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لزيارة الجمهورية اليمنية هي الرغبة الملحة والصادقة للحكومة اليمنية في التعاون مع هذا الفريق من أجل حل قضايا جميع حالات الإختفاء القسري المشار إليها وفق أسس قانونية وموضوعية وبما يكفل إغلاق هذا الملف نهائياً.
2 - إن حالات الإختفاء القسري في اليمن ليست بذلك الحجم أو الخطورة التي تحدث في بعض الدول وإنما تعتبر حالات محدودة حدثت في ظروف سياسية معينة، وشكلت إحدى صور الصراع على السلطة في ظل هيمنة الحكم الشمولي لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.
3 - إن حكومة الجمهورية اليمنية قد بذلت قصارى جهدها في البحث والتحقيق واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات القانونية لتسوية وكشف ملابسات حالات الإختفاء القسري المدعى بها التي ترجع إلى أحداث عام 1986، بما في ذلك الإتصال بأسر المفقودين وتسوية أوضاع من تبين اختفاؤه في تلك الأحداث، كما قامت اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان وبناءً على اقتراح بعثة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري بالإعلان في الصحف الواسعة الانتشار في اليمن عن توجه الحكومة اليمنية لمعالجة كافة قضايا الإختفاء القسري، وحث أسر المفقودين على التوجه للجهات المختصة والإدلاء بما لديهم من معلومات حول أقاربهم المختفين.
4 - كما تؤكد الجمهورية اليمنية أنه ومنذ قيامها في 22 من مايو عام 1990، لم يحدث فيها أي حالات إختفاء قسري. ومن ثم فإنه لا صحة مطلقاً للمزاعم القائلة بحدوث حالات اختفاء قسري أثناء حرب صيف عام 1994 وما بعدها.
«موقف الجمهورية اليمنية إزاء ما جاء في التوصيات الواردة في التقرير»
أولاً: حول توضيح ملابسات حالات الاختفاء التي حدثت عام 1986 فإن حكومة الجمهورية اليمنية تشير إلى ما يلي:
1 - إن النظام السياسي للجمهورية اليمنية هو نظام ديمقراطي قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان. وتأسيساً على ذلك وإدراكاً من حكومة الجمهورية اليمنية لأهمية معالجة كافة آثار ومخلفات الصراع السياسي ودورات العنف التي اتسمت بها حقبة الحكم الشمولي لما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية والتي مثلت أحداث الثالث عشر من يناير عام 1986 الذروة في دورات تلك الصراعات الدموية المؤسفة؛ فقد بادرت اليمن وعقب قيامها في 22 من مايو 1990 إلى معالجة تلك القضايا من خلال ما يلي:
- تم التأكد من خلو السجون والمعتقلات من أي شخص حبس جراء أحداث 1986.
- اعتُبر كل من ذهب ضحية هذه الأحداث شهيداً، وتتقاضى أسرته إعانة شهرية من جهة العمل التي ينتمي إليها الفقيد، وفي حالة عدم عمله في جهة حكومية تمنح الأسرة إعانة عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- ليس لدى الحكومة اليمنية أي تحفظ في تعويض أي أسرة ثبت فقدانها أحد أقاربها في تلك الأحداث.
2 - ورد في ص (9) الفقرة (39) أن الفريق يوصي الحكومة اليمنية بأن تصدر إعلاناً عاماً تعترف فيه بوقوع الأحداث التي أفضت إلى اختفاء ووفاة مئات الأشخاص. ويرد على ذلك أن الحكومة اليمنية ممثلة باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان وبناءً على اقتراح وفد الفريق العامل، قامت بتوضيح كافة الملابسات المتعلقة بحالات الإختفاء القسري التي تمت أثناء أحداث عام 1986 من خلال الحوار الصحفي الذي نشرته إحدى الصحف اليمنية مع المنسق العام السابق للجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان.
3 - وورد في ص(10) فقرة (40) التوصية بإنشاء فرقة عمل للتواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا القانونية المتبقية في ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري التي وقعت عام 1986، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع الأشخاص المختفين وأفراد أسرهم.
وقد قامت الحكومة اليمنية في حدود إمكانياتها المتاحة بإنشاء فرقة عمل خاصة تابعة للجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان للتواصل مع جميع الأسر المعنية بتسوية القضايا المتعلقة بحالات الاختفاء القسري، وقد تمكنت تلك الفرق من إجراء تحقيقات حول الحالات الواردة في الكشف المقدم من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري، أسفرت عن معرفة مصير عدد من هؤلاء المختفين، وجمع بعض المعلومات عنهم.
***
> بعاليه الرد الرسمي على تقرير الفريق الدولي المعني بحالات الاختفاء الرسمي.
الرد الصادر من اللجنة الوطنية العليا لحقوق الانسان (2002) برئاسة علي محمد الآنسي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، يوحي بأن حالات الإختفاء اقتصرت فيما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتجاهل الحالات الأخرى التي اختفت في الشمال قبل الوحدة.
التجاهل موصول أيضاً حيال ضحايا الاختفاء القسري في اليمن عموماً بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 1990، رغم تأكيدات الفريق الدولي والتقارير والشكاوى التي تلقاها الجانب اليمني من ذوي المختفين.
«النداء» تدعو الجهات المعنية المسؤولة في وزارة حقوق الانسان وغيرها إلى التعامل الإنساني والنزيه مع حالات الإختفاء دونما انتقائية أو تنصيب نفسها كأداة لتبرير حالات الإختفاء وإقناع الفريق الدولي بإغلاق هذا الملف الإنساني المؤلم عبر تزوير وقائع أو وثائق، دونما اعتبار لكرامة ومواطني أهالي الضحايا.
***

بعد ربع قرن ما تزال لطيفة تبحث عن الصحفي شديد الاعتداد
أكبر من أخ
* القمش مؤكداً لوالدي محمد: لم أسمع بهذا الإسم قط
* في الحديدة أصرت الأم على السفر إلى «الصليف» بحثاً عن محمد، فاستغرب قريبها التهامي قائلاً: أيش راح يسوي في أم صليف.. يجيب ملحو?!
- صنعاء - سامي غالب - إب - إبراهيم البعداني
عندما انتزع الأمن الوطني في 14 مايو 1982، محمد علي قاسم هادي من عوالمه الثرية، أصيبت أمه جوهرة الصباحي المقيمة في إب بوعكة خطيرة. كان «أكثر من إبن»، وخلال رحلة بحثها عنه تقاطع عندها الصحو والمنام، وفيما يشبه الرؤيا زارها الإبن المغيَّب في منامها نهاية الثمانينات ليبلغها أنه يقيم في «الصليف».إلى الانتزاع النفسي والانتظارات المستدامة والخيبات المتوالية وشفرات الوقت غير الرحيم، يتقدم البحر كأحد القواسم المشتركة العظمى في حيوات أقارب المختفين قسرياً. البحر بما هو مستودع الأسرار والمصب الافتراضي للوقائع الملفوفة بالغموض. في أفقه تتعلَّل أسر الضحايا بأمل أن يكونوا محتجزين في واحدة من جزره النائية. كذلك يتواتر في هذا الملف الموحش حضور «كمران» و«سقطرى» وغيرهما من الأمكنة اللصيقة بالبحر.
صباح اليوم التالي قصت «جوهرة» رؤياها على إخوة محمد: لطيفة وعبدالكريم وحياة. قررت الأسرة المحزونة القيام برحلة الأمل الى الصليف عبر مدينة الحديدة حيث يقيم أقاربهم. قبل أن تستأنف جوهرة الرحلة التهامية إلى الصليف ابتدرها أحد أقاربها التهاميين بصوت يحمل من التعاطف أكثر مما يحمل من الاستنكار: أيش راح يسوي في ام صليف.. يجيب ملحو! استسلمت للعالم الحقيقي وقفلت عائدة إلى مدينة إب.
***
في الأعوام التالية على اعتقال محمد سافرت جوهرة مرات عديدة الى صنعاء. وترددت مراراً على بيوت المسؤولين الأمنيين، واقتربت من مقراتهم الرهيبة، وفي كل مرة كانت تُصَد بعنجهية واستكبار.
بعد سنوات قرر والدا محمد مقابلة غالب مطهر القمش رئيس جهاز الأمن الوطني. طرقا بوابة منزله بإلحاح إلى أن قبل السماع لشكواهما. سألاه أن يفرج عن محمد، لكنه أنكر أن يكون قد سمع بسجين في الأمن الوطني يحمل هذا الأسم! في فبراير 1990 توفيت جوهرة، وقبل عدة شهور توفي علي قاسم هادي (والد محمد). وما يزال الغموض يلف مصير ابنهما.
***
طبق روايات عديدة
 أبرزها ما كتبه الزميل القدير الأستاذ عبدالباري طاهر في العدد قبل الماضي، فإن محمد، الناشط النقابي والكادر التعاوني و«الحركي» السري، استُهدف من رجال الأمن الوطني فور عودته من عدن حيث شارك ضمن وفد من نقابة الصحفيين «الشمالية» في مشاورات مع منظمة الصحفيين (الجنوبية)، خلال تجمع صحفي نظم في عدن.
أبرزها ما كتبه الزميل القدير الأستاذ عبدالباري طاهر في العدد قبل الماضي، فإن محمد، الناشط النقابي والكادر التعاوني و«الحركي» السري، استُهدف من رجال الأمن الوطني فور عودته من عدن حيث شارك ضمن وفد من نقابة الصحفيين «الشمالية» في مشاورات مع منظمة الصحفيين (الجنوبية)، خلال تجمع صحفي نظم في عدن.في مطار صنعاء رفض محمد تسليم ضابط أمن أوراق ومحاضر متصلة بالزيارة العدنية. تحولت المهمة الأمنية للضابط في قسم التحقيقات بالأمن الوطني المعروف بصرامته إلى مهمة انتقامية. كان الضابط منجرحاً، ورأى في اعتداد الشاب اليساري (المدان سلفاً) إهانة لاَ تُغتفر.
في 14 مايو 1982، بعد أسابيع من الزيارة العدنية، تقدم مجموعة من رجال الأمن نحو محمد أثناء مروره بميدان التحرير، وأخذوه إلى المعتقل.
***
لم تنته المهمة الانتقامية رغم مرور ربع قرن على اعتقال «الأخ الأكبر» لـ«لطيفة».
***
«كان أكبر من أخ»، تقول لطيفة لـ«النداء».
قبل أسبوعين من اعتقاله (اختفائه) بعث الشاب ذو العلامات المميزة التي لا تُحد، رسالة الى أسرته في مدينة إب يقول فيها إنه «بخير ما دام والديَّ لم ينسياني في الدعاء» وإذ بشَّرهما بعزمه خطبة شابة في صنعاء لم يسمها، تمنى للطيفة الشفاء من المرض «كما» والنجاح في امتحانات الصف الأول الثانوي.
بتوقيع رجل مثقل بالأسرار ذيَّل محمد رسالته المقتضبة (نحو 100 كلمة فقط). وعلى ما يبدو فإنه حنَّ إلى كعك أمه، فقرَّر أن يضيف 3 أسطر قصيرة الى الرسالة تتضمن طلباً استثنائياً: «أرجو إرسال قليل من الكعك إن أمكن، وإن كانت صحة الوالدة بخير».
***
«كان صديقي»، تضيف لطيفة.
قبل الإنقضاض الأمني عليه، انشغل محمد بإنجاز معاملتين: الأولى لغرض الالتحاق رسمياً بوظيفة تتناسب ومؤهله الجامعي الجديد (بكالوريوس آداب)؛ والأخرى لمواصلة دراسته العليا في بريطانيا. «أراد أن ألتحق به هناك في بريطانيا لدراسة الطب»، استدعت لطيفة لحظاتها الأخيرة مع محمد الذي تمكن من استصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من الأمن الوطني، لغرض إنجاز المعاملتين، وقد ضمنه لدى الأمن قريب التاجر عبدالله الصباحي.
***
 ولد محمد في مدينة إب عام 1956. درس الأبتدائية والأعدادية في مدرسة الثورة، وأنهى المرحلة الثانوية في مدرسة النهضة. وانتقل الى صنعاء لمواصلة دراسته الجامعية، ومتابعة أنشطته الأخرى.
ولد محمد في مدينة إب عام 1956. درس الأبتدائية والأعدادية في مدرسة الثورة، وأنهى المرحلة الثانوية في مدرسة النهضة. وانتقل الى صنعاء لمواصلة دراسته الجامعية، ومتابعة أنشطته الأخرى.في الحركة التعاونية تميز بالديناميكية، وتنقل في العديد من المناطق الريفية في أكثر من محافظة. كما شغل موقع سكرتير تحرير مجلة «الغد» الصادرة عن الاتحاد العام لهيئات التعاون الأهلي والتطوير. وفي الجامعة نشط في الجمعية الفلسفية بالكلية. وتحتفظ لطيفة بصورة له وهو يقدم لمحاضرة للشاعر عبدالله البردوني الجالس الى يساره.
***
«كان ملاكاً نزل من السماء»، تواصل لطيفة وصف الشاب الـ«أكبر من أخ».
«لو تدري كم كان جذاباً»، تقول قبل أن تردف بصوت فرائحي: «عُرف بقدرته الهائلة على الإقناع، وكثيراً ما تدخل عند أبي لمساعدتي في أمور تخص دراستي وعملي».
تعمل لطيفة حالياً في مكتب الصحة. وهي عملت منذ سن مبكرة في مكتب المواصلات بمدينة إب لمساعدة أسرتها. أعتُبرت الألصق بمحمد. وفي نهاية السبعينات توعكت، فدبَّر محمد منحة علاجية لها إلى القاهرة. أمضيا شهرين هناك، وقد عايشت يومياً شغف أخيها بالكتاب.
«كان إذ يزورنا في إب فمصطحباً كتباً جديدة»، تستدعي لطيفة ما يصلح أن يوصف «هدايا محمد»!
لكن مكتبته العامرة انحسرت بعد اختفائه القسري، ففي سنوات البحث عن محمد تعرضت الأسرة لشتى صنوف المضايقات والتهديدات، وتوجب عليها أن تتخفف سنة تلو سنة، من كل ما له علاقة بالنشاط السري والاتجاه الفكري لمحمد، مبقيةً على البقية الباقية من أوراقه الخاصة ومعاملاته وصوره، وشهادة حسن السيرة والسلوك التي اختفى بعد حصوله عليها بأيام!
***
 في رسالته الأخيرة، التي رغب الأمن الوطني أن تكون وصيته، لاح الشاب الذي يركب الخطر مقتضباً، ولكن أيضاً وعجباً، مستفيضاً في اهتمامه الدافئ بوالديه وإخوته الصغار.
في رسالته الأخيرة، التي رغب الأمن الوطني أن تكون وصيته، لاح الشاب الذي يركب الخطر مقتضباً، ولكن أيضاً وعجباً، مستفيضاً في اهتمامه الدافئ بوالديه وإخوته الصغار.الى دعاء الوالدين الذي أمل أن يعصمه من الشر المستطير في العاصمة، بدا مشغولاً باستعداد لطيفة لامتحانات الصف الأول الثانوي. سأل أيضاً عن صحتها. وعرَّج على شقيقته الصغرى «حياة» التي ستدخل بعد أسابيع امتحانات الصف السادس الأبتدائي، ثم عبدالكريم (الكان في الثالث الإعدادي). وقد أشار في رسالته الى وضع عبدالكريم مطمئناً أباه بأن سيبلغه برقم جلوس عبدالكريم فور صدوره.
هذه النقطة توضحها لطيفة لـ«النداء»: «أراد محمد لعبد الكريم أن يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية في العاصمة، ليكون قريباً منه لمساعدته».
إلى لطيفة وعبدالكريم وحياة، يشير محمد في رسالته المطرزة بالحب إلى «الحبوب الصغير» متمنياً له مستقبلاً زاهراً.
في أحد الأعياد من عام 1978، اصطحب الشاب القادم من العاصمة إخوته الثلاثة الى استديو في مدينة إب لنقش لحظة في حياة أسرة سعيدة.
في أقصى اليسار جلس وفي حضنه لاح «الحبوب الصغير» داهشاً من حركة المصور وعدسة الكاميرا. إلى يساره جلست لطيفة، والى يسارها وقفت حياة، وفي الخلف وقف عبدالكريم.
تتابع لطيفة إيضاحاتها، وهذه المرة عن الحبوب المدهوش:«انفصل والداه، فتحمست والدتي لرعايته الى حين ميسرة».
***
تخرج في كلية الآداب عام 1980. التحق بخدمة الدفاع الوطني، وسُرِّح في 27 أغسطس 1981. وحاز على شهادة الخدمة الاحتياطية التي يخصص جزء منها للبيانات والأوصاف الشخصية. طبق الشهادة فإن محمد يبلغ من الطول 160سم. شعره أسود، كما عيناه. ولون الوجه أسمر. وأمام بند العلامات المميزة لم يلحظ مدوِّن البيانات شيئاً يستحق التوثيق، ربما بمألوف العادة، ولذلك فقد وضع خطاً قصيراً كإشارة على عدم وجود أية علامة مميزة.
بعد ربع قرن يمكن لـ«النداء» أن تكمل ما فات على محرر شهادة الخدمة الاحتياطية التقاطه.
عاش محمد بكلْية واحدة. وطبق لطيفة فإنه خضع لعملية استئصال إحدى كليتيه في منتصف السبعينات.
الفتى الذي عرفه مجايلوه في حارة الجبَّانة مرحاً على قليل من حدة مزاج وعنف مغاضبة، كان كتوماً.
«لم يخطر على بالي قط أنه ناشط في حركة سرية»، قال يحيى السادة أحد زملاء محمد في ثانوية النهضة. وإذ استرجع تفاصيل يومية حميمة جمعتهما أيام الصبا، لفت الى طيبة محمد وميله الى المرح، قبل أن يضيف: «باستثناء قراءاته الغزيرة فإنه لم يبدر منه ما يشي بارتباطه بتنظيم سري».
«نضج مبكراً» يستذكر يحيى منصور أبو أصبع، القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الثوري، الفتى الذي كانه محمد مطلع السبعينات. في تلك الحقبة أشرف أبو أصبع على نشاط الحزب اليساري الفتي في مدينة إب، وقد أثار اهتمامه فاعلية تلميذ المدرسة الاعدادية الذي تمكن في فترة قصيرة من استقطاب العشرات من طلاب الاعدادية والثانوية الى الحزب.
في ظرف سنوات قليلة، يؤكد أبو أصبع، اصبحت منظمة الحزب في المدينة، وبخاصة في «الجبَّانة»، «قوة ضاربة بين الشباب». ويضيف باطمئنان: «الفضل يعود لمحمد وثلاثة آخرين من رفاقه».
«ذو الكلية الواحدة» شديد الاعتداد بنفسه، هذه العلامة المميزة هي التي غيبته فيزيائياً على الأرجح. على الناظر «في الصورة الباهرة» الإمعان في عينيه السوداوين، وفي ابتسامته الخفيفة، وفي الأمان الذي يخيِّم داخله أشقاؤه الصغار ليُمسك بالأبعاد الثرية في شخص «الأخ الأكبر»، وبخاصة مسحة الكبرياء على جبينه.
***
 الاعتداد بما هو علامة مميزة في شخصية محمد أدركته «النداء» في شخص لطيفة. ترددت لطيفة لسنوات عديدة على العاصمة رفقة أسرتها الصغيرة، بحثاً عن خيط يوصلها إلى مكان اعتقال محمد. وهي ضغطت على أعصابها بشدة كيلا تندُّ عنها إشارة يأس.
الاعتداد بما هو علامة مميزة في شخصية محمد أدركته «النداء» في شخص لطيفة. ترددت لطيفة لسنوات عديدة على العاصمة رفقة أسرتها الصغيرة، بحثاً عن خيط يوصلها إلى مكان اعتقال محمد. وهي ضغطت على أعصابها بشدة كيلا تندُّ عنها إشارة يأس.بلغ الأسرة أن محمد محتجز في قصر البشائر، القصر الذي حولته ثورة سبتمبر الى سجن يضيق بشبابها! ترددت لطيفة عدة مرات على قصر البشائر، تمكنت في إحداها من اجتياز بوابته الى عتماته الموحشة. تقول : «لمحتَُ زنازن أرضية (دَبَبَ).. خفت وقلت في نفسي ماذا لو قرروا وضعي في أحدها، ثم خرجت بسرعة».
وعود لطيفة كلها مؤجلة. لم تكمل الثانوية العامة، وهي بالتالي لم تلتحق بأخيها الى لندن، حسبما خطط قبيل اعتقاله. وعلى مر السنين رفضت عروض الزواج، الواحد تلو الآخر، إذْ «لا يكون فرح في غياب محمد». فقدت جوهرتها- الأم الصابرة التي كفت عن إرسال الكعك الى الحبيب محمد. فقدت والدها الموظف البسيط الذي هدَّته غطرسة واستكبار كبار المسؤولين الأمنيين الذين طرق أبوابهم. ومؤخراً فقدت وظيفتها هي الموظفة الكفوءة التي يُضرب بها المثل في عفة اليد واللسان. كل هذه الأهوال لم تفقدها علامتها المميزة: الاعتداد الشديد. وساعة ودعتها «النداء» قالت لطيفة، الناشطة الحزبية وعضوة اللجنة المركزية للاشتراكي، بحزم: «أرفض أن أوصف بأخت المرحوم... ما يزال أخي حياً يرزق». وبصوت طالع من عذابات العمر أودعتنا كلمتها الأخيرة: «إسألوا الأخ محمد اليدومي (القيادي الإصلاحي البارز والضابط السابق في الأمن الوطني)، لعله الوحيد الذي يعرف مصير أخي».
صورة.. شعرية

لأن له بغيةً راقية
تناديه كنْ غيث إبراقيةْ
لأني لمحت عذارى مناك
وريَّاك أولُ طراقيةَْ
فيهتف يا كل شوق الرحيل
إليها ولا تلتمس واقيةْ
إليها ويا نفس لا تحفلى
بما أنت في وصلها لاقيةْ
إلى كم أقاوي إليها الحنين
وأكتب للريح أوراقيةْ
فيعدو على النار يبدو
كمن يُغسِّل رجليه في ساقيةْ
فتستغرب النار هذا احتذى
غروري وهمَّ بإغراقية
وقال ادخليني لكي تورقي
وتذكي مشايع إيراقية
أما آخر الحرق بدء الرماد
فلوذي بأفلاك إشراقيةْ
* في سنة سبعينية خصيبة، استضافت الجمعية الفلسفية في قسم الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب الشاعر عبدالله البردوني ليلقي محاضرة عن اصطراع الأفكار في العالم العربي. وقدَّم الطالب محمد علي قاسم هادي للمحاضرة. والأبيات أعلاه مقطع من قصيدة «ابن ناقيةْ» نشرها البردوني مطلع التسعينات.
ملاحظة.. ومقترح
الأخ/ رئيس تحرير صحيفة «النداء» المحترم
تحية وتقدير،
أطالع بشغف ما ينشر في الملف الشجاع، المتعلق بقضية غاية في الحساسية وعميقة في طابعها الأنساني، وأعني بذلك ملف المفقودين قسرياً. وإذ أبارك لكم هذا السبق الصحفي والموقف المتقدم، لي هنا ملاحظة أرى لزاماً عليَّ أن أبينها، ومن ثم مقترح، إن نال رضاكم.
الملاحظة: إن هؤلاء الذين نفترض الآن أنهم، أو أغلبهم، قد فقدوا حياتهم بذلك الأسلوب الهمجي، إنما هم ضحايا صراعات طغت. بل كانت العنوان الأبرز لمراحل لها معطياتها ولها ثقافاتها ولها سمات وظروف عقائدية وسياسية ووطنية واقليمية ودولية. الكل يعرفها. بمعنى آخر أنه لو عادت عجلة التاريخ إلى نفس تلك المراحل بنفس ثقافاتها ونفس سماتها وظروفها، لخلصت تقريباً إلى نفس تلك الجرائم المؤلمة. ولو قلبت الأمور رأساً على عقب لأ استبعد أبداً أن يكون بعض المجني عليهم الآن جناة. أنا لا أبرر وإنما أوضح أنه يجب بيان سوء ولامعقولية تلك الأوضاع ومأساوية نتائجها وأهم تلك النتائج أنها ألغت من التاريخ المفترض، لتقدم وإنسانية الشعب اليمني، عشرات السنين، أقول هذا الكلام لأن ما ينشر في هذا الملف إنما هو فاصل حزين ومؤلم ومخجل. والعمل لعدم تكرار هذا الفاضل إنما يتحدد بتجذير وعي مضاد لأصوله وضمان عدم تكراره؛ خاصة والكل الآن يعلم تداعيات ما هو قائم وخطورته. ويجب زرع هذا المفهوم في عقول ذوي الشأن والعلاقة بأولئك الاماجد خاصة والكثير منهم ومن غيرهم يعرفون الجهات وربما الأشخاص الذين كانوا أدوات تنفيذ مثل هذه الاعمال.
أما اقتراحي إن لاقى قبولاً لديكم، فهو السعي من قبلكم أولاً بالتعاون مع كل المهتمين لتشكيل «اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المفقودين قسرياً» لتضم في عضويتها ناشطين قانونيين وسياسيين وصحفيين متطوعين بحماس وإنسانية، لجمع كل المعلومات عن الحالات المفترضة. والعمل بقوة من أجل رد الإعتبار لهم، وإنصاف ذويهم مادياً ومعنوياً. والأهم إبتكار الوسائل لتجذير وعي عميق لدى كل الناس بخطورة ومأساوية مثل هذه الأعمال التي تطال كل القيم الدينية والسياسية والوطنية الانسانية السوية، مع التأكيد على الاستبعاد النهائي والمطلق لأية نوايا في نبش الماضي الكئيب أو الاتهام أو الملاحقة أو الاستهداف وتحميل مؤسسات الدولة مسؤولية وتكاليف المعالجة الشمولية للموضوع. باختصار يجب أن يصبح أو يتحول هذا العمل إلى عنوان كبير وواسع لخلق وتعميق ثقافة جديدة قائمة على احترام انسانية الانسان ووقف وتجريم كل ما يتعرض لحياته أو كرامته مهما كان الإختلاف في الرأي أو الموقف.
- أحمد الرماح
***
المختفون قسرياً (10)
*انطفاء قادري كرو
* عبدالكريم الحوثي وآخرون أعضاء في قائمة المختفين قسرياً

- عدن - فهمي السقاف صنعاء - محمد العلائي
في 1969 أدرك الشيخ قادري كرو
عبدالعزيز صلاته الأخيرة، بيد أنه لم يتمكن من مشاطرة أبنائه العشاء الأخير.
فحينما قصد الرجل مسجد «زكو» بالشيخ عثمان، لأداء صلاة العشاء، كان بانتظاره فريقان: 3 من ابنائه في بيتهم المؤقت، و4 رجال مقطبي الحواجب، على متن سيارة لاندروفر. كانوا يتربصون به قبالة مدخل المسجد.
فرغ قادري من صلاته، عندما كان ولده «صالح» يسير في الجادة، عائداً بطبق لذيذ، من مطعم مجاور للحارة التي يقطنون.
يحمل الرجال ال4 اسحلتهم النارية، لكنهم يرتدون الزي المدني. وفيما كان الشيخ (الشاب) يقفل عائداً الى بيته، اعترض المسلحون طريقه. وبعدما ظفروا به أخذوا بتلابيبه وألقوه في بطن السيارة.. بطن الغياب السرمدي.
لاحقاً، سيتوجب على أولاده ال3 (صالح، سرور، وعبيد)، تجرع مرارة 38 عاماً من الانتظار المديد.
ساعتذاك، كان سرور (الابن الأصغر لقادري)، يجلس على عتبة المنزل. كان يبلغ من العمر وقتذاك 17 عاماً. وإذ راح الفتى يجول ببصره في أرجاء الشارع، حدق لبرهة في الضوء البازغ من منارة المسجد.
طبقاً لرواية صالح فإن سرور لمح أباه مطوقاً برجال متجهمين، وبحركة دراماتيكية أخفوه في بطن السيارة... الى الأبد.
«كنت حينها في قرابة ال 22 عاماً، وشقيقي عبيد 20 عاماً، وكان اصغرنا سرور 17 عاماً، حين انتقلنا بمعية والدنا للسكن مؤقتاً في مدينة الشيخ عثمان»، يقول صالح لـ«النداء» وقد بدا وجهه شاحباً وحزيناً.
يُمضي صالح الآن عامه ال55. لكن رغم ذلك ما يزال لديه متسع من الوقت ليروي حكاية والده، الذي اختفى قسرياً بعد سلسلة مضايقات جردته من كل شيء.
كان قادري شخصاً مرموقاً إبان السلطنة العبدلية في الحوطة. فإلى كونه خلف والده كشيخ لقريته «الثعلب»، (5 كليو مترات شرق الحوطة)، فقد عين أيضاً في 1953 عضواً في المجلس التشريعي اللحجي للسلطنة العبدلية» فضلاً عن أنه حاز في الفترة ذاتها على عضوية المجلس الزراعي اللحجي.
ولئن أجمع كل من عرفه عن كثب، على عديد مزايا كان يتمتع بها الرجل، فقد أضافوا، علاوة على ذلك، أنه كان شاباً طموحاً متطلعاً، تعدى نشاطه ودوره الاجتماعي حدود قريته الصغيرة ليصل الى حاضرة السلطنة العبدلية (الحوطة).
قبيل وفاة والده، الشيخ كرو عبدالعزيز، في ثلاثينات القرن الماضي، ببضعة أعوام، قرر قادري دخول عش الزوجية. لقد أنجب من هذه الزيجة 9أبناء (6 ذكور، و3 إناث).
«ما بين نهاية 1968 وبداية 1969 صودرت مزرعة الوالد، الواقعة في بستان الحسيني، عندما تم تطبيق قانون الاصلاح الزراعي في عهد الرئيس قحطان الشعبي»، قال كرو (45 عاماً) وهو أحد أنجال قادري، لدى مقابلته «النداء» في بستان الحسيني الشهير قبل بضعة اسابيع.
وأضاف كرو بتحسر شديد: «كان القانون يحدد ملكية الأسرة ب80 فداناً، والأفراد ب40 فداناً، لكن الوالد عومل كفرد لبعض الوقت، وبعدها صودرت بقية الأرض كاملة في العام 1970 (بعد اختفائه)، وأصبحنا معدمين، لا نملك من مزارع والدنا، وجدَّنا، شيئاً يذكر».
أياً يكن الأمر، فقد راودت قادري مشاعر القنوط. «وعند اشتداد المضايقات والملاحقات بداية 1969، اسدى له الشيخ سعيد اللحجي معروفاً جليلاً: تبرع له بمنزله الكائن في السبلة بمدينة الشيخ عثمان، ليقطنه، طمعاً في تحسن الظروف». كان يتحدث كرو وهو يترقب وصول السيارة التي ستقلنا الى ضفة أخرى من بستان الحسيني، حيث يتواجد شقيقه صالح، الذي سيغوص في اكثر التفاصيل عمقاً.
يقول صالح: «كان سرور أصغرنا سناً، إلا أنه كان ألصقنا بالوالد في حله وترحاله، يرافقه كظله، سيما بعد خروجه من السجن في 1967».
عندما أعلن المؤذن دنو وقت العشاء، نهض قادري لتوه. «عبيد وسرور بقيا في البيت، وأنا ذهبت لإحضار وجبة العشاب من مطعم لا يبعد كثيراً عن الحارة التي كنا نسكنها» أردف صالح بنبرة مثقلة بالوجع.
بعد برهات بدأت صلاة العشاء. لحظتها سمع سرور وعبيد أيادي غليظة تطرق الباب بشدة. فتح سرور الباب، لكنه لم يتوخ الحذر. وحين دعاهم لتناول العشاء، سألوه بحدة عن الشيخ قادري. «في المسجد يصلي العشاء»، رد سرور بتلقائية، وأشار الى مسجد «زكو».
لقد غادروه دون إيماءة وداع أو كلمة شكر على دعوة كريمة لتناول العشاء.
«كانت وجوههم مكفهرة، وملامحهم تشي بالخطر»، يقول صالح. وأضاف بصوت خافت: «كنا، ثلاثتنا، أنا وعبيد وسرور، منتظرين بشوق عودة الوالد لنتعشى معاً كالمعتاد. لم نكن نعلم أنه سيتخلف من الآن فصاعداً، ليس لتلك الليلة فحسب، بل لسنوات طوال، مستمرة حتى اللحظة».
المواقف المؤلمة أشد قسوة حتى عند استعادتها. لذا فقد بدا صالح وهو يسرد تفاصيل اختفاء والده، كمن يتحدث عن فاجعة حدثت قبل اسبوع فقط.
على سبيل التثبت، توجه صالح في صباح اليوم التالي، صوب قرية «ثعلب». وحين سأل والدته واخوته عما اذا كان والده بات ليلته عندهم، تلقى منهم جواباً ما يزال كغصة عالقة في حلقه: لم يأت! إنه عندكم!.
انضم محمد الى صالح ليواصلا معاً سرد بقية تفاصيل الاختفاء. ومحمد هو النجل الأكبر للشيخ قادري. كان عمره آنذاك 30 عاماً. «زرت شرطة الشيخ عثمان، وأبلغتهم بما حدث للوالد. لكن قائد الشرطة اجاب بالنفي: ليس عندنا. إلا انه أردف قائلاً: اسأل عنه في جهاز أمن الثورة»، قال محمد والكآبة تكسو وجهه.
وزاد: «ذهبت الى جهاز أمن الثورة، وهناك قابلت محمد سعيد عبدالله «محسن»، رئيس الجهاز آنذاك، وبعدما رويت له ما حدث رد : ليش عندنا؟ إسأل أقاربك عنه لعله عند احدهم. تأكدنا أنه ليس عند أحد من الأهل، وأبلغنا شرطة الشيخ عثمان في اليوم التالي فقال قائد الشرطة: لعله لديكم» أرد محمد.
يواصل محمد: «محسن كرر نفس اجابته السابقة، فازددت إلحاحاً، وأظهرت له رغبتي في مقابلة الوالد، وبعد ذاك الاصرار، أوعز محسن لأحد افراد جهازه الأمني: «خذوه لرؤية والده!!». لقد كان على وشك أن يذيق «محمد» ذات المصير الذي ألقى بوالده الى المجهول.
«احد ضباط الجهاز نصحني بمغادرة المبنى في الحال، موضحاً أن ما قاله رئيس الجهاز ليس إلا أمراً مبطناً من شأنه إلحاقي بوالدي»، ختم محمد حديثه.
في 26 يونيو 1968 اغتيل الرئيس سالمين. حينها سرت إشاعة مفادها أن من اختفوا قسرياً أعيدوا من جزيرة سقطرى الى سجن المنصورة.
«ظننا أن والدنا سيكون معهم، فكانت وجهتي هذه المرة رئاسة الجمهورية»، يستأنف محمد روايته، لكن بحزن اكثر. استطاع عبدالفتاح اسماعيل الاطاحة بسالمين، وتربع على سدة الحكم.
استبشر محمد خيراً. ولدى وصوله مكتب الرئاسة قدم مذكرة للرئيس الجديد.
يقول: «حددت السكرتارية موعداً لا ستلام الرد، وحالما ذهبت وجدت أن الرئيس لم يجشم نفسه عناء الرد».
في خضم هذه التفاصيل غاب أحد أبرز شخصيات القصة، إنه سرور. وحين سألناهم عن مصير هذا الابن المدلل، أفلتت من ثلاثتهم (محمد وصالح، وكرو) تنهيدة مدوية، تنم عن وجع دفين يغلي في صدورهم.
أجاب محمد هذه المرة أيضاً: «بعد أن مرت الشهور دون ان نتأكد اين انتهى المطاف بوالدنا، تعاظم الحزن في قلب سرور، وتوفي قهراً وكمداً، بعد 3 أشهر من اختفاء الوالد».
أخذ محمد يستفرد بالحديث، واندفع يكمل رواية المصائب التي حاقت بهم بعد العام 1969:
«في 1970 الحافل بالانتفاضات، صودرت جميع ممتلكات الوالد بما في ذلك بقية الاراضي الزراعية ،كما اقتحمت حملة أمنية بقيادة أحمد سالم عين فُتيش، منزلنا وصادرت منه قطعتي سلاح، ابو عجلة، واثنين خيول ومجموعة من الاغنام».
يستطرد محمد باستياء: «يومها سلك الثوار درب المستعمر في الأذى والتنكيل، لم يسلم شيئاً من موجودات المنزل، تصور أخذوا حتى أسرة نومنا وفرشانا، لم يتركو من المنزل سوى الجدران حتى الجدران كانت في طريقها للمصادرة لولا لطف الله وعنايته. طلبو منا اخلاء المنزل وأشعرونا شفوياً بقرار تزفيرنا (ترحيلنا) قسرياً الى شمال الوطن».
كرو يتذكر جيداً تفاصيل طفولة فيها الكثير من البؤس والحرمان. وقبل ان يسترسل في حديثه معي كان ينتشلنا من جهامة ذكرياتهم الطافحة بالمعاناة بخفة ظله. يتميز ابناء لحج عادة بروح الدُعابة. قال كرو: « كانت تعد والدتنا الخمير في البيت وكنت أذهب أبيعه لنحصل على قوتنا وما يعيننا على مواصلة دراستنا وكنت أبيع ثمار المنجا والباذنجان التي كنت احصل عليها نظير عمل في مزارعنا (السابقة) «قدم لي كشفاً يحوي ما هو من أملاكهم».
يختتم كرو حديثه: «لا أدري أي ذنب ارتكبه والدي حتى يلقى هذا المصير الغامض. هو من قارع الاستعمار ودخل سجونه ومعتقلاته مناضلاً في سبيل الوطن. لم يكتفو بذلك فحسب بل كنا موصومين بأننا أبناء الاقطاع والثورة المضادة!!».
***
عبدالكريم الحوثي وآخرون أعضاء في قائمة المختفين قسرياً
ليس هناك ما يدل على وجودهم في سجن الجهاز العتيد
لا يزال مصير عبدالكريم الحوثي، عضو لجنة الوساطة، وشقيقه بدر الدين الحوثي، طي الغموض.
في 10 فبراير 2007 استدعت وزارة الداخلية عبدالكريم. وبعد لحظات أبلغت مرافقيه أنه رهن التوقيف.
وعدا أخبار غير مؤكدة راجت بعد اختفائه ب4 أشهر تقول انه موجود في سجن الامن السياسي، فإن عائلته مذاك لا تعرف أين آل به المطاف.
ليس هناك ما يدل على وجوده في سجن الجهاز العتيد. هكذا تقول عائلته. طالما لم يسمح لها بزيارته او ايصال الطعام والملابس والدواء له، سيما وأنه يعاني من مرض الربو. وكان قبل اختفائه اجرى عملية جراحية لإزالة حصوات من الكلى، في حين كان لا يزال بحاجة ماسة لاستخدام الدواء حتى لحظة الاختفاء.
في الفترة نفسها، اعتقل من منزل عبدالكريم بضعة شباب لم يتمكن ذووهم من زيارتهم، ويفتقرون الى تأكيدات قاطعة تفيد بأنهم لدى الأمن السياسي، وهم : محمد الشهاري، محمد عبدالكريم الحوثي، أمير بدر الدين الحوثي ( كان يخضع للعلاج فهو يعاني من مرض نفساني)، وسالم حسين.
الى ذلك، اعتقل من منزل عبدالله حسين الحوثي في صنعاء كلُّ من: ابراهيم بدر الدين الحوثي (اصابته شظايا في الحرب)، محمد علي عبدالكريم الحوثي (يعاني من تضخم في الكبد)، وزكريا محمد بدر الدين الحوثي.
تلزم الاشارة الى أن جميع هؤلاء المختفين ما يزال وجودهم في الأمن السياسي مجرد إشاعات، وفقاً للمعلومات.




